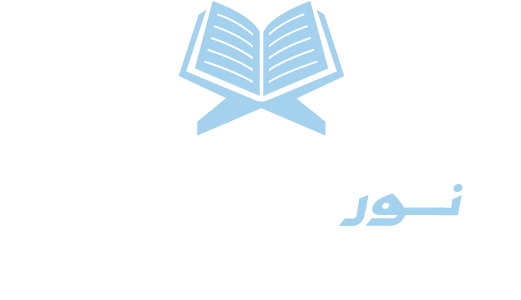ولهذا يقولون: ليس لله عين، ولا وجه، ولا له يد، ولا استوى على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً ولو أنكروا إنكار جحد، لكفروا، لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلاً وهو عندنا تحريف.
والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً} [المائدة: 50] والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل {لِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى} [النحل: 60] وقال: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} [النحل: 17] وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟
فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالماً من النقص.
فمثلاً: يدرك بأنه لابد أن يكون الرب سميعاً بصيراً، قال إبراهيم: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ} [مريم: 42].
ولابد أن يكون خالقاً، لأن الله قال: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاّيَخْلُقُ} [النحل: 17] {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً} [النحل: 20].
يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم، لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [النحل: 20]، إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل.
العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، لأن الرب لابد أن يكون كاملاً فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه الحجز، لأنه صفة نقص، إذا كان الرب عاجزاً وعُصِي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز، فلا يمكن!
إذاً، العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك والصم كذلك والجهل كذلك …. وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع.
سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟
الجواب: لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان، لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال، فهي ثابته لله سبحانه وتعالى.
فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببهما الحاجة،والله تعالى غني عما سواه، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذا، إذا كان الإنسان لا يأكل، فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو نحوه هذا نقص.
والنوم بالنسبة للخالق نقص، وللمخلوق كمال، فظهر الفرق.
التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه .. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: “من نازعني واحداً منهما عذبته” رواه مسلم.
فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً.
هذه ستة مباحث تحت قوله: “ما وصف به نفسه” وكلها مباحث هامة، وقدمناها بين يدي العقيدة، لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: “وبما وصفه به رسوله”: ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول، أو بالفعل، أو بالإقرار.
أ- أما القول، مثل “ربنا! الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض” رواه أحمد وقوله في يمينه: “لا ومقلب القلوب” رواه البخاري.
ب- وأما الفعل، فهو أقل من القول، مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس، وقال: “ألا هل بلغت؟ ” قالوا: نعم ثلاث مرات. قال “اللهم! أشهد” يرفع إصبعه إلى السماء، وينكتها إلى الناس رواه مسلم فرفع إصبعه إلى السماء، هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل.
وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة، قال: يا رسول الله! هلكت الأموال .. فرفع يديه رواه البخاري وهذا أيضاً وصف لله بالعلو عن طريق الفعل.
وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله.
وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} [النساء: 58] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى، والتيتليها على عينه وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل رواه أبو داود.
وحينئذ نقول: إن إثبات الرسول عليه والسلام للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل، مجتمعين ومنفردين.
جـ- أما الإقرار، فهو قليل بالنسبة لما قبله، مثل: إقراره الجارية التي سألها: “أين الله؟ ” قالت: في السماء. فأقرها وقال: “أعتقها” رواه مسلم.
وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع والثرى على إصبع .. آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقاً لقول رواه البخاري، وهذا إقرار.
إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو: ما دليله؟نقول: دليله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ} [النساء: 136]، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به، فهو تبليغ من الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال، وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح، والصدق، والبيان، فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو ـ والله ـ أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة، ومع هذا يقول: “سبحان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” رواه مسم.
* قوله: ” من غير تحريف ولا تعطي, ومن غير تكييف ولا تمثيل”.
شرح:
في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيماناً خالياً من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل، والتكييف، والتمثيل.
فالتحريف: التغيير وهو إما لفظي وإما معنوي.
لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس.
فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني: تغيير اللفظ أو المعنى.
وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاً ويسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريفاً! ولو قالوا: هذا تحريف، لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم.
ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن كثيراً ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون: من غير تأويل، لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة:
الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46]، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على المعنى.
الوجه الثاني: أنه أدل على الحال، وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن تسميه مؤولاً، بل العدل أننصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفاً.
الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين، تقبله النفس، وتستفصل عن معناه، أما التحريف، بمجرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر الإنسان منه، إذا كان كذلك، فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل.
الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: “اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل” رواه أحمد ,وقال الله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7]، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل.
والتأويل ليس بمعنى العاقبة والمال، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره.
(أ) يكون بمعنى التفسير، كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية، يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون المعنى والسمي التفسير تأويلاً، لأننا أولنا الكلام، أي: جعلناه يؤول إلى معناه وسمي التفسير تأويلاً، لأننا أولنا الكلام، أي: جعلناه يؤول إلى معناه المراد به.(ب) تأويل بمعنى: عاقبة الشيء، وهذا إن ورد في طلب، فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان نهياً، وإن ورد في خبر، فتأويله وقوعه.
مثاله في الخبر قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 53]، فالمعنى: ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومال ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق.
ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجداً قال: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: 100]: هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له.
ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1]، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: “سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي”، يتأول القرآن رواه البخاري. أي: يعمل به.
(جـ) المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل، فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول، وهو التفسير، وإن لم يدل عليهدليل، فهو مذموم، ويكون من باب التحريف، وليس من باب التأويل.
وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل.
مثاله قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]: ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه، وعلا عليه، فإذا قال قائل: معنى {اسْتَوَى}: استولى على العرش، فنقول: هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، لكن هذا تحريف في الحقيقة، لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه، كما سيأتي إن شاء الله.
فأما قوله تعالى {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النحل: 1]، فمعنى: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}، أي سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله: {فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ}.
وكذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، أي: إذا أردت أن تقرأ، وليس المعني: إذا أكملت القراءة، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرد أن يقرأ، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم رواه أبو شيبة، لا إذا أكمل القراءة، فالتأويلصحيح.
وكذلك قول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: “أعوذ بالله من الخبث والخبائث” رواه البخاري، فمعنى “إذا دخل”: إذاً أراد أن يدخل، لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا حملنا قوله “إذا دخل” على: إذ أراد أن يدخل: هذا التأويل الذي دل عليه صحيح، ولا يعدوا أن يكون تفسيراً.
ولذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى، لأنه الذي جاء به القرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف، ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم، بخلاف التأويل، فإن منه ما يكون مذموماً ومحموداً، فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه.
“ولا تعطيل”: التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى: {وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ} [الحج: 45]، أي: مخلاة متروكة.
والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كلياً أو جزئياً، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلاً.
فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله، أوأي صفة من صفات الله ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقراراً كاملاً.