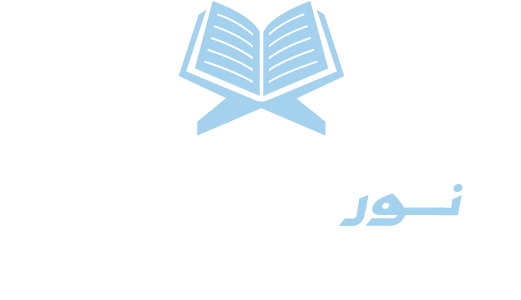وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، فيكفي أن نقول: لا قبول لدعواكم، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ أن الأصل عدم الثبوت، فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين، فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده يحبها، وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتحب.
وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، فيكفي أن نقول: لا قبول لدعواكم، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ أن الأصل عدم الثبوت، فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين، فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده يحبها، وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتحب.
فنحن ـ ولله الحمد ـ نثبت لله المحبة بينه وبين عباده.
صفة الرحمة
وقوله: ]بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم[( 1 )…………………………………………
( 1 ) هذه آيات في إثبات صفة الرحمة:
الآية الأولى: قوله: ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ [النمل: 30].
هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكماً، وليست مقدمة لما بعدها، وقد سبق لنا شرح البسملة، فلا حاجة إلى إعادته.
وفيها من أسماء الله ثلاثة: الله، الرحمن، الرحيم. ومن صفاته: الألوهية، والرحمة.
] رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْما [( 1 )……………………………………..
( 1 ) الآية الثانية: قوله: ] رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْما [ [غافر: 7]. هذا يقوله الملائكة: ] الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ [ [غافر: 7].
ما أعظم الإيمان وأعظم فائدته
الملائكة حول العرش يحملونه، يدعون الله للمؤمن.
* وقوله: ] رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً [: يدل على أن كل شيء وصله علم الله، وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهما في الحكم ] رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً [.
وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر، يرحم الكافر أيضاً.
لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن، فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك.
أما المؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنهار رحمة إيمانية دينية دنيوية.
ولهذا تجد المؤمن أحسن حالاً من الكافر، حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول: ] مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَة [ [النحل: 97]: الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع، روث، وإذا لم يشبع، جلس يصرخ هكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا، بطروا وإلا جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم، لكن المؤمن إن أصابته سراء، شكر، فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء، ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل.
فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه.
لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً آلافاً يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا، حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا، رضوا، وإن لم يعطوا، إذا هم يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية، فهم في جحيم، لم يذوقوا لذة الدنيا أبداً، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال بعض السلف: والله، لو يعلم الملوك وأبناء لملوك ما نحن فيه، لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم ومبلغ علمهم.
قوله: ]رحمة وعلما[: ]رحمة[: تمييز محول عن الفاعل، وكذلك ]وعلما[، لأن الأصل: ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء.
وفي الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة، والعلم.
]وكان بالمؤمنين رحيماً[( 1 )………………………………………………
( 1 ) الآية الثالثة: قوله: ]وكان بالمؤمنين رحيماً[ [الأحزاب: 43].
* ]بالمؤمنين[: متعلق بـ( رحيم )، وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيماً.
ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: ] رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً[ [غافر: 7]؟!
نقول: الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك. هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار، بخلاف الأولى. هذا هو الجمع بينهما، وإلا؛ بخلاف الأولى. هذا هو الجمع بينهما، وإلا، فكل مرحوم، لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة.
وفي الآية من الصفات: الرحمة.
ومن الناحية المسلكية: الترغيب في الإيمان.
( 1 ) الآية الرابعة: قوله: ]وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء [ [الأعراف: 156] يقول جل جلاله ممتدحاً مثنياً على نفسه ] وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء [، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض.
ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية، فليرجع إليه.
( 2 ) الآية الخامسة: قوله: ] كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة [ [الأنعام: 54].
* ]كتب[: بمعنى: أوجب على نفسه الرحمة فالله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة ، وجعل رحمته سابقه لغضبه، ] وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة [ [فاطر: 45]، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى.
* ومن رحمته ما ذكره بقوله: ] أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيم [ [الأنعام: 54] هذه من رحمته.
* ]سوءا[: نكرة في سياق الشرط، فتعم كل سوء، حتى الشرك.
* ]بجهالة[: يعني: بسفه، وليس المراد بها عدم العلم، والسفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله، فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة.
]ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم[: فيغفر ذنبه ويرحمه.
ولم يختم الآية بهذا، إلا سينال التائب المغفرة والرحمة، هذا من رحمته التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه، ويجزيه على عمله الصالح.
فلو أن رجلاً أذنب خمسين يوماً، ثم تاب وأصلح خمسين يوماً، فالعدل أن نعذبه عن خمسين يوماً، ونجازيه بالثواب عن خمسين يوماً، لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ، فكل الخمسين يوماً التي ذهبت من السوء تمحى وتزول بساعة، وزد على ذلك: ] فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات [ [الفرقان: 70]، السيئات الماضية تكون حسنات، لأن كل حسنة عنها توبة، وكل توبة فيها أجر.
فظهر بهذا أثر قوله تعالى: ]كتب ربكم على نفسه الرحمة[.
وفي الآية من صفات الله: الربوبية، والإيجاب، والرحمة.
( 1 ) الآية السادسة: قوله: ] وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [ [يونس: 107].
* الله عز وجل هو الغفور الرحيم، جمع عز وجل بين هذين الاسمين، لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب، وبالرحمة حصول المطلوب، والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه، ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبة.
* فـ ]الْغَفُور[: صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهام، وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما: ستر الرأس والوقاية. فـ ]الْغَفُور[: الذي يستر ذنوب عباده، ويقيهم آثامها، بالعفو عنها.
ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح: “أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده، ويقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا، وعملت كذا.. حتى يقر، فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم”رواه البخاري[90].
]فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين[( 1 )……………………………………
( 1 ) الآية السابعة: قوله: ] فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [ [يوسف: 64]، قالها عن يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم، إلا إذا أتيتم بأخيكم، فبلغوا والدهم هذه الرسالة، ومن أجل الحاجة أرسله معهم، وقال لهم عند وداعه: ] قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [ [يوسف: 64]، يعني: لن تحفظوه، لكن الله هو الذي يحفظه.
* ] خَيْرٌ حَافِظاً [: ]حَافِظاً[: قال العلماء: إنا تمييز، كقول العرب: لله دره فارساً. وقيل: إنها حال من فاعل ]خَيْر[ في قوله: ]فَاللَّهُ خَيْر[، أي: حال كونه حافظاً.
* الشاهد من الآية هنا قوله: ] وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [، حيث أثبت الله عز وجل الرحمة، بل بين أنه أرحم الراحمين، لو جمعت رحمة الخلق كلهم، بل رحمات الخلق كلهم، لكانت رحمة الله أشد وأعظم.
أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبداً، حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب.
جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه، فلما رأته، أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟“. قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: “لله أرحم بعباده من هذه بولدها“رواه البخاري ومسلم[91].
جل جلاله، عز ملكه وسلطانه.
كل الراحمين، إذا جمعت رحماتهم كلهم، فليست بشيء عند رحمة الله.
ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مائة رحمة، وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيارواه البخاري ومسلم[92].
كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء، ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع حتى يرضع بسهولة ويسر، وكذلك تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها، ترمي نفسها عليه، فتدافع عنهم، حتى ترده عن أولادها.
وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل:
فأما الكتاب، فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة، تارة بالاسم، كقوله: ]وهو الغفور الرحيم[ [يونس: 107]، وتارة بالصفة، قوله: ]وربك الغفور ذو الرحمة[ [الكهف: 58]، وتارة بالفعل، كقوله: ]يعذب من يشاء ويرحم من يشاء[ [العنكبوت: 21]، وتارة باسم التفضيل، كقوله: ]وهو أرحم الراحمين[ [يوسف: 92].
وبمثل هذه الوجوه.. جاءت السنة.
وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى، فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله، كله دال على إثبات الرحمة عقلاً.
فالناس في جدب وفي قحط، الأرض مجدبة، والسماء قاحطة، لا مطر، ولا نبات، فينزل الله المطر، وتنبت الأرض، وتشبع الأنعام، ويسقي الناس.. حتى العامي الذي لم يدرس، لو سألته وقلت: هذا من أي شيء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله ولا يشك أحد في هذا أبداً.
فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي.
وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفاً بالرحمة، قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانياً: لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة الإحسان، أو: الإحسان نفسه، أي: إما النعم، أو إرادة النعم.
فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة، التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها، كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله ] إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [ [الأعراف: 56]. أنكروا هذا، قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة!!
ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم، والمنع:
التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليها، ولكن السمع دل عليها، فثبتت بدليل آخر، والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل، لكن ثبتت بالسمع، وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة.
أما المنع، فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة، فهذه النعم المشهودة والمسموعة، وهذه النقم المدفوعة، ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك، ولو كان الله لا يرحم العباد، ما أعطاهم النعم، ولا دفع عنهم النقم!
وهذا أمر مشهود، يشهد به الخاص والعام، العامي في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة.
والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل: بالسمع: واضح. وبالعقل: لأن التخصيص، يدل على الإرادة ومعنى التخصيص يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة، كون هذه السماء سماء، وهذه الأرض أرضاً، وهذه النجوم وهذه الشمس… هذه مختلفة بسبب الإرادة، أراد الله أن تكون السماء سماء، فكانت، وأن تكون الأرض أرضاً، فكانت، والنجم نجماً، فكان…. وهكذا.
قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة، لكان الكل شيئاً واحداً!
نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم، فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منكم؟!
ما نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات:
الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم، فسوف يتعلق برحمة الله، ويكون منتظراً لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة، مثل: الإحسان، قال الله تعالى فيه: ]ِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ[ [الأعراف: 56]، والتقوى، قال تعالى: ] فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ [ [الأعراف: 156]، والإيمان، فإنه من أسباب رحمة الله، كما قال تعالى: ] وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماًً[ [الأحزاب: 43]، ولكما كان الإيمان أقوى، كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل.
صفة الرضى
وقوله: ]رضي الله عنهم ورضوا عنه[( 1 )……………………………………
( 1 ) هذه من آيات الرضى، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضى، وهو يرضى عن العمل، ويرضى عن العامل.
يعني: أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل..
أما بالعمل، فمثل قوله تعالى: ] وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ [ [الزمر: 7]، أي: يرض الشكر لكم.
وكما في قوله تعالى: ] وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناًً[ [المائدة: 3]. وكما في الحديث الصحيح: “إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً…“رواه البخاري[93].
فهذا الرضى متعلق بالعمل.
ويتعلق الرضى أيضاً بالعامل، مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف: ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه [ [المائدة: 119].
فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه، وليست شيئاً منفصلاً عنه: كما يدعيه أهل التعطيل.
ولو قال لك قائل: فسر لي الرضى. لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها أجلي وأوضح من لفظها.
فنقول: الرضى صفة في الله عز وجل، وهي صفة حقيقية، متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالاً ويكره أعمالاً.
ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي، كما سبق، وبالدليل العقلي، فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضى.
فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد ينازع فيه، لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر. وهذا إيراد قوي.
ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج، وليس عن رضى:
كما قال تعالى: ] وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ( 182 ) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ[ [الأعراف: 182-183].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه، لم يفلته“، وتلا قوله تعالى: ) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( [هود: 102].رواه البخاري ومسلم[94].
وقال تعالى: ] فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ( 44 ) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [ [الأنعام: 44-45].
أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه.
آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض
ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الصفات خمس آيات:
وقوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [( 1 )……………………………………………………………………………..
( 1 ) الآية الأولى: قوله: ] وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [ [النساء: 93].
* ]ومن[: شرطية. و( من ) الشرطية تفيد العموم.
* ]مؤمناً[: هو من آمن بالله ورسوله، فخرج به الكافر والمنافق.
لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان، فهو آثم، لكن لا يستحق الوعيد المذكور في الآية.
وأما المنافق، فهو معصوم الدم ظاهراً، ما لم يعلن بنفاقه.
* وقوله ]متعمدا[: يدل على إخراج الصغير وغير العاقل، لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد، وعلى إخراجا لمخطئ، وقد سبق بيانه في الآية التي قبلها.
فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم.
* ]جهنم[: اسم من أسماء النار.
* ]خالداً فيها[، أي: ماكثاً فيها.
* ]وغضب الله عليه[: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية.
* ]ولعنه[: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
* فهذه أربعة أنواع من العقوبة، والخامس: قوله: ]وأعد له عذاباً عظيماً[.
خمس عقوبات، واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب.
ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار، حيث رتب على القتل، والقتل ليس بكفر، ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر.
وأجيب عن ذلك بعدة أوجه:
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن.
لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً فيها وإن لم يقتل المؤمن: ] إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ( 64 ) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً [ [الأحزاب، 64-65].
الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر.
وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله، فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله.
ولا يستقيم هذا الجواب أيضاً.
الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط، أي: فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه.
وفي هذا نظر، أي فائدة في قوله: ]فجزاؤه جهنم[، ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه، فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم، فمعناه أنه صار خالداً في النار، فتعود المشكلة مرة أخرى، ولا نتخلص.
فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض.
الوجه الرابع: أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع، لم ينفذ السبب، كما نقول: القرابة سبب للإرث، فإذا كان القريب رقيقاً، لم يرث، لوجود المانع وهو الرق.
ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر، وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟
فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملاً، قد يوجد، وقد لا يوجد، فهو على خطر جداً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً“رواه البخاري[95]. فإذا أصاب دماً حراماً والعياذ بالله، فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه.
وعلى هذا، فيكون الوعيد هنا باعتبار المال، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سبباً لكفره، وحينئذ يموت على الكفر، فيخلد.
فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب، فالقتل عمداً سبب لأن يموت الإنسان على الكفر، والكفر سبب للتخليد في النار.
وأظن هذا إذا تأمله الإنسان، يجد أنه ليس فيه إشكال.
الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل، وليس المراد به المكث الدائم، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: فلان خالد في الحبس، والحبس ليس بدائم. ويقولون: فلا خالد خلود الجبال ، ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً.
وهذا أيضاً جواب سهل لا يحتاج إلى تعب، فنقول: إن الله عز وجل لم يذكر التأبيد، لم يقل: خالداً فيها أبداً بل قال: ]خالداً فيها[، والمعنى: أنه ماكث مكثاً طويلاً.
الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه، لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر:
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
أوعدته بالعقوبة، ووعدته بالثواب، لمخلف إبعادي ومنجز موعدي.
وأنت إذا قلت لابنك: والله، إن ذهبت إلى السوق، لأضربنك بهذا العصا. ثم ذهب إلى السوق، فلما رجع، ضربته بيدك، فهذا العقاب أهون على ابنك، فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد، ثم عفا عنه، فهذا كرم.
ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول: إن نفذ الوعيد، فالإشكال باق، وإن لم ينفذ، فلا فائدة منه.
هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها الخامس، ثم الرابع.
مسألة: إذا تاب القاتل، هل يستحق الوعيد؟
الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن، لقوله تعالى: ] )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ( 68 ) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ( 69 ) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات[ [الفرقان: 68-70]، وهذا واضح، أن من تاب ـ حتى من القتل ـ، فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات.
والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل، الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً، فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد، فقال له: إنه قتل تسعاً وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟! فالعابد استعظم الأمر، وقال: ليس لك توبة! فقتله، فأتم به المائة. فدل على عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية، فيها أهل خير وصلاة، فسافر الرجل، وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاة، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى أنزل الله بينهم حكماً، وقال: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب، فهو من أهلها، فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمةرواه البخاري[96].
فأنظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته، مع أن الله جعل عليهم آصاراً وأغلالاً، وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال، فالتوبة في حقها أسهل، فإذا كان هذا في بني إسرائيل، فكيف بهذه الأمة؟
فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن القاتل ليس له توبة رواه مسلم[97]؟
فالجواب: من أحد الوجهين:
1- إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمداً توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة، فإنه لا يسقط عنه الإثم، بل يؤاخذ به.
2- وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، والثالث لأولياء المقتول.
أ- أما حق الله، فلا شك أن التوبة ترفع، لقوله تعالى: ] قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً[ [الزمر: 53]، وهذه في التائبين.
ب- وأما حق أولياء المقتول، فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم، واصنعوا ما شئتم فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية، أو يعفوا، والحق لهم.
جـ- وأما حق المقتول، فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا.
وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له، أي: بالنسبة لحق المقتول.
على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحاً، فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهداراً لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفواً عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئاً، ويؤيد هذا عموم آية الفرقان: )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ….. )[ إلى قوله: ] إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات [ [الفرقان: 70].
وفي هذه الآية من صفات الله: الغضب، واللعن وإعداد العذاب.
وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمداً.
وقوله: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ( ( 1 )……………………
( 1 )* الآية الثانية: قوله: ] ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [ [محمد: 28].
* ]ذلك[: المشار إليه ما سبق، والذي سبق هو قوله تعالى: )فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ) ( )ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) [محمد: 27-28]، يعني: فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟
* ]ذلك[، أي: ضرب الوجوه والأدبار.
* ]بأنهم [، أي: بسبب، فالباء للسببية.
* ]اتبعوا ما أسخط الله[، أي: الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل.
* أما ما فيه رضى الله، فحالهم فيه قوله: ]وكرهوا رضوانه[، أي كرهوا ما فيه رضاه، فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة، أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم.
وفي هذه الآية من صفات الله: إثبات السخط والرضى.
وسبق الكلام على صفة الرضى، وأما السخط، فمعناه قريب من معنى الغضب.
وقوله:( فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُم( ( 1 )…………………………………………
( 1 ) الآية الثالثة: قوله: ] فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُم [ [الزخرف: 55].
* ]آسفونا[، يعني: أغضبونا وأسخطونا.
* ]فلما[: هنا شرطية، فعل الشرط فيها: ]آسفونا[، وجوابه: ]انتقمنا منهم[.
ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب الانتقام، أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه، فيقولون: غضبه، أي انتقامه، أو بالإرادة لأنهم يقرون بها، ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به.
ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضى، فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم.
وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل.
فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضى، لأن الباب واحد.
ونقول: بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب، وليس دليلاً على الرضى، ولا على انتفاء الغضب والسخط.
ونقول: هذه الآية: ] فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُم [ [الزخرف: 55]: ترد عليكم، لأنه جعل الانتقام غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط.
مسألة:
بقي أن يقال: ] فَلَمَّا آسَفُونَا [: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟
الجواب: لا، ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان:
المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن، مثل قول الله تعالى عن يعقوب: ) يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْن [ [يوسف: 84].
الثاني: الأسف بمعنى الغضب، فيقال: أسف عليه يأسف، بمعنى: غضب عليه.
والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل. والثاني: مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه، فقال: ]فلما آسفونا انتقمنا منهم[.
وفي الآية من صفات الله: الغضب، والانتقام.
ومن الناحية المسلكية: التحذير مما يغضب الله تعالى.
وقوله: ] كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ [( 1 )………………………………
( 1 ) ( 1 ) الآية الرابعة: قوله: ] وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ [ [التوبة: 46].
* يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم، لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا، كانوا كما قال الله تعالى: ] لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَة [ [التوبة: 47]، وإذا كانوا غير مخلصين، وكانوا مفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك: فـ] كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ [، يعني: جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد.
] وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ [ [التوبة: 46]: قيل: يحتمل أن الله قال ذلك كوناً. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد مع القاعدين، ففلان لم يخرج، وفلان لم يخرج، ممن عذرهم الله عز وجل، كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون: إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا.
ويمكن أن جمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك، وقعدوا، فهم ما قعدوا إلا يقول الله عز وجل.
وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره، وهذا أيضاً ثابت في الكتاب والسنة:
– قال الله تعالى: ] وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ…..[ إلى قوله: ] كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً [ [الإسراء: 23-38].
– وكما في هذه الآية التي ذكها المؤلف: ] وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ [ [التوبة: 46].
– وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله كره لكم قيل وقال“رواه البخاري[98].
فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة، أن الله تعالى يكره.
وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل، كما في قوله: ] وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ [ [التوبة: 46]، وكما في قوله: ]كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً [ [الإسراء: 38].
وتكون أيضاً للعامل، كما جاء في الحديث: “إن الله تعالى إذا أبغض عبداً، نادى جبريل، إني أبغض فلاناً، فأبغضه“رواه مسلم[99]
وقوله: ] كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [( 1 )……………………….
( 1 ) الآية الخامسة: قوله: ] كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [ [الصف: 3].
* ]كبر[، بمعنى: عظم.
* ]مقتاً[: تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض، وفاعل ]كبر[ بعد أن حول الفاعل إلى تمييز: ( أن ) وما دخلت عليه في قوله: ]أن تقولوا ما لا تفعلون[.
وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها: ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ( 2 ) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [ [الصف: 2-3]، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل.
ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله، فأنت بين أمرين: إما كاذب فيما تقول، ولكن تخوف الناس، فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة. وإما أنك مستكبر عما تقول، تأمر الناس به ولا تفعله، وتنهى الناس عنه وتفعله.
وفي الآية من الصفات: المقت، وأنه يتفاوت.
ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان مالا يفعل.
آيات صفة المجيء والإتيان
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان آيات أربع.
قوله: ] هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْر [ ( 1 ).
( 1 ) الآية الأول: قوله: ] هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْر [ [البقرة: 210].
* قوله: ]هل ينظرون[: ]هل[: استفهام بمعنى النفي، يعني: ما ينظرون، وكلما وجدت ( إلا ) بعد الاستفهام، فالاستفهام يكون للنفي. هذه قاعدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: “هل أنت إلا إصبع دميت“رواه البخاري ومسلم[100]، أي: ما أنت.
* ومعنى: ]ينظرون[ هنا: ينتظرون لأنها لم تتعد بـ( إلى )، فلو تعدت بـ( إلى ) لكان معناها النظر بالعين غالباً، أما إذا تعدت بنفسها، فهي بمعنى: ينتظرون. أي: ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة.
* ]يأتيهم الله في ظلل[: و]في[: هنا بمعنى ( مع )، فهي للمصاحبة، وليس للظرفية قطعاً، لأنها لو كانت للظرفية، لكانت الظلل محيطة بالله، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
* فـ]في ظلل[، أي: مع الظل، فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده ]تشقق السماء بالغمام[: غمام أبيض، ظلل عظيمة، لمجيء الله تبارك وتعالى.
* وقوله: ]في ظلل من الغمام[ الغمام، قال العلماء: إنه السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل: ] وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَام [ [البقرة: 57]، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيراً، بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحصل به الظلمة، وهو أجمل منظراً.
* وقوله: ]والملائكة[: الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني: أو تأتيهم الملائكة، وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة، ومن هم الملائكة.
والملائكة تأتي يوم القيامة، لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة وهكذا… إلى السابعة؟ يحيطون بالناس.
وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، يحذر الله به هؤلاء المكذبين.
وقوله )هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك( 1 )……………………….
( 1 ) الآية الثانية: قوله: ] هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك [ [الأنعام: 158].
* نقول في ]هل ينظرون[ ما قلناه في الآية السابقة، أي: ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال:
أولاً: ]إلا أن تأتيهم الملائكة[، أي: لقبض أرواحهم، قال الله تعالى: ] وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ [ [الأنفال: 50].
ثانيا: ( أو يأتي ربك ) يوم القيامة للقضاء بينهم .
ثالثا: ]أو يأتي ربك[: وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلمرواه البخاري[101].
وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث: لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم، لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى: ] وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ [ ( النساء: 18 ).
وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً مما هم عليه.
وذكر الحالة الثالثة بين الحالين، لأن وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه.
والغرض من هذه الآيات والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم.
( كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً ) ( 21 ) ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفاّ ) ( 1 )…………….
( 1 )الآية الثالثة: قوله: )كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً ) ( 21 ) ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّا )[الفجر: 21-22 * ]كلا[ هنا للتنبيه، مثل ( ألا ).
* وقوله: ]إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّا[: هذا يوم القيامة.
وأكد هذا الدك لعظمته، لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك، حتى تكون الأرض كالأديم، والأديم هو الجلد، قال الله تعالى: ]فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ( 106 ) لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً[ [طه: 106-107]. ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيساً لا تأكيداً، ويكون المعنى: دكاً بعد دك.
* قال ] وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّا[: ]وجاء ربك[، يعني: يوم القيامة، بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس يأتي الله للقضاء بين عباده.
* وقوله: ]والملك[: ( الـ ) هنا للعموم، يعني: وكل ملك، يعني: الملائكة ينزلون في الأرض.
* ]صفاً صفا[، أي: صفاً من وراء صف، كما جاء في الأثر: “تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة”تفسير السعدي[102] هكذا.
] وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً [( 1 )…………………………
( 1 ) الآية الرابعة: قوله: ]وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً [ [الفرقان: 25].
* يعني: اذكر يوم تشقق السماء بالغمام.
* و ]تشقق[: أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها تشقق شيئاً فشيئاً، ويخرج هذا الغمام، يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئاً فشيئاً.
تشقق السماء بالغمام، مثل ما يقال: تشقق الأرض بالنبات، يعني: يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعاً، وذلك لمجيء الله عز وجل للفضل بين عباه، فهو يوم رهيب عظيم.
* قوله: ] وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً [: ينزلون من السماوات شيئاً فشيئاً، تنزل ملائكة السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة… وهكذا.
وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى، بدليل الآيات السابقة.
هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله، وهي: المجيء والإتيان.
وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً من غيره وأحسن حديثاً، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة، فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثاً.
لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟
الجواب: لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء، ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات، جهلت الصفات، أي: كيفيتها، فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا.
فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا.