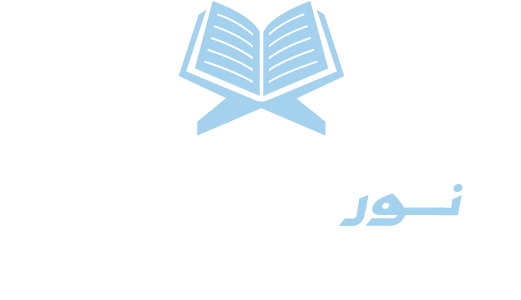(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:25)
(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:25)
التفسير:
.{ 25 } مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به، فقال تعالى: { وبشر… } الآية؛ و “البشارة” هي الإخبار بما يسر؛ وسميت بذلك لتغير بَشَرة المخاطَب بالسرور؛ لأن الإنسان إذا أُخبر بما يُسِرُّه استنار وجهه، وطابت نفسه، وانشرح صدره؛ وقد تستعمل “البشارة” في الإخبار بما يسوء، كقوله تعالى: { فبشرهم بعذاب أليم } [آل عمران: 21] : إمَّا تهكماً بهم؛ وإما لأنهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم، وتَسودَّ به وجوههم، وتُظلِم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: {ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 48، 49] ..
والخطاب في قوله تعالى: { بشِّر } إما للرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو لكل من يتوجه إليه الخطاب . يعني بشِّر أيها النبي؛ أو بشِّر أيها المخاطَب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات..
قوله تعالى: { الذين آمنوا } أي بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به، ورسوله؛ وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره؛ لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها؛ بل لا بد من قبول، وإذعان؛ وإلا لما صح الإيمان..
قوله تعالى: { وعملوا الصالحات } أي عملوا الأعمال الصالحات . وهي الصادرة عن محبة، وتعظيم لله عزّ وجلّ المتضمنة للإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله؛ فما لا إخلاص فيه فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: “أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”(رواه مسلم) ؛ وما لم يكن على الاتِّباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (: “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(رواه البخاري)” ..
قوله تعالى: { أن لهم جنات }: هذا المبشر به: أن لهم عند الله عزّ وجلّ { جنات… }: جمع “جنَّة”؛ وهي في اللغة: البستان كثير الأشجار بحيث تغطي الأشجار أرضه، فتجتن بها؛ والمراد بها شرعاً: الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر..
قوله تعالى: { تجري من تحتها الأنهار } أي تسيح من تحتها الأنهار؛ و{ الأنهار } فاعل { تجري }؛ و{ من تحتها } قال العلماء: من تحت أشجارها، وقصورها؛ وليس من تحت سطحها؛ لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار، والقصور! يجد الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها..
وقد بيّن الله تعالى أنها أربعة أنواع، كما قال تعالى: {مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفَّى} (محمد: 15) .
قوله تعالى: { كلما رزقوا } أي أعطوا؛ { منها} أي من الجنات؛ {من ثمرة} أي من أيّ ثمرة؛ { قالوا هذا الذي رزقنا من قبل } لأنه يشبه ما سبقه في حجمه، ولونه، وملمسه، وغير ذلك من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافاً عظيماً؛ ولهذا قال تعالى: { وأتوا به متشابهاً }؛ وما أجمل وألذّ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافاً عظيماً! تجده يجد في نفسه حركةً لهذا الفاكهة، ولذةً، وتعجباً؛ كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد! ولهذا لو قُدم لك فاكهة ألوانها سواء، وأحجامها سواء، وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص، وهذه مُز . أي حلو مقرون بالحموضة . وهذه حامضة؛ تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء، أو كانت مختلفة..
قوله تعالى: { وأتوا به متشابهاً }؛ { أتوا } من “أتى” التي بمعنى جاء؛ فالمعنى: جيء إليهم به متشابهاً يشبه بعضه بعضاً . كما سبق..
قوله تعالى: { ولهم فيها أزواج }؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج؛ لأن في كل منهما تفكهاً، لكن كل واحد من نوع غير الآخر: هذا تفكه في المذاق، والمطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع ثان؛ لأن بذلك يتم النعيم؛ و{ أزواج } جمع زوج؛ وهو شامل للأزواج من الحور، ومن نساء الدنيا؛ ويطلق “الزوج” على الذكر، والأنثى؛ ولهذا يقال للرجل: “زوج”، وللمرأة: “زوج”؛ لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقاً بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث..
قوله تعالى: { مطهرة } يشمل طهارة الظاهر، والباطن؛ فهي مطهرة من الأذى القذر: لا بول، ولا غائط، ولا حيض، ولا نفاس، ولا استحاضة، ولا عرق، ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي؛ مطهرة أيضاً من الأقذار الباطنة، كالغل، والحقد، والكراهية، والبغضاء، وغير ذلك..
قوله تعالى: { هم فيها خالدون } أي ماكثون لا يخرجون منها..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ لقوله تعالى: {وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات}؛ ولقول الله تبارك وتعالى: {وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين} [الصافات: 112] ، وقوله تعالى: {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] ، وقوله تعالى: {فبشرناه بغلام حليم} [الصافات: 101] ؛ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين . عليهم الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة، كما لو أدرك رمضان، فقلت: هنّاك الله بهذا الشهر؟ الجواب: نعم؛ وكذلك أيضاً لو أتم الصوم، فقلت: هنّأك الله بهذا العيد، وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس به، وقد كان من عادة السلف..
.2 ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان، والعمل الصالح..
فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟
فالجواب: أن التواصي بالحق، والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحياناً يُذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل، وسبب من الأسباب..
.3 ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا، وأعظم؛ لأنهم مهما آمنوا، وعملوا فالعمر محدود، وينتهي؛ لكن الجزاء لا ينتهي أبداً؛ هم مخلدون فيه أبد الآباد؛ كذلك أيضاً الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا منّ الله عليه، فدخل الجنة فالنعيم كامل..
.4 ومنها: أن الجنات أنواع؛ لقوله تعالى: { جنات }؛ وقد دل على ذلك القرآن، والسنة؛ فقال الله تعالى: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} [الرحمن: 46] ، ثم قال تعالى: {ومن دونهما جنتان} [الرحمن: 62] ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم “جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما؛ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما(رواه البخاري)” ..
.5 ومنها: تمام قدرة الله عزّ وجلّ بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا؛ لأن أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها؛ وليس في الدنيا أنهار من لبن، ولا من عسل، ولا من خمر؛ وقد جاء في الأثر(أخرجه الطبري في تفسيره) أنها أنهار تجري من غير أخدود . يعني لم يحفر لها حفر، ولا يقام لها أعضاد تمنعها؛ بل النهر يجري، ويتصرف فيه الإنسان بما شاء . يوجهه حيث شاء؛ قال ابن القيم رحمه الله في النونية:.
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 6 . ومن فوائد الآية: أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابهاً؛ وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل؛ وهذا من تمام النعيم، والتلذذ بما يأكلون..
.7 ومنها: إثبات الأزواج في الآخرة، وأنه من كمال النعيم؛ وعلى هذا يكون جماع، ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؛ ولهذا ليس في الجنة مَنِيّ، ولا مَنِيَّة؛ والمنيّ الذي خلق في الدنيا إنما خُلق لبقاء النسل؛ لأن هذا المنيّ مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولداً؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا حاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين لا يفنى منهم أحد؛ ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم، ويخدمهم؛ الوِلدان تطوف عليهم بأكواب، وأباريق، وكأس من معين؛ ثم هم لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها؛ بل الأمر فيها كما قال الله تعالى: {وجنى الجنتين دان} [الرحمن: 54] ، وقال تعالى: {قطوفها دانية} [الحاقة: 23] ؛ حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة، فيحسّ أنه يشتهيها، فيدنو منه الغصن حتى يأخذها؛ ولا تستغرب هذا؛ فنحن في الدنيا نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة؛ وما في الآخرة أبلغ، وأبلغ..
.8 ومن فوائد الآية: أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد؛ لا يمكن أن تفنى، ولا يمكن أن يفنى من فيها؛ وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة..
(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ) (البقرة:26)
التفسير:
.{ 26 } قوله تعالى: { إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما } أي لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلاً ولو كان مثلاً حقيراً ما دام يثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ و{ ما } يقولون: إنها نكرة واصفة . أي: مثلاً أيَّ مثل..
قوله تعالى: { بعوضة }: عطف بيان لـ{ ما } أي: مثلاً بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل في الحقارة؛ وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا: كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له} [الحج: 73] : قالوا: الذباب يذكره الله في مقام المحاجة! فبيَّن الله عزّ وجلّ أنه لا يستحيي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة، فما فوقها..
قوله تعالى: { فما فوقها }: هل المراد بما فوق . أي فما فوقها في الحقارة، فيكون المعنى أدنى من البعوضة؛ أو فما فوقها في الارتفاع، فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما أعلى خلقة: الذباب، أو البعوضة؟ الجواب: الذباب أكبر، وأقوى . لا شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية: { فما فوقها } أي فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى، وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام، وللخلف، كما في قوله تعالى: {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً} [الكهف: 79] أي كان أمامهم..
قوله تعالى: { فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه } أي المثل الذي ضربه الله { الحق من ربهم }، ويؤمنون به، ويرون أن فيه آيات بينات..
قوله تعالى: { وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً } لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه، وقد قال الله تعالى: {إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} (المطففين: 13، 14 )..
وقوله تعالى: { ماذا }: “ما” هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و “ذا” اسم موصول بمعنى “الذي” خبر المبتدأ . أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً، كما قال ابن مالك:.
ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو مَن إذا لم تلغ في الكلام قوله تعالى: { يضل به كثيراً }: الجملة استئنافية لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى: { ماذا أراد الله بهذا مثلاً }؛ و{ يضل به } أي بالمثل؛ { كثيراً } أي من الناس؛ { ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين } أي الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: { وأما الذين فسقوا فمأواهم النار } [السجدة: 20] : المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: إثبات الحياء لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما ).
ووجه الدلالة: أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد جاء ذلك صريحاً في السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن ربكم حييّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفراً”(رواه أبو داود) ؛ والحياء الثابت لله ليس كحياء المخلوق؛ لأن حياء المخلوق انكسار لما يَدْهَمُ الإنسان ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسر، ولا يتكلم، أو لا يفعل الشيء الذي يُستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله..
.2 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة؛ انظر إلى قوله تعالى: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً} [العنكبوت: 41] ؛ وهذا البيت لا يقيها من حَرّ، ولا برد، ولا مطر، ولا رياح {وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت} [العنكبوت: 41] ؛ وقال تعالى: {والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه} [الرعد: 14] : إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاً، أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه! هذا لا يمكن؛ هؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه؛ فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى؛ وإما لحكمتها، وبيان وجه هذا المثل..
.3 ومن فوائد الآية: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ لقوله تعالى: { بعوضة فما فوقها }؛ ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلك: لو سُلطت على الإنسان لأهلكته وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة..
.4 ومنها: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم..
.5 ومنها: أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في القرآن، فهو دليل على ثبوت القياس..
.6 ومنها: فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عزّ وجلّ بعقله؛ لقوله تعالى: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم}، ولا يعترضون، ولا يقولون: لِم؟، ولا: كيف؟؛ يقولون: سمعنا، وأطعنا، وصدقنا؛ لأنهم يؤمنون بأن الله عزّ وجلّ له الحكمة البالغة فيما شرع، وفيما قدر..
.7 ومنها: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: { من ربهم }؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وتقتضي التصرف المطلق في العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له، وتقتضي عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: {قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون} [الأعراف: 121، 122] : فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسى، وهارون؛ كما أن مقابل ذلك “العبودية” تنقسم إلى عبودية عامة، كما في قوله تبارك وتعالى: {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً} [مريم: 93] ؛ وخاصة كما في قوله تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] ؛ والفرق بينهما أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ وعلى هذا فالكافر عبد لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله بالعبودية العامة، والخاصة..
.8ومن فوائد الآية: أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله، وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: { وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلًا }؛ وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟
فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عزّ وجلّ؛ وهو دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله عزّ وجلّ . إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد، والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به..
.9 ومن فوائد الآية: أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ لقوله تعالى: { يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً }؛ فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون، والمهتدون سواءً؛ وليس كذلك؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الألف مهتدٍ؛ فكلمة: { كثيراً } لا تعني الأكثر؛ وعلى هذا لو قال إنسان: عندي لك دراهم كثيرة، وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها؛ لأن “كثير” يطلق على القليل، وعلى الأكثر..
.10 ومن فوائد الآية: أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: { وما يضل به إلا الفاسقين }؛ وهذا كقوله تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين} (الصف: 5) ..
.11 ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله . لا علاقة لإرادة الله تعالى به؛ لقوله تعالى: ( وما يضل به إلا الفاسقين )..