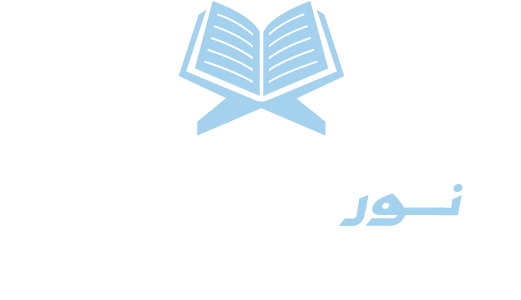الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر:
* قوله: “وَأمّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ”؛ يعني: من درجات الإيمان بالقدر.
* قوله: “فَهِيَ مَشيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ الإيمانُ بِأنَّ ما شاءَ اللهُ كانَ، وَما لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ، وَأنَّهُ ما في السَّماواتِ وما في الأرض مِن حَرَكَةٍ وَلا سُكونٍ إلَّا بِمَشيئَةِ اللهِ سُبْحانَهُ”.
* يعني: أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته شاملة، {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا} [فاطر: ٤٤].
وهذه الدرجة تتضمن شيئين؛ المشيئة والخلق:
– أما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين.
فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر.
– وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء.
* والدليل على هذا:
قوله تعالى: {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: ١٤٩].
وقوله سبحانه: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} [هود: ١١٨].
وقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا} [البقرة: ٢٥٣].
فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله.
وقال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: ٣٠].
وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها.
* قوله: “لا يكونُ في مُلْكِهِ ما لا يُريدُ”.
* هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل: لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية؛ فيكون في ملكه ما لا يريد.
وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية، وإرادة شرعية:
– فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} [هود: ٣٤].
– والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ومثالها قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٧].
وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما:
– ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع، سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه، سواء وقع أم لم يقع.
– وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد.
* وعلى هذا يكون قول المؤلف: “ولا يكون في ملكه ما لا يريد”؛ يعني به: الإرادة الكونية.
* فإن قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟
فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا يحبها، وأما بالإرادة الكونية؛ فهي مرادة له سبحانه؛ لأنها واقعة بمشيئته.
قوله: “وَأنَّهُ سُبْحانَهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ مِنَ المَوْجوداتِ وَالمعدوماتِ”.
* كل شيء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات؛ فيوجدها.
فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده.
فمثلًا؛ كل موجود؛ فالله قادر أن يعدمه، وقادر أن يغيره؛ أي: ينقله من حال إلى حال، وكل معدوم؛ فالله قادر على أن يوجده؛ مهما كان؛ كما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ٢٠].
* ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك، وقال: إلا ذاته؛ فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك!!
فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟
– إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصًا؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العلم، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل؛ فهذا لا تتعلق به القدرة أصلًا؛ لأن الواجب مستحيل العدم، والمستحيل مستحيل الوجود.
– وإن أردت بقولك: إنه غير قادر على ذاته: أنه غير قادر
على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجيء أو نحوه! فهذا خطأ، بل هو قادر على ذلك، وفاعل له، ولو قلنا: إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه.
وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير.
* وإنما نص المؤلف على هذا ردًّا على القدرية الذين قالوا: إن الله ليس بقادر على فعل العبد!! وإن العبد مستقل بعمله! ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم.
* قوله: “فَما مِن مَخْلوقٍ في الأرضِ وَلا في السَّماءِ إلَّا اللهُ خالِقُهُ سُبْحانَهُ لا خالِقَ غيْرُهُ وَلا رَبَّ سِواهُ”.
* وهذا صحيح بلا شك.
* ولهذا دليل أثري ودليل نظري:
– أما الدليل الأثري:
فقد قال الله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢].
وقال تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ} [الطور: ٣٥، ٣٦].
فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده.
ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديًا أمرنا أن نستمع له، فقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ}، ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم أربابًا، فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابًا، وهو أخس الأشياء وأهونها؛ فما فوقه من باب أولى، بل قال: {وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ} [الحج: ٧٣]، فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه.
فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئًا؟!
فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ يعني: على فرض أن يسلبهم الذباب شيئًا؛ لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم: بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام، ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب.
وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها، واستنقاذ حقها؛ فهي عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز.
والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن لا خالق إلا الله؛ فيجب الإيمان بعموم خلق الله عزَّ وجلَّ، وأنه خالق كل شيء، حتى أعمال العباد؛ لقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: ١٦]، وعمل الإنسان من الشيء، وقال تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: ٢] … والآيات في هذا كثيرة.
وفيه آية خاصة في الموضوع، وهو خلق أفعال العباد:
فقال إبراهيم لقومه: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦].
فـ (ما) مصدرية، وتقدير الكلام: خلقكم وعملكم، وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى.
فإن قيل: ألا يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولًا، ويكون المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه؟
فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلًا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟
فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله؛ لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقًا؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقًا لله، وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقًا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين.
– وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ فتقريره أن نقول: إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة.
مثال ذلك: أردت أن أعمل عملًا من الأعمال؛ فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقًا بأمرين هما:
أحدهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما فعلته.
الثاني: القدرة التامة، لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله عزَّ وجلَّ، وهو الذي أودع فيك العزيمة، وخالق السبب التام خالق للمسبب.
– ووجه ثان نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف.
فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله، وداخل في عموم الخلق أثريًّا ونظريًّا، والدليل الأثري قسمان عام وخاص، والدليل النظري له وجهان.
* وقوله: “لا خالق غيره”:
* إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقًا غير الله؛ فالمصور يعد نفسه خالقًا، بل جاء في الحديث أنه خالق: “فإن المصورين يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم” (رواه البخاري ومسلم)، وقال عز وجل: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: ١٤]؛ فهناك خالق، لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين؛ فما الجواب عن قول المؤلف؟
الجواب: أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عزَّ وجلَّ هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عزَّ وجلَّ، ولا أحد يبدل عينًا إلى عين؛ إلا الله عزَّ وجلَّ، وما قيل: إنه خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة؛ فالخشبة مثلًا بدلًا من أن كانت في الشجرة، تحولت بالنجارة إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقًا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم، أو تبديل العين من عين إلى أخرى.
* وقوله: “لا رب سواه”؛ أي: أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي.
* ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله:
ففي لقطة الإبل قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “دعها؛ معها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها” (رواه البخاري ومسلم) وربها: صاحبها.
وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل؛ يقول: “إذا ولدت الأمة ربها” (رواه البخاري ومسلم).
فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف: “لا رب سواه”؟
نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة؛ كل شيء؛ فالله ربه، لا يسأل عما يفعل في خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة، ولهذا يقدر الله عزَّ وجلَّ الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية المخلوق للمخلوق؛ فربوبية ناقصة قاصرة، لا تتجاوز محلها، ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفًا تامًّا، بل تصرفه مقيد: إما بالشرع، وإما بالعرف.
* قوله: “ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته”.
* يعني: ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملًا، ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته.
وأمره بذلك أمر ممكن؛ فالمأمور مخلوق لله عزَّ وجلَّ، وفعله مخلوق لله، ومع ذلك؛ يؤمر وينهى.
ولو كان الإنسان مجبرًا على عمله؛ لكان أمره أمرًا بغير ممكن، والله عزَّ وجلَّ يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، ويقول تعالى: {لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [الأنعام: ١٥٢]، وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة، وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك.
* قوله: “وَهُوَ سُبْحانَهُ يُحِبُّ المُتَّقينَ وَالمُحْسِنينَ وَالمُقْسِطينَ”.
* يعني أن الله عزَّ وجلَّ يحب المحسنين؛ لقوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥]، والمتقين؛ لقوله: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: ٧]، والمقسطين؛ لقوله: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩].
فهو عزَّ وجلَّ يحب هؤلاء، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه، فكان فعلهم محبوبًا إلى الله مرادًا له كونًا وشرعًا؛ فالمحسن قام بالواجب والمندوب، والمتقي قام بالواجب، والمقسط اتقى الجور في المعاملة.
* قوله: “وَيَرْضَى عَنِ الذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ وَلا يُحِبُّ الكافِرينَ”.
* “يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات”: والدليل قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: ١٠٠]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [البينة: ٧، ٨].
* قوله: “ولا يحب” الله عزَّ وجلَّ “الكافرين”.
والدليل قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ٣٢].
مع أن الكفر واقع بمشيئته، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته، أن يكون محبوبًا له سبحانه وتعالى.
* قوله: “ولا يرضى عن القوم الفاسقين”: والدليل قوله تعالى: {فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: ٩٦].
* والفاسق -وهو الخارج عن طاعة الله- قد يراد به الكافر، وقد يراد به العاصي.
– ففي قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} [السجدة: ١٨ – ٢٠]؛ فالمراد بالفاسق الكافر.
– وأما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]؛ فالمراد بالفاسق العاصي.
* فالله عزَّ وجلَّ لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقًا، وأما الفاسقون بمعنى العصاة؛ فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه، ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه.
* قوله: “ولا يأمر بالفحشاء”: والدليل قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}، لأنهم إذا فعلوا فاحشة: {قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا}؛ فاحتجوا بأمرين، فقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}، وسكت عن قولهم: {وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا}؛ لأنه حق لا ينكر، لكن {وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} كذب، ولهذا كذبهم وأمر نبيه أن يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [الأعراف: ٢٨]، ولم يقل: ولم يجدوا عليها آباءهم؛ لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم.
* قوله: “ولا يرضى لعباده الكفر”: لقوله تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: ٧]، لكن يقدر أن يكفروا، ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيًا به سبحانه وتعالى، بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه.
* قوله: “ولا يحب الفساد”: دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: ٢٠٥].
* كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبًا له، ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادًا له بالإرادة الكونية، بل هو عزَّ وجلَّ يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يرضى عنه، ولا يريده بالإرادة الشرعية.
* فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟!
فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه، وهذا الذي يقع من فعله عزَّ وجلَّ وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر؛ لِما يترتب عليه من المصالح العظيمة.
فمثلًا، الإيمان محبوب لله، والكفر مكروه له، فأوقع الكفر وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف الإيمان، ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف، ولولا وجود الكفر؛ ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثًا؛ لأن النار مثوى الكافرين، ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة واحدة، ولم يعرفوا معروفًا ولم ينكروا منكرًا، وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني، ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية الله؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله.
وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له، ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة، لكن المرض مكروه للإنسان، وقد يكون عقوبة من الله له، ومع ذلك يوقعه؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة.
كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عزَّ وجلَّ، كما قال تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: ٦، ٧]، وهذه مفسدة عظيمة؛ فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه، حتى يرجع إلى الله، وشاهد هذا قوله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: ٤١].
وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عزَّ وجلَّ؛ عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة، قد تحيط بها، وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك، وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك.
* فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروهًا لله ومرادًا له؟
فالجواب: أنه لا غرابة في ذلك، فها هو الدواء المر طعمًا الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو مرتاح، لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء، وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب، وربما كواه هو بنفسه، مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار. 2/218