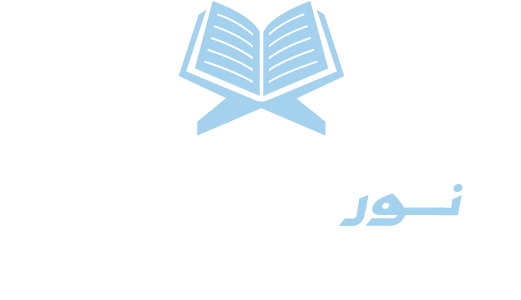ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “حبب إلى ما دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة“[رواه النسائي]، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيماناً، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه.
ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “حبب إلى ما دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة“[رواه النسائي]، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيماناً، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه.
فإذا قيل للشخص: إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فانشرح صدره، وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه، لكان بدعة، وأقبل إليه، ورضي به، فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيراً.
* قال: ]يشرح صدره للإسلام[: ]يشرح صدره[: بمعنى يوسع، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون: ] قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي [ [طه: 25]، يعني: وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جباراً عنيداً.
وقوله: ]للإسلام[: هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته، وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً، كان أدل على إرادة الله به الهداية.
* وقوله: ] وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [: من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ، أي شديد الضيق ثم مثل ذلك بقوله: ] كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [، يعني: كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء، ولهذا جاءت الآية: ] يَصَّعَّدُ [، بالتشديد، ولم يقل: يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة، وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم.
ولنفرض أن هذا رجل طُلِبَ منه أن يصعد جبلاً رفيعاً وصعباً، فإذا قام يصعد هذا الجبل، سوف يتكلف، وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب، لأنه يجد من هذا ضيقاً.
وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن، يقولون: إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه، كثر عليه الضغط، وصار أشد حرجاً وضيقاً، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء.
ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل.
والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، لأنه قال: ]فمن يرد الله أن يهديه[، ]ومن يرد أن يضله[، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات، أما الشرعية، فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله.
وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله، أصله وفرعه، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك، فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من يرد الله به خيراً، يفقهه في الدين“رواه البخاري ومسلم ، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه، قبله وأحبه.
قال تعالى: ] فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماًً[ [النساء: 65]، فهذا أقسام مؤكد بـ( لا )، وأقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ـ وهي ربوبية الله للرسول ـ على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور:
الأول: تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: ] حَتَّى يُحَكِّمُوكَ [، يعني: الرسول: فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله، فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإما كافر كفراً دون ذلك.
الثاني: انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم .
الثالث: أن يسلموا تسليماً، وأكد التسليم بمصدر، يعني: تسليماً كاملاً.
فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان.
ولنضرب لهذا مثلاً: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية، فاستدل أحدهما بالسنة، فوجد الثاني في ذلك حرجاً وضيقاً، كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه، لأن المؤمن حقاً هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها، ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم.
أقسام الإرادة:
الإرادة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تماماً للمشيئة، فـ( أراد ) فيها بمعنى ( شاء )، وهذه الإرادة:
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه.
وعلى هذان فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل، ما وقع.
ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد، يعني: أن ما أراده الله فلا بد أن يقع، ولا يمكن أن يتخلف.
القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة، فـ( أراد ) فيها بمعنى ( أحب )، فهي:
أولاً: تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق.
ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية.
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين:
1- الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم.
2- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه.
فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه، بمعنى: كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟!
فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر، فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصية.
ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروها باعتبارين، فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط، لقاتله، لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه، وهو ينظر إليه، وهو فرح مسرور، يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه، وهو راض بذلك، لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن؟ لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك.
ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين:
الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله، لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل.
الأمر الثاني: أن نفعل ما يريده الله شرعاً، فإذا علمت أنه مراد لله شرعاً ومحبوب إليه، فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله.
هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية، فالأول باعتبار الإرادة الكونية، والثاني: باعتبار الإرادة الشرعية.
قوله: ] وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [( 1 )………………………………….
( 1 ) هذه آيات في إثبات صفة المحبة:
الآية الأولى: ] وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [( البقرة: 195 ).
* ] وَأَحْسِنُوا [ فعل أمر.
والإحسان قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً مندوباً إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب، فهو واجب، وما كان زائداً على ذلك فهو مستحب.
وبناء على ذلك، نقول: ] وَأَحْسِنُوا [: فعل الأمر مستعمل في الواجب والمستحب.
والإحسان يكون في عبادة الله، ويكون في معاملة الخلق، فالإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريلرواه البخاري ، فقال: ما الإحسان؟ قال: “أن تعبد الله كأنك تراه“. وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه عبادة طلب ورغبة، “فإن لم تكن تراه، فإنه يراك“، أي: فإن لم تصل إلى هذه الحال، فاعلم أنه يراك والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب، لأنه يخاف ممن يراه.
وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل في تفسيره: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه.
بذل الندى: أي: المعروف، سواء كان مالياً أو بدنياً أم جاهياً.
كف الأذى: أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك.
وطلاقة الوجه: أن لا تكون عبوساً عند الناس، لكن أحياناً الإنسان يغضب ويعبس، فنقول: هذا لسبب، وقد يكون من الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال.
ولهذا، إذا رجمن الزاني أو جلدناه، فهو إحسان إليه.
ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع، والشراء، والإجارة، والنكاح… وغير ذلك، لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور، صبرت على العسر، وأوفيت الحق بسرعة، هذا يعد بذل الندى، فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير، فأنت لم تكف الأذى، لأن هذا أذية. أحسن في عبادة لله وإلى عباد الله.
* وقوله: ]إن الله يحب المحسنين[: هذا تعليل للأمر، فهذا ثواب المحسن، أن الله يحبهن ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة، ووالله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها، وهي أعلى من أن تحب الله، فكون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت، ولهذا قال تعالى: ] قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه [، ولم يقل: فاتبعوني، تصدقوا في محبتكم لله. مع أن الحال تقتضي هكذا، ولكن قال: ] يُحْبِبْكُمُ اللَّه [ [آل عمران: 31].
ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا أنك تحب الله.
كل يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل، هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل، أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض، ويقبلونك، ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن.
وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات الألوهية، والمحبة.
] وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[( 1 )………………………………………
( 1 ) الآية الثانية: قوله: ] وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [ [الحجرات: 9].
* ] وَأَقْسِطُوا [: فعل أمر، والإقساط ليس هو القسط، بل هو من فعل رباعي، فالهمزة فيه همزة النفي، هذه الهمزة هي همزة النفي، إذا دخلت على الفعل، نفت معناه، فالفعل ( قسط )، بمعنى: جار، فإذا أدخلت عليه همزة ( أقسط )، صار بمعنى: عدل، أي: أزال القسط، وهو الجور، فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب، مثل خطئ وأخطأ، خطئ، بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد.
* فقوله: ] وَأَقْسِطُوا [، أي: اعدلوا، وهذا واجب، فالعدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية:
يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل، ينعم الله عليك بالنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره، يبين الله لك الحق، فمن العدل أن تتبع هذا الحق.
ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: “من أحب أن يزحزح عن النار ويدخله الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه” .رواه مسلم
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، مثلاً: إذا أردت أن تعامل شخصاً معاملة، فاعرضها أولاً على نفسك: هل إذا عاملك إنسان بها، هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى، فعامله، وإلا، فلا تعامله .
ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم“رواه البخاري ومسلم
ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث، فيعطى كل واحد نصيبه، ولا يوصى لأحد منهم بشيء.
ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات، بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى.
ويدخل في ذلك العدل في نفسك، فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال، إن لربك عليك حقاً، و لنفسك عليك حقاً.
وعلى هذا فقس.
وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل: المساواة! وهذا خطأ، لا يقال: مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما.
ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟! سووا بين الذكور والإناث! حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم، لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد، ليس للوالد سلطة على الولد… وهلم جراً.
لكن إذا قلنا بالعدل، وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه، زال هذا المحذور، وصارت العبارة سليمة.
ولهذا، لم يأت في القرآن أبداً: أن الله يأمر بالتسوية! لكن جاء: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل( [النحل: 90]،( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل( [النساء: 58].
وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين، إلا أن يريد بالمساواة: العدل، فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ.
ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة: ] قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون [ [الزمر: 9]، ] لْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّور [ [الرعد: 16]، ] لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا [ [الحديد: 10]، ]لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه [ [النساء: 95].
ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً، إنما يأمر بالعدل.
وكلمة ( العدل ) أيضاً تجدونها مقبوله لدى النفوس.
وأحببت أن أنبه على هذا، لئلا نكون في كلامنا إمعة، لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه، فلا يفكر في مدلوله وفيمن وضعه وفي مغزاه عند من وضعه.
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها.
] فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [( 1 )……………………..
( 1 ) الآية الثالثة: قوله: ] فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [ [التوبة: 7].
* ]ما[: شرطية، وفعل الشرط: ]استقاموا[، وجوابه: ]فاستقيموا[، أي: مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتهم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد، فاستقيموا لهم في ذلك.
وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها، أنهم إذا استقاموا لنا، وجب أن نستقيم لهم، وأن نوفي بعهدهم. وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا، لا نستقيم لهم.
والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم، فيجب علينا أن نستقيم لهم، لقوله تعالى: ] فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [.
وقسم خانوا ونقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد لهم، لقوله تعالى: ] وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُم [ [التوبة: 12].
وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا، لكننا نخاف من خيانتهم، بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله فيهم: ] وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [ [الأنفال: 58]، أي: انبذ إليهم عهدهم، فقل: لا عهد بيننا وبينكم.
فإذا قال قائل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟!
قلنا: لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنهم، لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحونا، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء، ولا نخونهم ما دام العهد قائماً، لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم الخيانة، سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام، لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد.
* وقوله: ]المتقين[: المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى.
وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها.
]ِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[( 1 )………………………………….
( 1 ) الآية الرابعة: قوله: ] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينََ [ [البقرة: 222].
* التواب: صيغة مبالغة من التوبة، وهو كثير الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته.
وشروطها خمسة:
الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه.
الثاني: الندم على ما فعل من الذنب، وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه.
الثالث: الإقلاع عن الذنب، بتركه إن كان محرماً، أو تداركه إن كان واجباً يمكن تداركه.
الرابع: العزم على أن لا يعود إليه.
الخامس: أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها، لم تقبل.
فالتواب: كثير التوبة.
ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه، إذا أحدث لكل ذنب توبة، فإن الله تعالى يحبه، والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه، كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى.
* وقوله: ] وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [: الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره.
وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن بقوله: ]التوابين[، والظاهر بقوله: ]المتطهرين[.
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها.
وقوله: ] قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه [( 1 )……………………..
( 1 ) الآية الخامسة: قوله: ] قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه [ [آل عمران: 31].
يسمى علماء السلف هذه الآية: آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوماً ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: ] قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي [، وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله، أن يقال له: إن كنت صادقاً في محبة الله، فاتبع الرسول ، فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وقال: إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته، قلنا له: هذا كذب لو كانت محبتك صادقة، لا تبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه، فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لله أحب.
وإذا أحب الله وقام بعبادته، فإن الله تعلى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل، يقول تعالى في الحديث القدسي: “من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي“، ونفس الله أعظم من نفوسنا. “ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه“. وفي الحديث أيضاً: “أن من تقرب إليه شبراً تقرب الله إليه ذراعاً، ومن تقرب إليه ذراعاً، تقرب إليه باعاً، ومن أتى إلى الله يمشي، أتاه الله هرولة“رواه البخاري.
إذا فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك.
وفي الآية من الأسماء والصفات مما سبق في التي قبلها.
وقوله: ]فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه[( 1 )…………………………….
( 1 )* الآية السادسة: قوله: ] فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [ [المائدة: 54].
* الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله: ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [، أي: إذا ارتددتم عن دين الله، فإن ذلك لا يضر الله شيئاً، ] فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [، وهذا كقوله: ] وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ [ [محمد: 38].
* فكل من ارتد عن دين الله، فإن الله لا يعبأ به، لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه، ]فسوف يأتي الله بقوم[ بدل منهم ]يحبهم ويحبونه[، وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته.
* وتمام الآية: ]أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين[: أما المؤمنين أذلة، يخفضون أجنحتهم للمؤمنين، ويلينون لهم، ويتطامنون، ومع الكفار أعزة أقوياء، لا يظهرون الذل أمام الكافر أبداً.
وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: “وإذا لقيتموهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيقه“رواه مسلم، فإذا لاقاكم اليهود والنصارى، ولو كانوا ألفاً وأنتم عشرة، نشق هذا الجمع، ولا نفسح لهم الطريق، بل نلجئهم إلى أضيقه، فنريهم العز بديننا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر، وأن المتمسك به هو العزيز.
* ]يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم[: يجاهدون في سبيل الله، كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه، وكل إنسان يقابلونه من السلام بما يليق به، فمن قاتلهم بالحديد والنار، قاتلوه بالحديد والنار، ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي، جادلوه بمثل ذلك، فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد.
]ولا يخافون لومة لائم[ لا يخافون نقد الناس عليهم، يقولون الحق ولو كان على أنفسهم.
لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية، فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور، تأخروا، وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال، استعملوه، لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة، والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال.
* ثم قال الله تعالى: ]ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم[.
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، وزيادة أن الله تعالى يكون محبوباً.
وقوله: ]ِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ[( 1 )……………….
( 1 )*الآية السابعة: قوله: ] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ [[الصف: 4].
* هذه الآية في سورة الصف، وسورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد، لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله، ثم دعا إلى الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون.
* ] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاًً[: لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر، حتى في الجهاد.
والصلاة جهاد مصغر، فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبعه، بطلت صلاتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار” رواه مسلم، والصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة “كأنهم بنيان” والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: “يشد بعضه بعضاً“رواه البخاري ومسلم، يتماسك بعضه ببعض، ولهذا قال: ]كأنهم بنيان مرصوص[، فليس كالمفرق: فالمرصوص أشد تماسكاً.
فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات:
أولاً: يقاتلون، فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا.
ثانياً: الإخلاص، لقوله: ]في سبيله[.
ثالثاً: يشد بعضهم بعضاً، لقوله: ]صفاً[.
رابعاً: أنهم كالبنيان، والبنيان حصن منيع.
خامساً: لا يتخللهم ما يمزقهم، لقوله: ]مرصوص[.
هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها.
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها.
وقوله: ]وهو الغفور الودود[( 1 )…………………………………………….
( 1 )* الآية الثامنة: قوله: ] وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ [ [البروج: 14].
*]الْغَفُور[: الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها.
*]الْوَدُود[ مأخوذ من الود، وهو خالص المحبة، وهي بمعنى: واد، وبمعنى: مودود، لأنه عز وجل محب ومحبوب، كما قال تعالى: ] فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [ [المائدة: 54]، فالله عز وجل واد ومودود، واد لأوليائه، وأولياؤه يودونه يحبونه، يحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه.
وفي الآية اسمان من أسماء الله: الغفور، والودود. وصفتان: المغفرة، والود.
وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة، وهي الخلة، لقوله تعالى: ]واتخذ الله إبراهيم خليلاً[ [النساء: 125]، والخليل هو من كان في أعلى المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبداً.
يقول الشاعر لمعشوقته:
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً
فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحداً منهم خليلاً أبداً، قال النبي عليه الصلاة وهو يخطب الناس: “لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر “رواه مسلم ، إذاً، أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحداً خليلاً، لكن إخوة الإسلام ومودته، وأما الخلة، فهي بينه وبين ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً“رواه مسلم.
والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر، إلا لاثنين، هما إبراهيم محمد عليهما الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله اتخذني خليلاً”.
وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا هذين الرسولين الكريمين، فهما خليلان لله عز وجل.
وهذه الآية: ]واتخذ الله إبراهيم خليلاً[ هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية، أول ما أنكر قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً فقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، حيث خرج به موثقاً في يوم عيد الأضحى، وخطب الناس، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، ثم نزل فذبحه.
ويقول ابن القيم في ذلك:
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان
فلدينا الآن محبة وود وخلة، فالمحبة والود مطلقة، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد.
ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية، لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية، لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل الأشاعرة، يقولون: لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبداً، لأن العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل، فإنه يجب أن ننزه الله عنه.
فنحن نقول: نثبت المحبة بالأدلة العقلية، كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية، احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل، فنقول وبالله التوفيق:
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره، هذا يدل بلا شك على المحبة، ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم، وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل؟!
وهنا سؤالان:
الأول: بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي التي يطلبها كل إنسان، والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه، ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته: “هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك” رواه أبو داود والترمذي.
فالجواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة:
منها: أن ينظر الإنسان: من الذي خلقه؟ ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه؟ ومن الذي أجرى إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها، وكثيراً ما تشاهد بعينك آفات ونقماً تهلكك، فيرفعها الله عنك؟
وهذا لا شك أنه يجلب المحبة، ولهذا ورد في الأثر: “أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم”رواه البيهقي .
وأعتقد لو أن أحداً أهدى إليك قلماً، لأحببته، فإذا كان كذلك، فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها، تحب الله.
ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها، تجد قلبك ينشرح، وتحب الذي أسداها إليك، بخلاف النعم الدائمة، فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضاً أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين، إن كان الله من عليك بالعلم، فقد فضلك بالعلم، أو بالعبادة، فقد فضلك بالعبادة، أو بالمال: فقد فضلك بالمال، أو بالأهل، فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت، وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها، فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة، شكرت الله وأحببته.
ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، تحب الذي يحبه الله، فهذا يجعلك تحب الله، لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك، فتحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر، الأخيرة من الأشخاص، والأولى من الأعمال، لأننا أتينا بـ( ما ) التي لغير العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان، وهذه ( من ) للعاقل من الأشخاص، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب إبراهيم، تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، تحب الصديقين، كأبي بكر، والشهداء، وغير ذلك ممن يحبهم الله، فهذا يجلب لك محبة الله، وهو أيضاً من أثار محبة الله، فهو سبب وأثر.
ومنها: كثرة ذكر الله، بحيث يكون دائماً على بالك، حتى تكون كلما شاهدت شيئاً، استدللت به عليه عز وجل، حتى يكون قلبك دائماً مشغولاً بالله، معرضاً عما سواه، فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل.
وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله عز وجل.
السؤال الثاني: ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟
والجواب:
أولاً: قوله: ] وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [ [البقرة: 195]: يقتضي أن نحسن، وأن نحرص على الإحسان، لأن الله يحبه، وكل شيء يحبه الله، فإننا نحرص عليه.
ثانياً: قوله: ] وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [ [الحجرات: 9]: يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل.
ثالثاً: قوله: ] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [ [التوبة: 7]: يقتضي أن نتقي الله عز وجل، لا نتقي المخلوقين بحيث إذا كان عندنا من نستحي منه من الناس، تركنا المعاصي، وإذا لم يكن، عصينا، فالتقوى أن نتقي الله عز وجل، ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك وبين الله، ، يصلح الله ما بينك وبين الناس. أنظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك، ولا يهمك غير ذلك، ]إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا [ [الحج: 38]. افعل ما يقتضيه الشرع، وستكون لك العاقبة.
رابعاً: يقول الله تعالى: ] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ [ [البقرة: 222]، وهذه تستوجب أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل، أكثر أن أرجع إلى الله بقلبي وقالبي، ومجرد قول الإنسان: أتوب إلى الله. هذا قد لا ينفع، لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب إلى الله: أن بين يديك معاصي، ترجع إلى الله منها وتتوب، حتى تنال بذلك محبة الله.
] وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [ [البقرة: 222]: إذا غسلت ثوبك من النجاسة، تحس بأن الله أحبك، لأن الله يحب المتطهرين. إذا توضأت، تحس بأن الله أحبك، لأنك تطهرت. إذا اغتسلت، تحس أن الله أحبك، لأن الله يحب المتطهرين….
ووالله، إننا لغافلون عن هذه المعاني، أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث، لأنها شرط لصحة الصلاة، خوفاً من أن تفسد صلاتنا، لكن يغيب عنا كثيراً أن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لنا، لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله له، لحصلنا خيراً كثيراً، لكننا في غفلة.
خامساً: قوله: ]قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [ [آل عمران: 31]: هذا أيضاً يستوجب أن نحرص غاية الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نترسم طريقه، لا نخرج منه، ولا نقصر عنه، ولا نزيد، ولا ننقص.
وشعورنا هذا يحمينا من البدع، ويحمينا من التقصير، ويحمينا من الزيادة والغلو، ولو أننا نشعر بهذه الأمور، فانظر كيف يكون سلوكنا آدابنا وأخلاقنا وعباداتنا.
سادساً: قوله: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [ [المائدة: 54]، نحذر به من الردة عن الإسلام، التي منها ترك الصلاة مثلاً، فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا، أهلكنا الله، وأتى بقوم يحبهم ويحبونه، ويقومون بواجبهم نحو ربهم، فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة.
سابعاً: قوله: ]إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ [ 0[الصف: 4].
إذا آمنا بهذه المحبة، فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها: القتال، وعدم التواني، والإخلاص، بأن يكون في سبيل الله، أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان، أن نحكم الرابطة بيننا إحكاماً قوياً كالبنيان المرصوص، أن نصف، وهذا يقتضي التساوي حساً، حتى لا تختلف القلوب، وهو مما يؤكد الألفة، والإنسان إذا رأى واحداً عن يمينه وواحداً عن يساره، يقوى على الإقدام، لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب، فستشتد همته.
فصار في هذه الآيات ثلاثة مباحث:
1- إثبات المحبة بالأدلة السمعية.
2- أسبابها.
3- الآثار المسلكية في الإيمان بها.
أما أهل البدع الذين أنكروها، فليس عندهم إلا حجة واهية، يقولون:
أولاً: إن العقل لا يدل عليها.
ثانياً: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، لا تكون بين رب ومخلوق أبداً، ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن نرد عليهم فنقول:
نجيبكم عن الأول ـ وهو أن العقل لا يدل عليها ـ بجوابين: أحدهما: بالتسليم، والثاني: بالمنع.
التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها، وهو دليل قائم بنفسه، والله عز وجل يقول في القرآن: ]وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء [ [النحل: 89]، فإذا كان تبياناً، فهو دليل قائم بنفسه، “وانتفاء الدليل المعين، لا يلزم منه انتفاء المدلول”، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة، سواء الحسيات أو المعنويات:
فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه، فإذا انسد طريق، ذهبنا مع الطريق الثاني.
أما المعنويات، فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة وجوب الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة.
فإذاً، إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان.
الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها، ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، كما سبق.