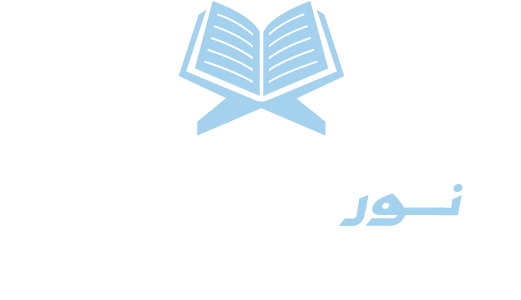3- أنه يصح أن نقول ـ على زعمكم ـ: أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير، لأنه ( استولى ) على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة ( استولى ) على شيء، ، صح أن نطلق ( استوى ) على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان على زعمكم.
3- أنه يصح أن نقول ـ على زعمكم ـ: أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير، لأنه ( استولى ) على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة ( استولى ) على شيء، ، صح أن نطلق ( استوى ) على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان على زعمكم.
فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل.
* ولما كان أبو المعالي الجويني ـ عفا الله عنه ـ يقرر مذهب الأشاعرة، وينكر استواء الله على العرش، بل وينكر علو الله بذاته، قال:
“كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه”. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني: كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذاً: لم يستو على العرش. فقال له أبو العلاء الهمذاني:
يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش ـ يعني: لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه ـ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا: ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت أبو المعالي، وجعل يضرب على رأسه: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني!وذلك لأن هذا دليل فطري لا أحد ينكره.
وقال في سورة يونس عليه السلام: )إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ( 1 )، وقال في سورة الرعد: )اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) ( 2 )…………………………………..
( 1 ) الموضع الثاني: في سورة يونس، قال الله تعالى: ]إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش[ [يونس: 3].
نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى.
( 2 ) الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله تعالى: )اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ )[الرعد: 2] .
- ( رفع السموات بغير عمد ): ( بغير عمد ): هل يعني: ليس لها عمد مطلقاً؟ أو لها عمد لكنها غير مرئية لنا؟
فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال: إن جملة ( ترونها ) صفة لـ( عمد )، أي: بغير عمد مرئية لكم، ولها عمد غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة ]ترونها[ جملة مستأنفة، معناها: ترونها كذلك بغير عمد. وهذا الأخير أقرب، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد، لكانت مرئية في الغالب، وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسيمة لحكمة يريدها.
* وقوله: ]ثم استوى على العرش[: هذا الشاهد، ويقال في معناها ما سبق.
( 1 ) الموضع الرابع: في سورة طه قال: )الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )[طه: 5].
* قدم ( على العرش ) وهو معمول لـ( استوى ) لإفادة الحصر والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستو على شيء سوى العرش.
* وفي ذكر ( الرحمن ) إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمة.
( 2 ) الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: ( ثم استوى على العرش الرحمن )[الفرقان: 59].
* ( الرحمن ): فاعل ( استوى ).
وقال في سورة آلم السجدة: )اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ) ( 1 )، وقال في سورة الحديد )هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) ( 2 ) ……………………………….
( 1 ) الموضع السادس: في سورة آلم السجدة قال:: )اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ) {السجدة: 4} .
نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس ، لكن هنا فيه زيادة:
]وما بينهما[؛ يعني: بين السماء والأرض ، والذي بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض، وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب ومنها ما هو مجهول إلى الآن.
( 2 )الموضع السابع: في سورة الحديد قال:]هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش[ {الحديد:4}.
فهذه سبعة مواضع؛ كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدى بـ ( على ) .
وبعد؛ فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة ( س و ي ) تدل على الكمال ]الذي خلق فسوى [ {الأعلى:2}؛ أي: أكمل ما خلقه؛ فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال.
ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية: معداة بـ( إلى ) ، ومعداة بـ ( على ) ، ومقرونة بالواو ، ومجردة:
-فالمعداة بـ ( على ) مثل: ( استوى على العرش ){الحديد: 4} ، ومعناها:
علا واستقر
والمعداة بـ ( إلى ): مثل قوله تعالى: ) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ){البقرة: 29} .
فهل معناها كالأولى المعداة بـ( على ) ؟
فيها خلاف بين المفسرين:
منهم من قال: إن معناها واحد ، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله؛ فمعنى ( استوى إلى السماء )؛ أي: ارتفع إليها.
ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل؛ فمعنى: استوى إليها؛ أي: قصد إليها قصداً كاملاً ، وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى ، وهو ( إلى ) ، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر قوله: ( ثم استوى إلى السماء )؛ أي: قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي بـ( إلى ) .أ.هـ كلامه.
والمقرونة بالواو؛ كقولهم: استوى الماء والخشبة؛ بمعنى: تساوى الماء والخشبة.
والمجردة؛ كقوله تعالى: )وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ){القصص:14} ، ومعناها: كمل.
تنبيه:
إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال ، وهو: إن الله خلق السماوات ، ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عالياً؟
فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وابداً ، لم يزل عالياً على كل شيء قبل أن يخلق العرش ، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ، ثم بعد خلق السماوات والأرض علا علواً خاصاً على العرش.
فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستوياً على العرش ، لكن قبل خلق السماوات والأرض ، هل هو مستو على العرش أولاً؟
فالجواب: الله أعلم بذلك.
فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟
فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته ، وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية.
إثبات علو الله على مخلوقاته
وقوله: ) يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ )
ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست آيات.
الآية الأولى: قوله: ) يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ) {آل عمران: 55}
* الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب ، ولهذا ينسب إلى أمه ، فيقال: عيسى بن مريم.
يقول الله: ( إني متوفيك ): ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: ( متوفيك )؛ بمعنى قابضك ، ومنه قولهم: توفى حقه؛
أي: قبضه.
القول الثاني: ( متوفيك ): منيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما قال تعالى: )وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمّىً ) ( الأنعام:60 )
القول الثالث: أنه وفاة موت: ( متوفيك ): مميتك ، ومنه قوله تعالى: )اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ){الزمر: 42}
والقول بأن ]متوفيك[ متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن عيسى عليه السلام لم يمت، وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله تعالى: )وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ){النساء: 159}؛ أي: قبل موت عيسى على أحد القولين، وذلك إذا نزل في آخر الزمان . وقيل: قبل موت الواحد؛ يعني: ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ آمن بعيسى ، حتى وإن كان يهودياً . وهذا القول ضعيف.
بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم ، فنقول: إنه يمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضاً له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم؛ ثم رفعه ، ولا منافاة بين الأمرين.
قوله: ( ورافعك إلى(: الشاهد هنا؛ فإن ( إلي ) تفيد الغاية ، وقوله: ( ورافعك إلي )
يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً، وهذا يدل على علو الله عز وجل.
فلو قال قائل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى: ) وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ){آل عمران: 45}.
قلنا هذا لا يستقيم؛ لأن الرفع هنا عدى بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية؛ رفع الجسد، وليس رفع المنزلة.
* واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو معنوي ، وعلو ذاتي:
1- أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ أي: بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً .
2- وأما العلو الذاتي؛ فيثبته أهل السنة ، ولا يثبته أهل البدعة؛ يقولون: إن الله تعالى ليس عالياً علواً ذاتياً.
فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي فنقول: إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعال علواً ذاتياً بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة:
أولاً: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية ، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. . .
فالعلو مثل قوله: ( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ){البقرة: 255} ، )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ){الأعلى: 1}.
والفوقية: )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) ( الأنعام: 18}، )يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) {النحل:50} .
( 3 ) ونزول الأشياء منه مثل قوله: )يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض ) ( السجدة: 5 )، )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ) ( الحجر:9 ) ما أشبه ذلك .
( 4 ) وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله: ) إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) {فاطر: 10} ، ومثل قوله )تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ){المعارج: 4} .
( 5 ) كونه في السماء؛ مثل قوله: )أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ){الملك: 16}.
ثانياً: وأما السنة فقد تواترت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره:
فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام:
فجاء بذكر العلو والفوقية ، ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم “سبحان ربي الأعلى”[130]، وقوله لما ذكر السماوات؛ قال: “والله فوق العرش[131] .
وجاء بذكر أن الله في السماء؛ مثل قوله ، صلى الله عليه وسلم: “ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء“13[2
وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء ، وهو يخطب الناس في أكبر جمع ، وذلك في يوم عرفة ، عام حجة الوداع؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مئة ألف ، والذين مات عنهم نحو مئة وأربعة وعشرين ألفاً: يعني: عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع، فقال عليه الصلاة والسلام: “ألا هل بلغت؟” . قالوا: نعم . “ألا هل بلغت؟ “. قالوا: نعم. “ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ، وكان يقول: “اللهم اشهد“؛ يشير إلى السماء بأصبعه ، وينكتها إلى الناس [133]
ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء.
وهذا إثبات للعلو بالفعل.
وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها ، فقال لها النبي ، صلى الله عليه وسلم: “أين الله؟” . قالت: في السماء . فقال: “من أنا؟” . قالت: رسول الله . قال: “أعتقها؛ فإنها مؤمنة”[134]. فهذه جارية لم تتعلم ، والغالب على الجواري الجهل ، لا سيما أمة غير حرة ، لا تملك نفسها ،تعلم أن ربها في السماء، وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء ، ويقولون: إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ! أو أنه في كل مكان!!
فهذه من أدلة الكتاب والسنة .
ثالثاً: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء ، من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا؟
نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلولها.
ولهذا لما قال شيخ الإسلام: “إن السلف مجمعون على ذلك“؛ قال: “ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماء ، أو: إن الله في الأرض ، أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، أو: إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه”.
رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل ، وكونه في السفل مستحيل؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام فإذا كان السفل مستحيلاً؛ كان العلو واجباً.
وهناك تقرير عقلي آخر ، وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء ، وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله.
وقولنا: “مطلقة“: احترازاً من الكمال النسبي ، الذي يكون كمالاً في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقص، ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال.
خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء ، ولهذا عندما يفجؤك الشيء الذي لا تستطيع دفعه، وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض.
وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في السماء كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس ، فلما خرج؛ رأى نملة مستلقية على ظهرها ، رافعة قوائمها نحو السماء، تقول: “اللهم ! إنا خلق من خلقك ، ليس بنا غنى عن سقياك” . فقال: “ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم“. وهذا إلهام فطري.
فالحاصل أن: كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة. ووالله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب.
* والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان في العلو بذاته؛ كان في جهة، وإذا كان في جهة؛ كان محدوداً وجسماً ، وهذا ممتنع ! والجواب عن قولهم: “إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسماً،؛ نقول:
أولاً: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات ، ولو جاز هذا؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة.
فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو ، ورسوله ، صلى الله عليه وسلم أثبت له العلو، والسلف الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: لا يمكن أن يكون علو ذات؛ لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا وكذا.
ثانياً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً صحيحاً؛ فلنقل به؛ لأن لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسداً، لبينه، ولكنها لا تستلزم معنى فاسداً.
ثالثاً: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها.
أتريدون بالحد أن شيئاً من المخلوقات يحيط بالله؟ فهذا باطل ومنتف عن الله، وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى، ولكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً، لعدم ورود ذلك.
وأما الجسم، فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى، لكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً، لما سبق.
وكذلك نقول في الجهة، هل تريدون أن الله تعالي له جهة تحيط به؟ فهذا باطل، وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالي.
( بل رفعه الله إليه ) ( 1 ) ………………………………………
( 1 ) الآية الثانية: قوله: ) بل رفعه الله إليه ( [ النساء: 158]…………….
( بل ): للإضراب الإبطالي، لإبطال قولهم: )وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ) ( )بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً [ النساء: 157-158]، فكذبهم الله بقوله: ( وما قتلوه يقيناً ، بل رفعه الله إليه ).
والشاهد قوله: ) بل رفعه الله إليه ( ، فإنه صريح بأن الله تعالى عال بذاته، إذ الرفع إلي الشيء يستلزم علوه.
) إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ( ( 1 )……………………………
( 1 )الآية الثالثة: قوله: ) إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ( [ فاطر: 10] .
) إليه (: إلى الله عز وجل.
) يصعد الكلم الطيب (: و ) الكلم ( هنا اسم جمع، مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلي الله، كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل كلمة تقرب إلي الله عز وجل، فهي كلمة طيبة، تصعد إلي الله عز وجل، وتصل إليه، والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضاً.
فالكلمات تصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله، وهذا يدل على أن الله عال بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه وترفع.
) يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) )وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ) )أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً ) ( 2 )……………………..
( 2 ) الآية الرابعة: قوله: ) يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب ) ( أسباب السموات فأطلع إلي إله موسي وإني لأظنه كاذباً ( [ غافر:36-37].
هامان وزير فرعون، والآمر بالبناء فرعون.
) صرحاً ( ، أي بناء عالياً.
)لعلي أبلغ الأسباب ، أسباب السموات( ، يعني: لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء.
)فأطلع إلي إله موسى( ، يعني: أنظر إليه، وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له: أن الله في السماء. فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول: لم أجد أحداً، ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، يقول: إن موسى قال: إلهه في السماء، اجعلونا نرقى لنراه !! تهكماً.
وأيا كان، فقد قال: )وإني لأظنه كاذباً( ، للتمويه على قومه، وإلا، فهو يعلم أنه صادق، وقد قال له موسى: )لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ( [ الإسراء: 102]، فلم يقل: ما علمت! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و( قد ) والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى: )وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) ( النمل:14 )
الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله: إن الله في السماء. فيكون علو الله تعالى ذاتياً قد جاءت به الشرائع السابقة.
)أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير( ( 1 )………
( 1 ) الآية الخامسة والسادسة: قوله: )أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ) )أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )[الملك: 16-17].
والذي في السماء هو الله عز وجل، لكنه كنى عن نفسه بهذا، لأن المقام مقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم، قادر عليكم، مسيطر عليكم، مهيمن عليكم، لأن العالي له سلطة على من تحته.
( فَإِذَا هِيَ تَمُورُ )، أي: تضطرب.
والجواب: لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض.
والانهيارات التي يسمونها الآن: أنهياراً أرضياً، وانهياراً جبلياً .. وما أشبه ذلك هي نفس التي هدد الله بها هنا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات ليهونوا الأمر على البسطاء من الناس.
- ( أم أمنتم )، يعنى بل أأمنتم، و ( أم ) هنا بمعني ( بل ) والهمزة.
- ( أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ): الحاصب عذاب من فوق يحصبون به، كما فعل بالذين من قبلهم، كقوم لوط وأصحاب الفيل، والخسف من تحت.
فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت، قال الله تعالي: )فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا )[ العنكبوت:40]، أربعة أنواع من العذاب.
وهنا ذكر الله نوعين منها: الحاصب والخسف.
والشاهد من هذه الآية هو قوله: ( من في السماء ).
والذي في السماء هو الله عز وجل ، وهو دليل على علو الله بذاته .
لكن هاهنا إشكال، وهو أن ( في ) للظرفية، فإذا كان الله في السماء، و( في ) للظرفيه، فإن الظرف محيط بالمظروف ! أرأيت لو قلت: الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء ! فإذا كان الله يقول: )أأمنتم من في السماء( ، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، وهذا الظاهر باطل، وإذا كان الظاهر باطلاً، فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلاً.
فما الجواب على هذا الإشكال؟
قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين:
فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، والسماء معنى العلو وارد في اللغة، بل في القرآن ، قال تعالي: )أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا )[ الرعد: 17]، والمراد بالسماء العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ، والسحاب في العلو بين السماء والأرض، كما قال الله تعالي: )والسحاب المسخر بين السماء والأرض( [ البقرة: 164].
فيكون معنى ( من في السماء )، أي: من في العلو.
ولا يوجد إشكال بعد هذا، فهو في العلو. ليس يحاذيه شىء، ولا يكون فوقه شيء.
2- أو نجعل ( في ) بمعنى ( على ) ، ونجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع، يعني: الأجرام السماوية، وتأتي ( في ) بمعنى ( على ) في اللغة العربية، بل في القرآن الكريم، قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا:( وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ )[ طه: 71] ، أي: على جذوع النخل.
فيكون معني ( من في السماء ) ، أي: من على السماء.
ولا إشكال بعد هذا.
فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: )وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ )[ الزخرف: 84]، وقوله: )وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ يعلم سركم وجهركم )[ الأنعام: 3 ] ؟ !
فالجواب: أن نقول:
أما الآية الأولى، فإن الله يقول: )وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ) ، فالظرف هنا لألوهيته، يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة، فهو نفسه في واحدة منهما، وفيهما جميعاً بإمارته وسلطته، فالله تعالي ألوهيته في السماء وفي الأرض، وأما هو عز وجل ففي السماء.
أما الآية الثاني: ( وهو الله في السموات وفي الأرض ) فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: ( وهو الله )، أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه، ففي السماء. فيكون المعنى: هو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض.
فتخرج هذه الآية كتخريج التي قبلها.
وقيل المعنى: ( وهو الله في السموات )، ثم تقف، ثم تقرأ: ( فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) أي أنه نفسه في السماوات، ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض.
وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض، والصواب الأول: أن نقول: ( وهو الله في السماوات وفي الأرض ) ، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، فتطابق الآية الأخرى.
من الفوائد المسلكية في هذه الآيات:
أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء، فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه، وحينئذ يخافه و يعظمه، وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه، فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم.
إثبات معية الله لخلقه
قوله:( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ( 1 )…………
( 1 ) شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى لخلقه، وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدون للإنسان أن هناك تناقضاً بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جداً أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو.
وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث:
* المبحث الأول في أقسامها:
معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة، وخاصة.
والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ، ومقيدة بوصف.
أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر . ودليلها قوله تعالى: ( وهو معكم أين ما كنتم ) {الحديد: 4} .
أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى: ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) {النحل: 128}.
وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله تعالى عن نبيه: ) لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) {التوبة 40 )، وقال لموسى وهارون: ) إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ) {طه: 46}.
وهذه أخص من المقيدة بوصف.
فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاماً. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته، والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد.
* المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟
أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك ، فيجعلون معنى قوله: ( وهو معكم ) أي: وهو عالم بكم سميع لأقوالكم ، بصير بأعمالكم ، قادر عليكم حاكم بينكم . . . . وهكذا ، فيفسرونها بلازمها.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على حقيقتها ، وأن كونه معنا حق على حقيقته ، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها.
وعلى هذا، فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو.
والمؤلف عقد لها فصلاً خاصاً سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه.
وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر، قال: إنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق، الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء، وهو فوق سماواته؟!
وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل السنة، فقالوا: أنتم تمنعون التأويل، وأنتم تؤولون في المعية، تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك.
فنقول: إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست في المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم، بأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم.
*المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟
فيه تفصيل:
أما المعية العامة، فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطاً بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته.
وأما المعية الخاصة، فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية، فقد سبق لنا أن الرضى من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله، وجد الرضى، وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص، كان الله معه.
*المبحث الرابع في المعية: هل هي حقيقية أو لا؟
ذكرنا ذلك، وأن من السلف من فسرها باللازم، وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه. ومنهم من قال: هي على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله، خاصة به.
وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك، فإن هذا باطل مستحيل!
*المبحث الخامس في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟
الجواب: لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه.
الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض، أصلاً، إذ من الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء، فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق، فاجتماعهما في الخالق من باب أولى.
أرأيت لو أن إنساناً على جبل عالٍ، وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة، وأنا معكم، وهو واضع المنظار على عينيه، ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم، لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه، وهو بعيد عنهم، فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق؟!
الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق، لم يكن متعذراً في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين، لظهور التباين بين الخالق والمخلوق.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: “اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل“[135]، فجمع بين كونه صاحباً له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحباً لك في السفر وخليفة لك في أهلك.
وثبت في الحديث الصحيح[136] أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي: )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ): “حمدني عبدي”. كم من مصلٍ يقول:: )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ؟ لا يحصون، وكم من مصليين، أحدهما يقول: )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ، والثاني يقول: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، وكل واحد منهما له رد، الذي يقول: ]الحمد لله رب العالمين[: يقول الله له: “حمدني عبدي”. والذي يقول: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(: يقول الله له: “هذا بيني وبين عبدي نصفين”…..
إذاً، يمكن أن يكون الله معنا حقاً وهو على عرشه في السماء حقاً، ولا يفهم أحداً أنهما يتعارضان، إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه، ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق.
ونحن بَينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك، وإلا، فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله، وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول: كيف يمكن؟! منكراً ذلك!
إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة، وهم خير منك، ومسئولهم أعلم من مسئولك وأصدق وأفصح وأنصح، عليك أن تصدق، لا تقل: كيف؟ ولا لم؟ ولكن سلم تسليماً.
تنبيه:
تأمل في الآية، تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى: ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى ) ، ( يعلم ما يلج في الأرض )، فكذلك ضمير ]وهو معكم[، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية، إذا آمنا بها، توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه، ولهذا جاء في الحديث: “أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت“[137]
أما أهل الحلول، فقالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد، فالله معك في المسجد والذين في السوق الله معهم فى السوق!! والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات!!
ما نزهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث!!
المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليهم:
شبهتهم: يقولون: هذا ظاهر اللفظ: ( وهو معكم )؛ لأن كل الضمائر تعود على الله: ( هو الذي خلق ) ، ( ثم استوى ) ، ( يعلم ) ، ( وهو معكم ) ، وإذا كان معنا؛ فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان!!
والرد عليهم من وجوه:
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على العرش، وهو مع كل إنسان في أي مكان ! والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل .
ثانياً: قولكم: “إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان! هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية أسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولاً مما زعمتم؛ فقد تقتضي الاختلاط ، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان؛ هذه ثلاثة أشياء:
1-مثال المعية التي تقتضي المخالطة: أن يقال: اسقوني لبناً مع ماء؛ أي: مخلوطاً بماء.
2-ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان: قولك: وجدت فلاناً مع فلان يمشيان جميعاً وينزلان جميعاً.
3-ومثال المعية التي لا تقتضي الإختلاط ولا المشاركة في المكان: أن يقال: فلان مع جنوده . وإن كان في غرفة القيادة ، لكن يوجههم . فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان.
ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل: )إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ) {النحل: 128}؛ فلا يقتضي ذلك لا اختلاطاً ولا مشاركة في المكان ، بل هي معية لائقة بالله ، ومقتضاها النصر والتأييد.
ثالثاً: نقول: وصفكم الله بهذا ! من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل ، والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحاً؛ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق ، وإن كانوا أسفل منه ، فإذا جعلتم الله في الأرض؛ فهذا نقص.
إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان ، وأنتم تدخلون الكنيف؛ هذا أعظم النقص ، ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف ! لكن كيف تقوله لله عز وجل ؟!
رابعاً: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما ، وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئاً ، كل جزء منه في مكان.
وإما أن يكون متعدداً؛ يعني: كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة.
خامساً: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله حالاً في الخلق؛ فكل مكان في الخلق؛ فالله تعالى فيه، وصار هذا سلماً لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن هذا القول باطل ، ومقتضى هذا القول الكفر.
ولهذا نرى أن من قال: إن الله معنا في الأرض؛ فهو كافر؛ يستتاب ، ويبين له الحق، فإن رجع، وإلا؛ وجب قتله.
وهذه آيات المعية:
الآية الأولى: قوله تعالى: )هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) {الحديد: 4}: والشاهد فيها قوله: ( وهو معكم أين ما كنتم ) ، وهذه من المعية العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وسمعاً وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية.
الآية الثانية: قوله: ) مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) {المجادلة: 7}.
( ما يكون ): ( يكون )؛ تامة يعني: ما يوجد.
وقوله: ( من نجوى ثلاثة ): قيل: إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، وأصلها: من ثلاثة نجوى ، ومعنى ( نجوى )؛ أي: متناجين.
وقوله: ( إلا هو رابعهم ) ولم يقل: إلا هو ثالثهم؛ لأنه من غير الجنس ، وإذا كان من غير الجنس ، فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس؛ فإنه يؤتى بنفس العدد، أنظر قوله تعالى عن النصارى: )لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ){المائدة: 73}، ولم يقولوا: ثالث أثنين؛ لأنه من الجنس على زعمهم فعندهم كل الثلاثة آلهة ، فلما كان من الجنس على زعمهم؛ قالوا فيه: ثالث ثلاثة.
قوله: ( ولا خمسة هو سادسهم ) ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قوله: ( ولا أدنى من ذلك ): الأدنى من ثلاثة أثنان ، ( ولا أكثر ) من خمسة ، ستة فما فوق.
ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض؛ إلا والله عز وجل معهم.
وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن ، والكافر، والبر، والفاجر ، ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً وغير ذلك.
وقوله: )ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة(؛ يعني: أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة؛ نبأهم بما عملوا؛ يعني: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن المراد بالإنباء لازمه ، وهو المحاسبة ، لكن إن كانوا مؤمنين؛ فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ، ثم يقول: “سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم”[138].
وقوله عز وجل: ]إن الله بكل شيء عليم[: كل شيء موجود أو معدوم ، جائز أو واجب أو ممتنع ، كل شيء؛ فالله عليم به. وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم ، وأن علم الله يتعلق بكل شيء، حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير ، والظاهر والخفي.
وقوله: ) لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) ( 1 ) ……………………………………..
( 1 )الآية الثالثة: ]لا تحزن إن الله معنا[ {التوبة: 40}.
الخطاب لأبي بكر من النبي ، صلى الله عليه وسلم:؛ قال الله تعالى: )إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّه ) ( التوبة: من الآية40 ) إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه( لا تحزن إن الله معنا ) {التوبة:40}.
أولاً: نصره حين الإخراج ]إذ أخرجه الذين كفروا[ .
ثانياً: وعند المكث في الغار ]إذ هما في الغار[.
ثالثاً: عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار: ]إذ يقول لصاحبه لا تحزن[.
فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه ، صلى الله عليه وسلم .
وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول أبو بكر: “يا رسول الله ! لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا”[139]؛ يعني: إننا على خطر؛ كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: ( إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ) {الشعراء: 61}، فقال ) كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ) ( الشعراء:62 ) وهنا قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأبي بكر رضي الله عنه: ]لا تحزن إن الله معنا[ . فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه ، وعلل ذلك بقوله: ]إن الله معنا[ .
وقوله: ]لا تحزن[: نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع؛ فهو صالح للماضي والمستقبل.
والحزن: تألم النفس وشدة همها.
]إن الله معنا[: وهذه المعية خاصة، مقيدة بالنبي ، صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش على الغار ، لوم يبصروهما ! أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار ، والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون ، وإذا على الغار ، حمامة وعش عنكبوت ، فقالوا: ليس فيه أحد؛ فانصرفوا . فهذا باطل!! الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحاً صافياً؛ ليس فيه مانع حسي ، ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية!!
أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعيد ، وخلاف قوله: “لو نظر أحدهم إلى قدمه، لأبصرنا”.
المهم أن بعض المؤرخين –عفا الله عنهم –يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل.
) إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ) ( 1 ) ………………………..
( 1 )الآية الرابعة: قوله: ) إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ){طه: 46}.
هذا الخطاب موجه لموسى وهارون ، لما أمرهما الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون؛ قال: ( )اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ) ( )فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) )قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى( {طه:43-46}.
فقوله: ( أسمع وأرى(: جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة، وهو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه: ( إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) .
)إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) ( 1 ) ، وقوله ) وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) ( 2 )…………………………………
( 1 )لآية الخامسة: قوله: )إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ{النحل: 128}.
هذه جاءت بعد قوله: )وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِين ) )وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ) {النحل: 126-127}.
عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى ، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو إحسان ، ولهذا قال: )إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) ( النحل:128 )
والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة: كل من كان من المتقين المحسنين؛ فالله معه.
وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية: الحرص على الإحسان والتقوى؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه.
( 2 ) الآية السادسة: قوله: ) وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ){الأنفال:46}.
سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله ، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله؛ سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح.
وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله لأن فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمور، وإن شاء لم يفعل ، وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه ، ثم على أقدار الله؛ لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم.
والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه ، أما من فرشت له الأرض وروداً ، وصار الناس ينظرون إلى ما يريد؛ فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي.
ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر.
فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماه ، فيقول: “افلا أكون عبداً شكورا” [140]
والصبر: صبر على ما أوذي ، فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من اليهود والمنافقين، ومع ذلك؛ فهو صابر.
) كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ) ( 1 )…………………………….
( 1 )الآية السابعة: قوله ) كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ){البقرة:249} .
]كم[: خبرية ، تفيد التكثير؛ يعني: فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة، لكن لا بحولهم ولا بقوتهم، بل بإذن الله ، أي: بإرادته وقدرته.
ومن ذلك: أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين.
ومن ذلك: أصحاب بدر غلبوا قريشاً وهم كثيرون .
أصحاب بدر خرجوا لغير قتال، بل لأخذ عير أبي سفيان ، وأبو سفيان لما علم بهم؛ أرسل صارخاً إلى أهل مكة يقول: أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش، فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها، يظهرون القوة والفخر والعزة ، حتى قال أبو جهل: والله؛ لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم فيها ثلاثاً؛ ننحر الجذور، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبداً.
فالحمد لله ، غنوا عل قتله هو ومن معه!
كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف، كل يوم ينحرون من الإبل تسعاً إلى عشر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً ، معهم سبعون بعيراً وفرسان فقط يتعاقبونها ، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة.
فـ ) كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(؛ لأن الفئة القليلة صبرت، ( والله مع الصابرين )؛ صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة الله ، وعن معصية الله، وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد، ( والله مع الصابرين ) .
انتهت آيات المعية، وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها.
فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟
أولاً: الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء ، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبداً.
ثانياً: أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ، ولا يجدنا حيث نهانا ، وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية.
إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى
قوله: ) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً ) ( 1 )، ) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ) ( 2 )………………………
( 1 )ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى.
الآية الأولى والثانية: قوله: ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً ) {النساء: 87} ( ومن أصدق من الله قيلاً ) {النساء: 122}.
( ومن ): اسم استفهام بمعنى النفي ، وإتيان النفي بصيغة الإستفهام أبلغ من إتيان النفي مجرداً؛ لأنه يكون بالاستفهام مشرباً معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثاً ، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن اصدق من الله؟
وقوله: ( حديثاً ) و ( قيلاً ): تمييز لـ( أصدق ).
وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله: ( أصدق )؛ لأن الصدق يوصف به الكلام ، وقوله: ( حديثاً( لأن الحديث هو الكلام، ومن قوله في الآية الثانية: )قيلاً(؛ يعني: قولاً ، والقول لا يكون إلا باللفظ.
ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ، ليس فيه كذب بوجه من الوجوه.
)وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ) ( 1 )……………………………….
( 1 )الآية الثالثة: قوله: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ){المائدة: 116}.
قوله: ( يا عيسى ): مقول القول، وهي جملة من حروف: ( يا عيسى ابن مريم ).
ففي هذا إثبات أن الله يقول: وأن قوله مسموع، فيكون بصوت ، وأن قوله كلمات وجمل ، فيكون بحرف.
ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء ، كيف شاء، بما شاء ، بحرف وصوت، لا يماثل أصوات المخلوقين.
“متى شاء”: باعتبار الزمن.
“بما شاء”:باعتبار الكلام؛ يعني: موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك.
“كيف شاء”: يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. قلنا: إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين.
الدليل على هذا من الآية الكريمة ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ): هذا حروف.
وبصوت؛ لأن عيسى يسمع ما قال.
لا يماثل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) {الشورى: 11}.
)وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ) ( 1 ) وقوله ) وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ) ( 2 )…………………………….
( 1 )الآية الرابعة: قوله: ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ) {الأنعام: 115} .
( كلمة )؛ بالإفراد، وفي قراءة ( كلمات )؛ بالجمع ، ومعناها واحد؛ لأن ]كلمة[ مفرد مضاف فيعم.
تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق والعدل، والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم، ولهذا قال المفسرون: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام.
فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه الوجوه ، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه.
هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل . إذا؛ فهي أقوال؛ لأن القول هو الذي يقال فيه: كاذب أو صادق.
( 2 )الآية الخامسة: قوله: ( وكلم الله موسى تكليماً ) {النساء:164}.
( الله ): فاعل؛ فالكلام واقع منه.
( تكليماً ): مصدر مؤكد ، والمصدر المؤكد –بكسر الكاف-؛ قال العلماء: إنه ينفي احتمال المجاز. فدل على أنه كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز.
أرأيت لو قلت: جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد، وإن كان خلاف الظاهر ، لكن إذا أكدت فقلت: جاء زيد نفسه. أو: جاء زيدٌ انتفى احتمال المجاز.