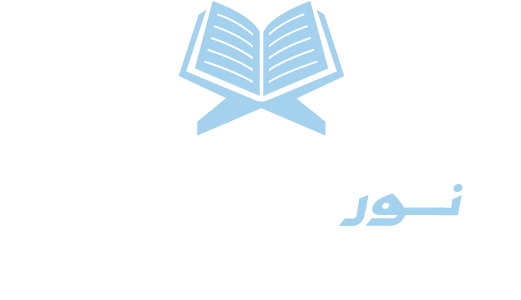* قوله: “ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانهلا سمي له وكفو له ولا ند له, بخلقه سبحانه وتعالى”.
الشرح:
قوله: “ولا يكيفون”؛ أي: أهل السنة والجماعة، وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة، سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك، فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداً، يعنى: لا يقولون: كيفية يده كذا وكذا، ولا: كيفية وجهه كذا وكذا، فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضاً، يعني: نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل، أو كيف ينزل، أو كيف وجهه، أو كيف يده، ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضاً، لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل، وإما التعطيل.
ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش، أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالكاً رحمه الله قال: “السؤال عن بدعة”، لا تقل: كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك، قلنا: إنك مبتدع .. وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل.
قوله: “ولا يمثلون”، أي: أهل السنة والجماعة: “صفاته بصفات خلقه”، وهذا معنى قوله فيما سبق: “من غير تمثيل” وسبق لنا امتناع التمثيل سمعاً وعقلاً، وأن السمع ورد خبراً وطلباًفي نفي التمثيل، فهم لا يكيفون ولا يمثلون.
قوله: “لأنه سبحانه”: (سبحان): اسم مصدر سبح والمصدر تسبيح، فـ (سبحان) بمعنى تسبيح، لكنها بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه، فهو اسم مصدر، كـ: سبحان من سبح، وكلام من كلم وسلام من سلم، وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائماً.
ومعنى (سبح)، قال العلماء: معناها: نزه، أصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص.
قوله: “لا سمي له”: دليل ذلك قوله تعالى: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً} [مريم: 65]: {هَلْ} استفهام، لكنه بمعنى النفي ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة، وهي التحدي، لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا سمي له، و: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً}، لأن {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً} متضمن للنفي وللتحدي أيضاً، مُشرَب معنى التحدي، وهذه قاعدة مهمة: كلما كان الاستفهام بمعنى النفي، فهو مشرب معنى التحدي، كأني أقول: إن كنت صادقاً، فأتني بسمي له وعلى هذا، فـ {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً}: أبلغ من: “لا سميّ له”.
والسمي: هو المسامي، أي: المماثل.
قوله: “ولاكفء له”: والدليل قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُكُفُواً أَحَدٌ} [الإخلاص: 4].
قوله: “ولا ند له”: والدليل قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22]، أي: تعلمون أنه لا ند له والند بمعنى النظير.
وهذه الثلاثة ـ السمي والكفء والند ـ معناها متقارب جداً، لأن معنى الكفء: الذي يكافئه، ولا يكفائ الشيءُ الشيءَ إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله، لم يكن مكافئاً، إذاً: لا كفء له، أي: ليس له مثيل سبحانه وتعالى.
وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله.
قوله: “ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى”: القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية، فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول:
1 – قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ ومعناه، فمثلاً: إذا قلنا: الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي).
2 – وقياس التمثيل: هو أن يلحق الشيء مثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق.
3 – وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم منالأصل، ولهذا يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله، لقوله تعالى {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى} [النحل: 60]، بمعنى كل صفة كمال، فلله تعالى أعلاها، والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها.
ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلاً: نقول: العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق، فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائماً نجده في كلام العلماء.
فقول المؤلف رحمه الله: “ولا يقاس بخلقه”، بعد قوله: “لا سمي ولا كفء له، ولا ند له”، يعني القياس المقتضي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل.
إذاً، يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما، وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز، أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى.
لو قال لك قائل: الله موجود، والإنسان موجود، ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس.
فنقول: لا يصح، لأن وجود الخالق واجب، ووجود الإنسان ممكن.
فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق.نقول: لا يمكن، سمع الخالق واجب له، لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعاً يلحقه نقص السمع، وسمعه محدود.
إذاً، لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه، لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق.
قوله: “فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه”
الشرح:
قال المؤلف هذا تمهيداً وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة:
الوصف الأول: أن يكون صادراً عن علم، وإليه الإشارة بقوله: “فإنه أعلم بنفسه وبغيره”.
الوصف الثاني: الصدق، وأشار إليه بقوله: “وأصدق قيلاً”.
الوصف الثالث: البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله: “وأحسن حديثاً”.الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم.
فدليل الأول ـ وهو العلم ـ: قوله تعالى: {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55]، فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك، لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل، وأنت لا تعلم ماذا تكسب غداً؟
وكلمة {أَعْلَمُ} هنا اسم تفضيل، وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن (عالم) اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل.
فنقول له: هذا غلط، فالله يعبر عن نفسه ويقول: {أَعْلَمُ} وأنت تقولك عالم! وإذا فسرنا {أَعْلَمُ} بـ (عالم)، فقد حططنا من قدر علم الله، لأن (عالم) يشترك فيه غير الله على سبيل المساواة، لكن {أَعْلَمُ} مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك.
ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه.ونقول أيضاً: في باب المقارنة لا بأس أن نقول: أعلم، بمعنى: أن تأتي باسم التفضيل، ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى، كما قال الله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً} [الفرقان: 24]، فجاء باسم التفضيل، مع أن المفضل عليه ليس فيه خير، وقال يوسف: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} {يوسف: 39]، والأرباب ليس فيها خير.
فالحاصل أن نقول: إن {أَعْلَمُ} الواردة في كتاب الله يراد بها معناها الحقيقي، ومن فسرها بـ (عالم)، فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية.
ودليل الوصف الثاني ـ الصدق ـ: قوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً}، أي: لا أحد أصدق منه، والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به، فهو صدق، بل أصدق من كل قول.
ودليل الوصف الثالث ـ البيان والفصاحة ـ: قوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً} وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي.ودليل الوصف الرابع ـ سلامة القصد والإرادة ـ: قوله تعالى:
{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [النساء: 26].
فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر.
وإذا كان كذلك، فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، وأن لا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، بل ليبين لهم ويهديهم، وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره من أعلم القائلين، ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، ولا يمكن أن يكون كلاماً عيياً غير فصيح، وكلام الله لو اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام، وجب عل المخاطب القبول بما دل عليه.
مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله عز وجل يخلق بهما من شاء فنثبتهما، لأن كلام الله عزوجل صادر عن علم وصدق، وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه، ولا يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه، ولو فرض هذا، لكان مقتضاه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه، وهذا ممتنع، فإذا كان كذلك، وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم.وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة.
قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا، فنقول: هل الله عز وجل حينما قال: {بِيَدَيَّ}: عالم بأن له يدين؟ فسيقول: هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق بلا شك. ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم، أو: غير صادق، ولا أن يقول: عبر بهما وهو يريد غيرهما عياً وعجزاً، ولا أن يقول: أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالاً لهم! فنقول له: إذاً، ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟! فاستغفر ربك وتب إليه، وقل: آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من غيره وأتم إرادة من غيره أيضاً.
ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة ونحن زدنا الوصف الرابع، وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [النساء: 26].
هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في الكلام.
أما ما أخبرت به الرسل:* فقال المؤلف: “ثم رسله صادقون مصدقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لايعلمون”.
الشرح:
قوله: “ثم رسله صادقون المصدوقون (1) “: الصادق: المخبر بما طابق الواقع، فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به.
ولكن: لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام، فإذا قالت اليهود: قال موسى كذا وكذا، فلا نقبل، حتى نعلم صحة سنده إلى موسى. وإذا قالت النصارى: قال عيسى كذا وكذا، فلا نقبل، حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال محمد رسول الله كذا وكذا، فلا نقبل، حتى نعلم صحة السند إلى محمد صلوات الله عليهم.
فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته، فهم صادقون فيه، لا يكذبون أبداً.
ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب.
“مصدوقون” أو: “مصدقون”: نسختان:
أما على نسخة “مصدوقون”، فالمعنى أن ما أوحي إليهم، فهو صدق، والمصدوق: الذي أخبر بالصدق والصادق: الذيجاء بالصدق، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت آية الكرسي، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له: “صدقك وهو كذوب” رواه البخاري، يعني: أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون، كل ما أوحي إليهم، فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل إليهم، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [التكوير: 19 – 21].
وأما على نسخة: “مصدقون”، فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم، وعلى هذا يكون معنى “مصدقون”، أي: شرعاً، يعني: يجب أن يصدقوا شرعاً، فمن كذب بالرسل أو كذبهم، فهو كافر، ويجوز أن يكون “مصدقون” له وجه آخر، أي: أن الله تعالى صدقهم، ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله:
أما بقوله: فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ} [النساء: 166]، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} [المنافقون: 1]، فهذا تصديق بالقول.أما تصديقه بالفعل، فبالتمكين له، وإظهار الآيات، فهو يأتي للناس يدعوهم إلا الإسلام، فإن لم يقبلوا، فالجزية، فإن لم يقبلوا، استباح دمائهم ونساءهم وأموالهم، والله تعالى يمكن له، ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض، وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها، فهذا تصديق من الله بالفعل، كذلك أيضاً ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له سواء كانت الآيات شرعية أم كونية، فالشرعية كان دائماً يُسأل عن الشيء وهو لا يعلمه، فينزل الله الجواب: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85] ودليله في البخاري4721، إذاً هذا تصديق بأنه رسول ولو كان غير رسول، ما أجاب الله {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 217]. فالجواب: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ} .. إلخ، فهذا تصديق من الله عز وجل.
والآيات الكونية ظاهرة جداً وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله، سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة.ففهمنا من كلمة: “مصدقون”: أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق، أي: يجب أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعاً، لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق.
قوله: “بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون”: فهؤلاء كاذبون أو ضالون، لأنهم قالوا مالا يعلمون.
وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله مالا يعلمون من وجهين: قالوا: إنه لم يرد كذا وأراد كذا! فقالوا في السلب والإيجاب لما لا يعلمون.
مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الحقيقي! فهنا قالوا على الله مالا يعلمون بالسلب، ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! فقالوا على الله مالا يعلمون في الإيجاب.
وهؤلاء الذين يقولون على الله مالا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان.
قوله: “ولهذا قال سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات:180 – 183] “الشرح:
قوله: “ولهذا “؛ أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله.
“قال: {سُبْحَانَ رَبِّكَ} “: سبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به.
وقوله: ” {رَبِّكَ} أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهي ربوبية خاصة، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق.
وقوله: {رَبِّ الْعِزَّةِ} من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق وهنا قال: {رَبِّ الْعِزَّةِ}، وعزه الله غير مخلوقة، لأنها من صفاته، فنقول: هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وعلى هذا، فـ {رَبِّ الْعِزَّةِ} هنا معناها: صاحب العزة، كما يقال: رب الدار، أي: صاحب الدار.
قوله: {عَمَّا يَصِفُونَ} يعني: عما يصفه المشركون، كما سيذكره المؤلف.
قوله: {وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ} أي: على الرسل.
قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}: حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح، وإثبات الكمال بالحمد.
قوله: “فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلمعلى المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب”:
الشرح:
معنى هذه الجملة واضح، وبقي أن يقال: وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل، لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم.
* قوله: “وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات”
بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص، فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان:
1 – صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية.
2 – وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية، من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية، بل نقول: منفية.
فنقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي، فالاختلاف في اللفظ ولا يضر.