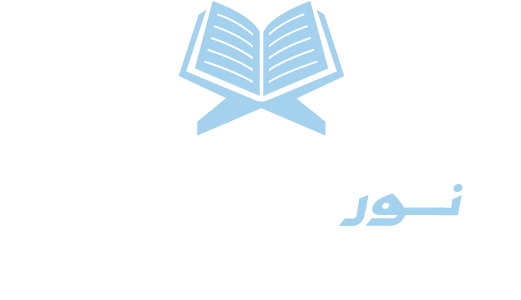تتمتع كلمة الاستشراق بمعنيين، المعنى العام للاستشراق ، والمعنى الخاص :
تتمتع كلمة الاستشراق بمعنيين، المعنى العام للاستشراق ، والمعنى الخاص :
فالمعنى العام يُراد به البحث في تراث الشرق عامة.
والمعنى الخاص يراد به البحث في تراث الإسلام بشكل خاص.
وفي العادة ،ومن خلال تعاريف الاستشراق ، يقصد به الدراسات الغربية الموجهة للشرق عامة أو للإسلامي بشكل خاص، وبلا شك، فإن الاستشراق ظاهرة ارتبطت بالعلاقات التاريخية الحضارية بين الشرق والغرب منذ كان الصدام بينهما إثر الفتوحات الإسلامية، فحينما انتشر الإسلام بشكل سريع أحس العالم المسيحي بالخطر، وحين فشلت الحروب الصليبية، ازداد الخوف من التيار الإسلامي، فبدأ التفكير في وقف ذلك التيار، والشروع في محاولات تشويه الإسلام والتشكيك فيه بتقديم صورة كريهة عنه، والبدء في عمليات التنصير، ومن هنا ارتبط الاستشراق في بداية تكوينه بالكنيسة ، وبالتحركات الصليبية بشكل عام، واعتبر المستشرقون الأوائل عملهم نوعا من الكفاح ضد العروبة والإسلام، وأصبح المراد بالاستشراق محاربة الإسلام، ولذلك يؤكد المستشرق الألماني رودي باريتRudi Paret 1901 – 1982م أن الهدف الرئيس من جهود المستشرقين في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية هو التنصير، وعرَّفه بأنه إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام، واجتذابهم إلى النصرانية.
ومع حلول العصور الحديثة ، انتقلت الحركة الاستشراقية إلى مرحلة أعلى وهي الارتباط بالأمور السياسية والاقتصادية الاستعمارية ، وهكذا امتدت ظاهرة الاستشراق وأخذت أبعادا وخلفيات كبيرة، في المعاهد والجامعات الغربية، وهي وإن تأثرت بالدراسات اللاهوتية في مراحلها الأولى، فإن ضغوط الكنيسة بدأت تتقلص وتحل محلها الإديولوجيات الحديثة ، وبدأت الدراسات الاستشراقية تتأثر بالمعارف التقنية المستحدثة ، ومن هنا عرف الاستشراق تحولات ومنجزات في حقول المعرفة عامة، وفي حقول المعارف الإسلامية خاصة، و أثبتت الظاهرة الاستشراقية فاعليتها وحضورها المعرفي في أكثر البلدان الأوربية، وأصبح الاستشراق مادة علمية ممثلة بكرسي علمي استشراقي في كل جامعة. ولذلك أصبح للاستشراق مجالات متعددة نحو الشرق الإسلامي، وخصوصا فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية، ومن هذه المجالات ما يلي:
أولا: القرآن الكريم.
القرآن محط أنظار المستشرقين عموما، لأنه مصدر القوة في حياة المسلمين، وهو منبع الرؤية في حضارة الإسلام، فهو الموجه لحركة الحياة عند المسلمين، ولمناحي التفكير لديهم، وهو الأصل الأول في معرفة حقيقة الإسلام، وهو الذي يُحدد علاقة الإسلام بالديانات السابقة، إذ هيمن على الكتب السابقة، واستصفى مقاصدها في رسالات السماء إلى أهل الأرض، وكما كان موقف كفار قريش من القرآن الكريم، واعتبروه تارة شعرا ، وتارة سحراً وكهانة وأساطير الأولين ، وكما رموا صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بالافتراء والكذب وبالجنون ، وبحثوا له عن مصدر في الأرض، كانت جهود الاستشراق لا تخرج عن هذه التوجهات والتوجيهات التي استفاد منها كثير من العلمانيين في عالمنا العربي طيلة القرن العشرين، وما يزال بعضهم تشكل لديه منطلقات فكرية و” منهجية ” . وباختصار ظل مشركو مكة والمستشرقون، ومن تتبعهم من أهل الإلحاد يعتبرون القرآن من تأليف النبيr ،والملاحظ أن العداء التاريخي للإسلام ظل مترسبا في العقول ، وأن نيرانه ظلت متقدة إلى اليوم ، وسعت جهود الاستشراق في معالجتها لموضوع القرآن أن تطمس مقولة الوحي فيه ، وأن تُثبت بشريته ليتسنى لها أن تُطفئ نوره بين سكان المعمور، ولم يتحقق شيء من ذلك.
ولقد اعتنت المدرسة الألمانية بدراسة وترجمة القرآن لأمرين هامين :
أولهما: أن البحوث الألمانية تحتل دور القيادة في التخصص في الدراسات الإسلامية في البلاد الغربية ، إذ حققت جهودهم تأثيرا واسعا في جل البحوث اللاحقة في الدراسات الاستشراقية ، وعلى امتداد تاريخ الاستشراق المعاصر .
ثانيهما: أصبحت تلك البحوث مرجعا وعمدة في كل ما يتعلق بشؤون القرآن، توثيقا وتأريخا ومعرفة بعلومه .
ولقد برزت بعض القيادات الاستشراقية الألمانية التي بذلت وقتا وجهدا كبيرا لدراسة القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الألمانية، وأصبح لهذه القيادات الاستشراقية شهرة كبيرة لا في الأوساط الألمانية فحسب بل في العالم كله، وعلى وجه الخصوص في أوربا، ومن هؤلاء المشاهير، المستشرق تيودور نولدكة ( 1836 – 1931)، الذي تناول أصل القرآن وتركيب سوره ، وهو في سن العشرين، وكان له أطروحة بعنوان ” تاريخ النص القرآني ” قدمها سنة 1858م، حيث تناول فيها ” أصل القرآن وترتيب سوره ” ، ولما أعلنت أكاديمية باريس عن جائزة ، لبحث يكتب في موضوع القرآن ، رحل في طلب المزيد من المصادر لرسالته ، وتوسع فيها ، ثم أرسل مساهمته بعنوان ” تاريخ القرآن ” إلى مسابقة تلك الأكاديمية ( مجمع الكتابات والآداب في باريس ) ، فنال الجائزة سنة1858م ، وبعد أن أعاد نولدكة النظر في تلك الرسالة ، ترجمها إلى الألمانية ، ونشرها بعنوان : ” تاريخ النص القرآني ” سنة 1960م . وقد كان له تأثير عجيب في فكر بعض المستشرقين الذين كان بعضهم تلاميذا له ساهموا كثيرا في إخراج بعض مجلدات كتابه” تاريخ النص القرآن ” ، الذي كان عبارة عن عرض تاريخي مفصل لكل ما يتصل بالقرآن منذ نزول الوحي حتى آخر طبعة ظهرت في القرن التاسع عشر ،حيث خصص الجزء الأول للسور المكية والمدنية ، وتطبيقاً للمنهج التاريخي تابع نولدكه تقسيمه للسور زمنيا إلى ثلاث فترات مكية وفترة مدنية ( وهو تقسيم لقي استحسان كثير من الباحثين ) ، كما حدَّد في هذا الجزء مميزات السور المكية والمدنية ،من حيث الأسلوب والمضمون ، أما الجزء الثالث فقد خصصه لمعالجة تاريخ القرآن ، وبذلك أعاد نولدكه ترتيب القرآن زمنيا على الطريقة التي يريدها وينتهجها ، فأصبح الترتيب الذي انتهجه نولدكه يشغل أذهان المستشرقين جميعاً ، ويُعلقون عليه أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآنية.
ويتضح مما سبق أن البحث في تاريخ القرآن هو بحث في توثيق النص القرآني ، ملابسات نزوله ، جمعه وتدوينه ، قراءاته ، والغاية ربطه بمناخه العام ، لإثبات بشريته، ويعتبر هذا الكتاب أخطر كتاب أنتجه الغرب في تاريخه مع تعامله مع النص القرآني ، ويكفي هذا الكتاب شهرة ومكانه أنه أصبح عمدة في فرع تخصص ” القرآن ” ، وأنه أصبح ملاذا للمستشرقين ممن يريدون نقد القرآن أو التشكيك فيه ، وعلى من يريد الاشتغال علميا بالقرآن على أي نحو من الأنحاء، وذكر د. ميشال جحا أنه أصبح راسخ القدم في العلوم القرآنية ، وأنه وضع أسس البحث العلمي للدراسات القرآنية التي جاءت من بعده، وكتاب نولدكه يعتبره أبو عبد الله الزنجاني في كتابه ” تاريخ القرآن ” من أهم ما ألفه الإفرنج في تاريخ القرآن ، إذ بحث فيه صاحبه بتضلع عميق ، وحاول أن يكون موضوعيا بقدر الإمكان ، وقد تناول البحث حقيقة الوحي والنبوة وما بينهما من علاقة ، وحاول ربط السيرة النبوية بتاريخ السور المكية والمدنية ، كما تناول حكمة نزول القرآن وأسباب نزول الآيات وغيرها من الموضوعات.
ولم يكتف نولدكه بدراسة القرآن الكريم فحسب، بل اضطلع إلى دراسة اللغة العربية والشعر و السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، وله في كلٍ مساهمات كبيرة بما يخدم مصلحته لفهم القرآن والنقض فيه وإثبات بشريته وأنه ليس وحيا منزل من الله تعالى.
ومن يقرأ لنولدكه حول توثيق النص القرآني ، يلاحظ أن موقفه لا يخلو من تناقض واضطراب ، فهو قد لمح إلى وجود التحريف في القرآن في كتابه ” تاريخ النص القرآني ” ؛ وذلك حين كتب فصلا بعنوان : ” الوحي الذي نزل على محمد ولم يُحفَظ في القرآن ” ، ثم نجده يًصرح بالتحريف في مادة ” قرآن ” بدائرة المعارف الإسلامية ، حين يقول : ” إنه مما لا شك فيه أن هناك فقرات في القرآن ضاعت ” ، وفي مادة ” قرآن ” في دائرة المعارف البريطانية يُقرر مسألة التحريف في القرآن فيقول : ” إن القرآن غير كامل الأجزاء ” ، وتناقض نولدكه يبدو في موقفه من المستشرق الألماني ” فلّرس ” الذي زعم أن القرآن مؤلف بلهجة قريش ، وأنه عُدِّل حسب أصول اللغة الفصحى في عصر ازدهار الحضارة العربية ، فانبرى إليه نولدكه يرد عليه موضحا أن كلامه عارٍ من الصحة والتحقيق العلميين، ويبدو أن نولدكه أسهم بشكل قوي في ترسيخ مسألة التحريف في الفكر الاستشراقي ، فقد فتح الطريق أمام تحريف القرآن الكريم.
ويجد الباحث أصداء تلك الدعوى في أعمال المستشرقين ، ومن خلالها انتقلت إلى أذهان كثير من الأوربيين . ويتضح فيما كتبه المستشرق “بول ” في دائرة المعارف الإسلامية الألمانية ( مادة ” تحريف ) . وقد اعتبر ” بول ” التحريف تغييرا مباشرا لصيغة مكتوبة ، وأن الأمر الذي حدا بالمسلمين إلى الاشتغال بهذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن من آيات اتهم فيها محمد r اليهود بتغيير ما أنزل إليهم من كتب ، وبخاصة التوراة . ولكن عرضه للوقائع والشرائع التي جاءت في التوراة انطوى على إدراك خاطئ أثار عليه النقد والسخرية من جانب اليهود ، فكان في نظرهم مبطلا.
ومما يَغمِزُ به نولدكه دقة النص القرآني ، ادعاؤه الغريب أن أوائل السور دخيلة على هذا النص ، ففي الطبعة الأولى في كتابه “ّ تاريخ القرآن ” بالاشتراك مع شافلي ، تظهر- لأول مرة فكرة في تاريخ الدراسات القرآنية – فكرة لا ترى في أوائل السور إلا حروفا أولى أو أخيرة مأخوذة من أسماء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نُسَخ من سور قرآنية معينة . فالسين من سعد بن أبي وقاص ، والميم من المغيرة ، والنون من عثمان بن عفان ، والهاء من أبي هريرة ، وهكذا . فهي- عنده – إشارات لمن كانوا يملكون تلك الصحف ، وقد تُركت في مواضعها سهواً ، وبمضي الزمان أُلحقت بالقرآن ، ويبدو أن نولدكه شعر بخطأ فكرته فرجع عنها ، وأن شافلي أهملها وأغفل ذكرها فيما بعد في الطبعة الثانية ، لكن المستشرقين ” بُهُل ” و” هرسفيلد” قد تحمَّسا لها من جديد وتبَنَّيَها مُتغافليْن عن مدى بُعدها عن المنطق السليم.
وفي الجانب القصصي للقرآن الكريم نجد نولدكه يدس السم في العسل، فيُبدي إعجابَه بالإعجاز البياني للقرآن ، ونجده دقيقا وعميقا ، يأخذك الإعجاب بموضوعيته ومنهجيته ، واطلاعه الواسع ، ثم سرعان ما يتغيَّر، فيسعى إلى التدليس والتجريح، والقارئ له في غمرة الإعجاب، وتتبدى للقارئ بضاعته في تذوق أساليب القرآن، ومن هنا يطفوا الدخن والسم الاستشراقي الدفين في خلجاته على السطح، وتتكشف المنهجية والموضوعية، التي سرعان ما تتهاوى وتتساقط أمام الحقد والعداوة للإسلام وأهله، ينقل الأستاذ أنيس المقدسي ” قول نولدكه أن في قصص القرآن انقطاعا وبترا يفسدان ترتيب الأخبار وتسلسلها، ويعرضها إلى الغموض، وهو موقف نابع من تشبع وجدانه بأسلوب القصة في التوراة، ونابع من جهله بخصوصيات القصة القرآنية، وتناغم أسلوب الوحي مع مقاصد السماء والأرض”، وقد قام أنيس المقدسي بمراجعة أقوال نولدكه وانتقادها ومن ثم قام بالرد عليها، قائلا” ولا يجوز مقابلة هذا الأسلوب بأسلوب القصة في التوراة لاختلاف الغرض فيهما، ففي التوراة عدا أسفار الأنبياء والأمثال والأناشيد الروحية، حوادث تاريخية منظمة تجري الأخبار مجراها الواضح العادي، أما القرآن فإنه يشير إلى الحوادث التاريخية بوثبات ومجملات روحية خطابية لا يقصد بها تسلسل الخبر، بل يقصد بها إلى التذكير والتهويل، ولذلك ترد مرارا بحسب ما يقتضيه الكلام، وكثيرا ما ترد على سبيل الإشارة والتلميح، والنسق الخطابي يقتضي التكرار كما هو معروف “.
ولم يكتف المستشرق نولدكه بما سبق من النقد والتجريح لقصص الكتاب العزيز ،بل تمادى به الأمر لأن ينتقد اضطراب الأسلوب القصصي في القرآن، متمثلا ذلك الانتقاد في تكرير بعض الألفاظ والعبارات تكريرا لا مسوغ له في رأيه، وأشار إلى كثرة انتقال القرآن في خطاباته من صيغة إلى أخرى، ومن حال إلى حال، فمن غيبة إلى خطاب، ومن ظاهر إلى مضمر، وبالعكس، واعتبر ذلك مجالا للتجريح، والحق أن للرجل ثغرات تبعد صاحبها عن التمعن والتدقيق وروح الإنصاف وتجعله متطرفا ومرده في هذا ، إلى عدم تمرسه بضروب البلاغة العربية، ولعل في آرائه مزيجا بين الهراء والدس الذي لا يحمد عليه اسم مثله، ومتى كان العالم جانبيا في التفكير، أو هامشيا في التعليق، أو سطحيا في الاستنتاج، أخذت عليه هذه المآخذ الفجة .
ويتضح لنا مما سبق، ما بذله المستشرقون ، وعلى رأسهم المستشرق الألماني نولدكه، حول مجال القرآن الكريم، أنه على الرغم مما بذلوه من الجهود المضنية لنقد كتاب الله العزيز والتشيك فيه وفيما جاء به من التشريع العظيم والطعن في كونه كلام الله تعالى الموحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذه الجهود الاستشراقية تضاءلت واضمحلت وتهاوت أمام إعجاز وبلاغة القرآن الكريم ، فقد أضاع المستشرقون المفاتيح البيانية للدخول إلى رحاب القرآن العظيم يوم قالوا ببشريته ، مما أنساهم قدس الوحي وربانيته ، فراحوا يبحثون في سيرة الرسول الكريم لعلهم يعثرون عن مصدر للقرآن .
إن الجهود الاستشراقية، وعلى رأسها مدرسة نولدكه،لم تخرج عن الأطر المعرفية للاستشراق ، فهي بدورها أنكرت سماوية القرآن ونبوة الرسولr، فما هو الجديد عند نولدكه أو غيره من المستشرقين ؟ قيل هو المنهج الذي صار قدوة للمعجبين الذي جعلوه ملكا علميا مشاعا بينهم ، بل هو المنهج الذي يقود ويذكر بما قاله مشركو قريش منذ قرون حين نزوله من الله تبارك وتعالى . ولذلك كانت شهادة د. ميشال جحا من أن نولدكه ” حاول في كل ما كتب أن يكون مثال العالم المتجرد العقلاني ، فلم يتجن في أبحاثه على الإسلام ، ولم يحاول أن يدَّعيَ معرفة أشياء لم يكن يعرفها ، ولهذا جاءت آراؤه واضحة جلية وخاضعة لصفة التجرد بعيدة عن الهوى والتضليل ، شهادة منقوضة وبعيدة عن الحقيقة، إذ أن نولدكه وغيره من المستشرقين قد جانبهم الإنصاف في دراساتهم للتراث الإسلامي وعلى ذروته كتاب الله عز وجل، إذ لم يكن هدفهم سوى الهدم والنقض والإقصاء لدين الله وكل ما يتصل به من العلوم والمعارف، .
والذي ينبغي على أمة الإسلام ألا تنخدع ببريق المنهج الاستشراقي ، إن أهداف معاشر المستشرقين، هي نسف النص من أساسه وإشاعة الشك في توثيقه ، وبالتالي تشكيك شعوب الأرض – ومن بينهم المسلمون – بحقيقة الوحي، وهي حقيقة تعذَّر على العالم الغربي أن يُقر بها فحاول أن ينسف علاقة القرآن بالسماء ، لأن الفكر الغربي مشدود إلى المادة ، وكتاب ” تاريخ النص القرآني ” على ما يدعيه له بعضهم من دقة وموضوعية ومنهجية ، فإنه من تلك الجهود التي طمست حقيقة الوحي في الذهنية الغربية ، فلم يستطع أن يتمثل حقيقة الوحي الالهي فظل مشدودا إلى الأرض يبحث عن مصدر للقرآن فيها، وقد أشاعت كتبه ومقالاته داخل دوائر المعارف أوهما تشكك غير المسلمين وبعض المسلمين في حقيقة الوحي .
وخطورة المدرسة الألمانية في مجال الدراسات القرآنية أن نتائجها تسربت إلى دوائر المعارف بلغات العالم ، وأسهمت في طمس حقيقة الإسلام في قلوب كثير من الخلائق ، في العالم الغربي خاصة ، وتحاملت على الوحي لنفي ألوهيته وإشاعة بشريته .
وحقيقة الوحي حُجبت عن عقول المستشرقين نتيجة عوامل أهمها :
1) تعصب ديني أعمى كثيراً من العقول ، وكان ذلك من نتائجه نزعة لاهوتية حاقدة على الإسلام والشرق .
2) النزعة الاستعلائية ترى حضارة العرب بركة صغيرة بلغها شيء من الماء من نهر اليونان العظيم الخالد .
3) شيوع عقلانية شدت أنظار المستشرقين إلى العوامل المادية، الإيمان بالماديات فقط .
4) علمانية تتعقلن في دهريتها ،وتستبعد الألوهية ، وتعتبر منتهاها في دنياها .
5) إمبريالية تريد أن تُعربد بأموال غيرها ، وأن تفرض غرورها على المستضعفين في الأرض . يقول الإمام الغزالي : ” إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في البحث ، وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد ، وجمهرة المستشرقين مستأجرون لإهانة الإسلام وتشويه محاسنه والافتراء عليه “.
ثانيا: السنة النبوية.
يعلم المستشرقون يقينا مدى أهمية السنة النبوية في دين الله عز وجل، بل وأهميتها البالغة في نفوس أمة الإسلام، فهي المصدر الثاني للتشريع، وهي المفسرة لكتاب الله عز وجل، كما أنهم يعلمون أن النيل منها والتشكيك في مصداقيتها هو تشكيك في القرآن الكريم ، ولذلك عمدوا إلى دراستها بهدف النقض فيها والتشكيك في مصدرها، والقدح في رواياتها بل وفي رواتها وأسانيدها، يقول المبشر الأمريكي (جب) : “إن الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر مما هو مبنى على القرآن الكريم، ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء، وصار شبه صبيرة طومسون، وطومسون هذا رجل أمريكي، جاء إلى لبنان فقدمت له صبيرة فحاول أن ينقيها من البذر، فلما نقى منها كل بذرها لم يبق في يده منها شيء”.
والمستشرقون يسيرون في محاربة السنة، والتشكيك في صحتها على درب المستشرق “جولد تسيهر” في موقفه من السنة ويرددون شبهاته واعتبروا أنفسهم مدينين له فيما كتبه من شبهات حول السنة الشريفة ، يقول عنه كاتب مادة (الحديث) في دائرة المعارف الإسلامية ، “إن العلم مدين دينا كبيرا لما كتبه (جولد تسيهر) في موضوع الحديث، وقد كان تأثير “جولد تسيهر” على مسار الدراسات الإسلامية الاستشراقية أعظم مما كان لأي من معاصريه من المستشرقين فقد حدد تحديداً حاسماً اتجاه وتطور البحث في هذه الدراسات”.
ومن هنا كان الرد على هذا الخبيث ردا على عصابة المستشرقين إجمالا فيما أثاروه من شبهات وطعون حول السنة النبوية المطهرة .
ولما عجز أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين في الماضي والحاضر، في التحريف والعبث بالقرآن الكريم، غيرو مسارهم إلى السنة النبوية واتخذوا للوصول إلى غايتهم الدنيئة أساليب متعددة، فأخذوا بالطعون والتجريح ونفخوا فيها، وزادوا ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا، وقد وجهوا شبهاتهم حول مفهوم السنة وتدوينها، وجهالاتهم حول السند والمتن، ولذلك كان لزاما على الغيورين على شريعة اللهن وخصوصا فيما يتصل بالكتاب والسنة، مواجهة هذا المد الاستشراقي الخبيث والمملوء بالسموم والآفات الفكرية، مواجهة جادة، وِفق أصول التحديث رواية ودراية، لرد هذه الشبهات، وبيان تهافت تلك المفتريات، ومواجه هذه الأباطيل بعوامل البناء، لدحض معاول الهدم والفناء.
إن هؤلاء المستشرقين الذين يبثون الشكوك حول السنة الشريفة ورواياتها وأسانيدها، يتذرعون- أحياناً- بما دخل على الحديث من وضع ودس، متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماؤنا لتنقية الحديث الصحيح من غيره، مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري، مما لم يعهد عشر معشاره في التأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم، وهذا ملاحظ ومشاهد في مؤلفات وصحاح السنة المطهرة، والذي حملهم على البغي والتجني على تراث رسول اللهr هو ما رأوه في الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة، وهم لا يعتقدون بنبوَّة خاتم النبيّين عليه الصلاة والسلام، فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن النبي الأمي، بل هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى، فالعقدة النفسية عندهم هي عدم تصديقهم بنبوة محمدr ومنها تنبعث كل تخبطاتهم ومفترياتهم وجهالاتهم.
ولقد أثار المستشرقون الكثير من الشبهات حول مفهوم السنة والحديث، وليس هذا مقام البسط لها وذلك لمجافاتها لمسار البحث، وإنما تكفي الإشارة إلى بيان تعديهم وجنايتهم على سنة رسول اللهr ، ولم يكتف المستشرقون عند حد شبهاتهم حول المفهوم والتدوين، وإنما تعدوا ذلك إلى الطعون في السنة، وتنوعت أساليبهم في ذلك حول السند والمتن ، مما يستدعي الدعاة إلى الله ممن يملكون أدوات الرد ، إلى بيان جهالاتهم والرد على شبهاتهم حول أكاذيبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: اللغة العربية وآدابها
لم يقف حد اهتمامات المستشرقين عند القرآن الكريم والسنة النبوية، بل تعدى ذلك إلى اللغة العربية وآدابها، التي هي لغة القرآن العظيم ومرتكز السنة الشريفة، وذلك لأن اللغة العربية هي المدخل الحيوي لهم للنقض والتشكيك والتجريح والتزييف في القرآن والسنة والسيرة بل وفي التاريخ الإسلامي، والتاريخ الاستشراقي مليء بالأمثلة الحية والشاهدة على ذلك، ومنها على سبيل الاستلال لا الحصر ذلك المستشرق “هاملتون جب”، وكذلك المستشرق “ماسينيون”، والمستشرق “سلفستر دي ساسي”، الذي أسس “مدرسة اللغات الشرقية الحية” في باريس، وكانت “قبلة” المستشرقين في ذلك الزمن، ومن خلال اهتمام المستشرقين باللغة العربية وآدابها نادى بعضهم بالاهتمام باللهجات المحلية، وما يسمى بالفلكلور حتى إنهم أقنعوا كثيرا من الطلاب العرب والمسلمين بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه حول اللهجات المحلية والفلكلور، ودعا بعض المستشرقين أيضا إلى العامية، ووضع قواعد خاصة بها، بحجة صعوبة اللغة الفصحى، أو أنها قديمة، أو كلاسيكية غير صالحة في الوقت الحاضر، بل إن بعض المستشرقين نادوا بكتابة اللغة العربية بالأحرف اللاتينية.
إن الاهتمام بالأدب العربي الحديث قد ازداد على مرِ السنين، فهناك أكثر من دورية تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، تتخصص في الأدب العربي أو الدراسات العربية، فعلى سبيل المثال (المجلة الدورية للدراسات العربية Arab Studies Quarterly، ومجلة المختار في دراسات الشرق الأوسط Digest of Middle East Studies التي بدأتْ في الصدور منذ ست سنوات، ومجلة آداب الشرق الأوسط (أدبيات) (Middle East Literature(Literary Articles)، التي تتعاون في إصدارها جامعة “أكسفورد” البريطانية، وجامعة “داكوتا” الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت في الصدور منذ عام 1996م، ومن القضايا التي اهتم بها الاستشراق استخدامُ اللغة الفصحى في الإبداع الأدبي، سواء كانت قصة، أم رواية، أم مسرحية، وقد جعلوا هذه القضية من القضايا التي أولوها اهتماما كبيرا، وقد ناقش “أحمد سمايلوفيتش” هذه القضية في كتابه، (فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي الحديث)، وأكد أنها من أخطر الهجمات التي تعرضت لها اللغة العربية، ونقل عن “عثمان أمين” قوله: “إن حملات التغريب شنها النفوذ الغربي وأعوانه في آسيا وإفريقيا، مصوبا هجماته إلى التراث العربي الإسلامي بوجه عام، وإلى اللغة العربية بوجه خاص”.
ومن هنا يتبين لنا مدى ما تعرضت له اللغة العربية من قبل الحملة الاستشراقية الشرسة، للقضاء على أصالتها وعلاقتها الوطيدة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، ومن ثم إحياء العامية في حياة الناس ونشرها في ميادين العلم، وذلك للقضاء على الفصحى، ومما يؤكد ذلك توجيه الطلاب العرب والمسلمين إلى كتابة وتأليف رسائل الماجستير والدكتوراه في العامية واللهجات المحلية، ومن هنا يتسنى للمستشرقين التشويش على الناس والتشكيك في محتوى الكتاب والسنة، ولعل توجه كثير من المسلمين اليوم إلى استخدام العامية في التعليم والمراسلات والشعر والكلام المباشر برهان واضح على التخلي عن اللغة العربية واستخدامها في الحياة العامة.
رابعا: الفقه الإسلامي.
الفقه الإسلامي كغيره من المجالات الاستشراقية التي نفث المستشرقون سمومهم في كل ما يتصل بدين الإسلام وتراثه الخالد، فأعملوا دراساتهم في الفقه الإسلامي من ناحية أحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، وتطور الدراسات الفقهية عند المسلمين، لعلمهم أن دراسة الفقه الإسلامي تعطيهم الفرصة لفهم أعمق للمجتمعات الإسلامية قديما وحديثا، وفي دراستهم للفقه الإسلامي، يسلطون الضوء على فهم الأحكام الإسلامية في العبادات والمعاملات في التشريعات الاجتماعية، وفي الفكر السياسي وغيرها من جوانب الدين، وقد حاولوا جهدهم من خلال هذه الدراسات التأثير في حياة الأمة الإسلامية، بالزعم بعدم أصالة الفقه الإسلامي، وأنه مأخوذ من التشريعات الرومانية، والفارسية، والهندية، وغيرها، ثم زعموا باطلا تطور التشريعات الإسلامية، ليصلوا من ذلك إلى أن يستمر المسلمون في تطوير وتحديث وتجديد هذه التشريعات تمهيدا للأخذ من التشريعات والأنظمة والقوانين الأوروبية الحديثة.
ولعل من أبرز من كتب في هذا المجال من الفقه الإسلامي من المستشرقين المستشرق، “جوزيف شاخت” 1902 – 1970، ومن المعروف أن (جوزيف شاخت) حاول أن يأتِي بنظرية جديدة حول أسس الفقه الإسلامي، ونشر لبيانِها عدة كتب ومقالات بالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ووضع كتاب (المدخل إلى الفقه الإسلامي) لهذا الغرض، وإن كان كتابُه: (أصول الشريعة المحمدية) يعد من أشهر مؤلفاته على الإطلاق، كما عبَّر عنه المستشرق “جب” بأنه (سيصبح أساسا في المستقبل لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته، على الأقل في العالم الغربي)، وقد أثرت نظريات (شاخت) تأثيرا بالغًا على جميع المستشرقين تقريبًا، مثل، (أندرسون)، و(روبسون)، و(فيتزجرالد)، و(كولسون)، و(بوزورث)، كما أن لهذه النظريات تأثيرا عميقا على من تثقفوا بالثقافات الغربية من المسلمين.
يقول د. محمد مصطفى الأعظمي ” إن كتاب شاخت يحاول أن يقلع جذور الشريعة الإسلامية، ويقضي على تاريخ التشريع الإسلامي قضاء تاما، فهو يزعم أنه “في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي – في معناه الاصطلاحي – وجود كما كان في عهد النبي، والقانون – أي الشريعة – من حيث هي هكذا كانت تقع خارج عن نطاق الدين، وما لم يكن هناك اعتراض ديني أو معنوي روحي على تعامل خاص في السلوك، فقد كانت مسألة القانون تمثل عملية لامبالاة بالنسبة للمسلمين، حيث صرَّح “شاخت” بأنه (من الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقهية صحيحا بالنسبة إلى النبي).
ولقد حظيت مقولة شاخت تلك بصدى واسعا لدى الكثير من المتغربين في بلاد المسلمين، وأسست أفكار ومقولات يرددونها عبر ما يجدون من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فتعرضت السنة الشريفة والفقه الإسلامي إلى اتهامات ظالمة، وهجوم سافر ، وكأن الفقه لا علاقة له بالكتاب والسنة، وقد قام د. عماد الدين خليل من خلال بحثه المقارن -المستشرقون والسيرة النبوية، بحث مقارن في منهج المستشرق البريطاني المعاصر “مونتجمري وات”، حيث بدأ بعدة ملاحظات أساسية، اعتبرها بمثابة المدخل المنهجي لمناقشة المستشرق “وات”، وهي تمثل منطلقات موضوعية لتقويم الدراسات في حقل السيرة الشريفة، إذ يؤكد “أن الدين، والغيب، والروح، لهي عصب السيرة وسداها ولحمتها، وليس بمقدور الحس أو العقل أن يُدلِي بكلمته فيها إلا بمقدار، وتبقى المساحات الأكثر عمقا وامتدادا بعيدة عن حدود عمل الحواس، وتحليلات العقل والمنطق، إننا – ونحن نناقش هذا المستشرق أو ذاك في حقل السيرة النبوية – يجب أن ننتبه إلى هاتين النقطتين، مهما كان المستشرق ملتزما بقواعد البحث التاريخي وأصوله، إنه من خلال رؤيته الخارجية وتغربه يمارس نوعا من التكسير والتجريح في كيان السيرة ونسيجها، فيصدم الحس الديني، ويرتطم بالبداهات الثابتة، وهو من خلال منظوره العقلي الوضعي يسعى إلى فصل الروح عن جسد السيرة، ويعاملها كما لو كانت حقلا ماديا للتجارب والاستنتاجات، وإثبات القدرة على الجدل، وكانت النتيجة أبحاثا تحمل اسم السيرة، وتتحدث عن حياة الرسولr وتحلل حقائق الرسالة، ولكنها – يقينا – تحمل وجها وملامح وقسمات مستمدة من عجينة أخرى غير مادة السيرة، وروح أخرى غير روح النبوة، ومواصفات أخرى غير مواصفات الرسالة، إنها تسعى لأن تخضع حقائق السيرة لمقاييس عصر تنسخ كل ما هو جميل، وتزيف كل ما هو أصيل، وتَمِيل بالقيم المشعَّة إلى أن تفقد إشعاعها، وترتَمي في الظلمة، أو تؤول إلى البشاعة، إن الغربيين لم يستطيعوا أن يقدموا أعمالاً علمية بمعنى الكلمة لواقعة السيرة، ولا قدروا حتى على الاقتراب من حافة الفهم؛ بسبب إنهم كان يعوزهم التعامل الأكثر علمية مع احترام المصدر الغيبي، واعتماد الموقف الموضوعي بغير حكم مسبق الذي يتجاوز كل الإسقاطات، التي من شأنها أن تعرقل عملية الفهم، والجذور العميقة هي المنهج الخاطئ الذي تقوم عليه أبحاث هؤلاء المستشرقين؛ فالمستشرق بين أن يكون علمانيا ماديا لا يؤمن بالغيب، وبين أن يكون يهوديا أو نصرانيا لا يؤمن بصدق الرسالة التي أعقبت النصرانية، لذا فإنه – من الناحية المبدئية – يجب على المثقف المسلم رفض القبول النهائي لنتائج بحوث المستشرقين في حقل السيرة، لأنها مهما تكن على درجة من الحيادية والنزاهة، فإنها لا بد أن تسقط في الخطأين، “القصور عن الفهم، وتدمير الثقة بأسس هذا الدين”.
قلت ومجالات الاستشراق والمستشرقين تجاه التراث الإسلامي كثيرة، وطعنهم وتشكيكهم في جوانب الدين أكثر من أن تحصى، ولعلي أتيت من المجالات المهم ، دون التعرض لبقيتها، وذلك للاختصار وعدم الإطالة، ولعل ما ذكرت سبيلا لما وراءه لمن أراد التوسع في هذا الجانب، وإلا فالمستشرقون لم يتركوا بابا أو مجالا للصد عن هذا الدين وتشويه معالمه السامية، بل وتشويه سمعة وصورة كل من ينتسب إليه، وخصوصا من يهتمون بالدعوة إلى الله، ولكن مع كل هذه الهجمة الشرسة من أعداء الدين من المستشرقين وغيرهم، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وينصر دينه ولو عن طريق فاجر، ولذلك فهناك ثلة من المستشرقين المنصفين للإسلام وأهله، من خلال كتبهم وكتاباتهم، إذ أظهروا حقيقة دين الإسلام وسماحته، فكانت آرائهم شوكة في نحور أعداء الدين والملة من بني جلدتهم.