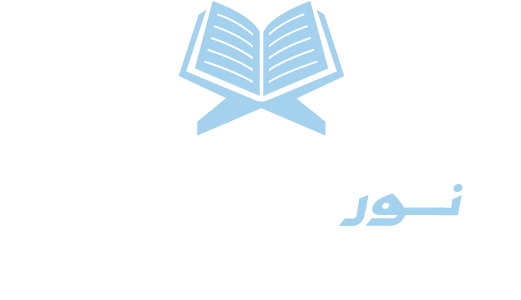قوله: “وَالعِبادُ فاعِلونَ حَقيقَةً، وَاللهُ خالِقُ أفْعالِهِم”.
* هذا صحيح؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة، والله خالق فعله حقيقة، وهذه عقيدة أهل السنة، وقد سبق تقريرها بالأدلة.
* وخالفهم في هذا الأصل طائفتان:
الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة، والله لم يخلق أفعالهم.
الطائفة الثانية: الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله خالق أفعالهم، وليسوا فاعلين حقيقة، لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز، وإلا؛ فالفاعل حقيقة هو الله.
وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، وأن الخلق هو الله، ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم؛ فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله!! وله لوازم باطلة أخرى.
* وبهذا تبين أن في قول المؤلف: “والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم”: ردًّا على الجبرية والقدرية.
* قوله: “وَالعَبْدُ هُوَ المُؤْمِنُ وَالكافِرُ، وَالبَرُّ وَالفاجِرُ، وَالمُصَلّي وَالصّائِمُ”.
* يعني: أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد، لا لغيره؛ فهو المؤمن، وهو الكافر، وهو البار، وهو الفاجر، وهو المصلي، وهو الصائم … وكذلك هو المزكي، وهو الحاج، وهو المعتمر … وهكذا، ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة.
* وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية.
– فالعامة: هي الخضوع لأمر الله الكوني؛ كقوله تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: ٩٣].
– والعبودية الخاصة: هي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهي خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [الفرقان: ٦٣]، وقوله: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ}، وهذه أخص من الأولى.
* قوله: “وَلِلعِبادِ قدرَةٌ عَلى أعمالِهِم، وَلَهُم إرادَةٌ، وَاللهُ خالِقُهم وَخالِقُ قدرَتِهم وَإرادَتِهِم”.
* “للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة”؛ خلافًا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة، بل هم مجبرون عليها.
* “والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم”؛ خلافًا للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقًا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته.
* وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقًا لله تعالى؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة، وخالق القدرة والإرادة هو الله، وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق.
ويشير بها أيضًا إلى كون فعل العبد اختياريًّا لا إجباريًّا؛ لأنه صادر عن قدرة وإرادة؛ فلولا القدرة والإرادة؛ لم يصدر منه
الفعل، ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه الفعل، ولو كان الفعل إجباريًّا؛ ما كان من شرطه القدرة والإرادة.
* * *
ثم استدل المؤلف لذلك، فقال: “كما قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: ٢٨، ٢٩] “.
* فقوله: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ}: فيها رد على الجبرية.
* وفي قوله: {وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}: رد على القدرية.
* * *
* قوله: “وَهذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ”؛ أي: درجة المشيئة والخلق.
* “يُكَذِّبُ بِها عامَّةُ القَدَرِيَّةِ، الذينَ سمَّاهُمُ النَّبِيّ – صلى الله عليه وسلم – مَجوسَ هذِهِ الأمَّةِ”.
* “عامة القدرية”؛ أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة، ويقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، وليس لله فيه مشيئة ولا خلق.
* و“سماهم النبي – صلى الله عليه وسلم – مجوس هذه الأمة” (رواه أحمد وأبو داود)؛ لأن المجوس
يقولون: إن للحوادث خالقين: خالقًا للخير، وخالقًا للشر! فخالق الخير هو النور، وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله؛ فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد؛ فهذه للعباد استقلالًا، وليس لله تعالى فيها خلق.
* * *
* قوله: “وَيَغْلو فيها قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الإثْباتِ، حتَّى سَلَبوا العَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيارَهُ، وَيُخْرِجونَ عَن أفْعالِ اللهِ وَأحكامِهِ حِكَمَها وَمَصالِحَها”.
* “يغلو فيها”؛ أي: في هذه الدرجة.
* “قوم من أهل الإثبات”؛ أي: إثبات القدر.
* وهؤلاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ لأنه مكتوب عليه.
* قوله: “ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها”: “يخرجون”: معطوفة على قوله: “يغلو”.
* ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله
وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئة، ولهذا يثيب المطيع، وإن كان مجبرًا على الفعل، ويعاقب العاصي، وإن كان مجبرًا على الفعل.
ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود، ولا الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختياره.
* وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه المنكر؛ قال: هذا هو ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله؟! فيحتج بالقدر على معاصي الله، ويقول: أنا عبد مسير! ثم يحتج أيضًا بحديث: “تحاج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم: أنت موسى! اصطفاك الله بكلامه، وكتب لك التوراة بيده! أتلومني على أمر قدره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ “. قال النبي عليه الصلاة والسلام: “فحج آدم موسى”؛ قالها ثلاثًا (رواه البخاري ومسلم). وعند أحمد: “فحجه آدم” (رواه أحمد). وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة.
قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسى؛ احتج عليه بالقدر، وآدم نبي، وموسى رسول، فسكت موسى؛ فلماذا تحتج عليَّ؟
والجواب على حديث آدم:
– أما على رأي القدرية؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا
توجب اليقين، قالوا: وإذا عارضت العقل، وجب أن ترد. وبناء على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به.
– أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل، ودلالته حق، ولا يلام العبد على ما قدر عليه.
– أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب، وصار ذنبه سببًا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام -وهو أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ فكيف يلومه موسى؟!
وهذا وجه ظاهر في أن موسى – عليه السلام – لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما على المصيبة التي هي من قدر الله، وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية.
فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري، ولكننا لا نحتج به على المعصية، كما فعل الجبري.
وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وقال: الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة
منها؛ فلا بأس به.
ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها، وقلت: هذا بقضاء الله وقدره، وأستغفر الله وأتوب إليه … وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا.
فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصية، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها.
ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين طرق عليًّا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة، فقال: “ألا تصليان؟ “. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله! أنفسنا بيد الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثنا. فانصرف النبي – صلى الله عليه وسلم – يضرب فخذه وهو يقول: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤] (رواه البخاري ومسلم).
وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرًا؛ لأن عليًّا رضي الله عنه احتج بالقدر بنومه، والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر؛ لأن فعله لا ينسب إليه، ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف: {وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ} [الكهف: ١٨]؛ فنسب التقليب إليه، مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة منهم؛ لم يضفه إليهم.
والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى -وهو ما
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -هو الصواب.
* فإذًا؛ لا حجة للجبري بهذا الحديث، ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر.
فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع:
– فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا} [الأنعام: ١٤٨]؛ قالوا ذلك احتجاجًا بالقدر على المعصية، فقال الله تعالى: {كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}؛ يعني: كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر {حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا}، وهذا يدل على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما ذاقوا بأس الله.
– ودليل سمعي آخر: قال الله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِه} [النساء: ١٦٣] [النساء: ١٦٣] إلى قوله: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: ١٦٥]، ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة؛ ما بطلت بإرسال الرسل، وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال الرسل، بل هو باق.
فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام: ١٠٦ – ١٠٧]؛ فهنا قال الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا}؛ فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا}: قول صحيح وجائز، لكن قول المشرك: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: ١٤٨]؛ يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل، والله عزَّ وجلَّ إنما قال لرسوله هكذا تسلية له وبيانًا أن ما وقع فهو بمشيئة الله.
– وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعًا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي: هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ سيقول: لا. فنقول: إذًا؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك. واحتجاج الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل؛ لأن الحجة لا بد أن تكون طريقًا يمشي به الإنسان؛ إذ إن الدليل يتقدم المدلول.
ونقول له أيضًا: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معبد آمن، والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذًا؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار، وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله
تعالى بالأمن لمن سلكه؛ فقال: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ} [الأنعام: ٨٢]، وهذه حجة واضحة.
ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين: إحداهما بالمرتبة العالية، والثانية بالمرتبة السفلى؛ فأيهما تريد؟ بلا شك ستريد المرتبة العالية، وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟! وهل هذا إلا تناقض منك؟!
وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدًا لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله عزَّ وجلَّ. 2/228