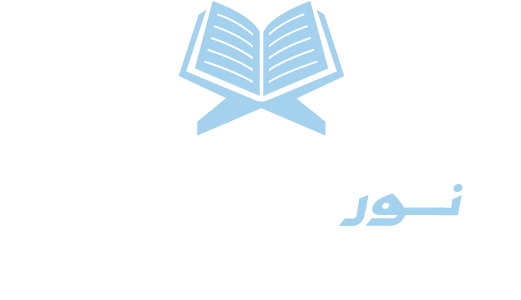(وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (البقرة:89)
(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) (البقرة:90)
التفسير:
.{89 } قوله تعالى: { ولما جاءهم كتاب }: هو القرآن؛ ونكَّره هنا للتعظيم؛ وأكد تعظيمه بقوله تعالى:
{ من عند الله }، وأضافه الله تعالى إليه؛ لأنه كلامه . كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله..
قوله تعالى: { مصدق لما معهم }: له معنيان:.
الأول: أنه حكم بصدقها، كما قال في قوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله} [البقرة: 285] ؛ فهو يقول عن التوراة: إنه حق، وعن الإنجيل: إنه حق؛ وعن الزبور: إنه حق؛ فهو يصدقها، كما لو أخبرك إنسان بخبر، فقلت: “صدقت” تكون مصدقاً له..
المعنى الثاني: أنه جاء مطابقاً لما أخبرت الكتب السابقة . التوراة، والإنجيل؛ فعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ( قال: {إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} [الصف: 6] ؛ فجاء هذا الكتاب مصدقاً لهذه البشارة..
وقوله تعالى: { لما معهم } أي من التوراة، والإنجيل؛ وهذا واضح أن التوراة أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه، أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره..
قوله تعالى: { وكانوا من قبل } أي من قبل أن يجيئهم {يستفتحون } أي يستنصرون، ويقولون سيكون لنا الفتح، والنصر { على الذين كفروا } أي من المشركين الذين هم الأوس، والخزرج؛ لأنهم كانوا على الكفر، ولم يكونوا من أهل الكتاب . كما هو معروف؛ فكانوا يقولون: إنه سيبعث نبي، وسنتبعه، وسننتصر عليكم؛ لكن لما جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به؛ { فلعنة الله }: اللعنة: هي الطرد، والإبعاد عن رحمة الله؛ { على الكافرين } أي حاقة عليهم؛ وهو مظهر في موضع الإضمار؛ إذ كان مقتضى السياق: “فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم”؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد؛ منها: مراعاة الفواصل كما هنا؛ ومنها الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف؛ ومنها الإشعار بالتعليل؛ ومنها إرادة التعميم..
.{ 90 } قوله تعالى: { بئسما اشتروا به أنفسهم }: “بئس” فعل ماضٍ لإنشاء الذم؛ يقابلها “نِعْم”: فهي فعل ماضٍ لإنشاء المدح؛ و”بئس”، و”نعْم” اسمان جامدان لا يتصرفان . أي لا يتحولان عن صيغة الماضي؛ و “ما” اسم موصول بمعنى الذي . أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم؛ أو إنها نكرة موصوفة، والتقدير: “بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم”، و{ اشتروا } فسرها أكثرهم بمعنى باعوا؛ وهو خلاف المشهور؛ لأن معنى “اشترى الشيء”: اختاره؛ والمختار للشيء لا يكون بائعاً له؛ والصحيح أنها على بابها؛ ووجهه أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر كانوا راغبين فيه، فكانوا مشترين له..
قوله تعالى: { أن يكفروا }: { أن } هنا مصدرية؛ والفعل بعدها مؤول بمصدر، والتقدير: كفرُهم؛ وهو المخصوص بالذم؛ وإعرابه مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله؛ { بما أنزل الله }: “ما” هذه اسم موصول بمعنى الذي؛ والمراد به: القرآن؛ لأنه تعالى قال في الأول: { ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم}؛ و{ بغياً } مفعول لأجله عامله: قوله تعالى: { يكفروا }؛ و “البغي” فسره كثير من العلماء بالحسد؛ والظاهر أنه أخص من الحسد؛ لأنه بمعنى العدوان؛ لأن الباغي هو العادي، كما قيل: على الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي: مرتعُ مبتغيه وخيم؛ فالبغي ليس مجرد الحسد فقط؛ نعَم، قد يكون ناتجاً عن الحسد؛ والذين فسَّروه بالحسد فسَّروه بسببه..
قوله تعالى: { أن ينزل الله من فضله }: “الفضل” في اللغة: زيادة العطاء؛ والمراد بـ “الفضل” هنا الوحي، أو القرآن، كما قاله تعالى: {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون} (يونس: 58).
قوله تعالى: { على مَن يشاء من عباده }: { مَنْ } اسم موصول؛ والمراد: النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن في الحقيقة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كما قال تعالى: {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} [إبراهيم: 1] ؛ و{ يشاء } أي يريد بالإرادة الكونية؛ والمراد بـ{ عباده } هنا الرسل..
قوله تعالى: { فباءوا } أي رجعوا؛ { بغضب }: الباء للمصاحبة . يعني رجعوا مصطحبين لغضب من الله سبحانه وتعالى؛ ونكَّره للتعظيم؛ ولهذا قال بعض الناس: إن المراد بـ “الغضب” : غضب الله سبحانه وتعالى، وغيره . حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء، وتصرفهم..
قوله تعالى: { على غضب } . كقوله تعالى: {ظلمات بعضها فوق بعض} [النور: 40] . يعني غضباً فوق غضب؛ فما هو الغضب الذي باءوا به؟ وما هو الغضب الذي كان قبله؟
الجواب: الغضب الذي باءوا به أنهم كفروا بما عرفوا، كما قال تعالى: { فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به }؛ والغضب السابق أنهم استكبروا عن الحق إذا كان لا تهواه أنفسهم، كما قال تعالى: {أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم} [البقرة: 87] ؛ والغضب الثالث: قتلهم الأنبياء، أو تكذيبهم؛ فهذه ثلاثة أنواع من أسباب الغضب؛ وقد يكون أيضاً هناك أنواع أخرى..
قوله تعالى: { وللكافرين عذاب مهين }: هذا إظهار في موضع الإضمار فيما يظهر؛ لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ الضمير . أي ولهم عذاب مهين؛ والإظهار في موضع الإضمار له فوائد سبق بيانها قريباً..
وقوله تعالى: { عذاب } أي عقوبة؛ و{ مهين } أي ذو إهانة، وإذلال؛ ولو لم يكن من إذلالهم . حين يقولون: { ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون } [المؤمنون: 107] . إلا قول الله عزّ وجلّ لهم: {اخسئوا فيها ولا تكلمون} [المؤمنون: 108] لكفى..
الفوائد:
.1 من فوائد الآيتين: أن القرآن من عند الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ( كتاب من عند الله )
.2 ومنها: أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة؛ لقوله تعالى: { كتاب من عند الله }؛ ومعلوم أن الكلام ليس جسماً يقوم بنفسه حتى نقول: إنه مخلوق..
3 . ومنها: التنويه بفضل القرآن؛ لقوله تعالى: { مصدق لما معهم }، ولقوله تعالى: ( من عند الله )
.4 ومنها: أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، وتكون له الغلبة؛ لقوله تعالى:
{ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا } يعني يستنصرون . أي يطلبون النصر؛ أو يَعِدون به؛ فقبل نزول القرآن، وقبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون للعرب: إنه سيبعث نبي، وينْزل عليه كتاب، وننتصر به عليكم، ولما جاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به كفروا به..
.5ومنها: أن اليهود لم يخضعوا للحق؛ حتى الذي يقرون به لم يخضعوا له؛ لأنهم كفروا به؛ فيدل على عتوهم، وعنادهم..
.6 . ومنها: أن الكافر مستحق للعنة الله، وواجبة عليه؛ لقوله تعالى: ( فلعنة الله على الكافرين )
.7 . استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز لعن الكافر المعين؛ ولكن لا دليل فيها؛ لأن اللعن الوارد في الآية على سبيل العموم؛ ثم هو خبر من الله عزّ وجلّ، ولا يلزم منه جواز الدعاء به؛ ويدل على منع لعن المعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: “اللهم العن فلاناً، وفلاناً”(1) . لأئمة الكفر، فنهاه الله عن ذلك؛ ولأن الكافر المعين قد يهديه الله للإسلام إن كان حياً؛ وإن كان ميتاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا”(2) ..
.8 ومن فوائد الآيتين: أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بغي، وحسد؛ لقوله تعالى: ( بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده)
.9ومنها: أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلاناً الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ فقد شابه اليهود
.10 ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتْبَعْه من أيٍّ كان مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلان، وفلان..
.11 ومنها: أن العلم من أعظم فضل الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: { أن ينَزِّل الله من فضله على من يشاء }؛ ولا شك أن العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم، وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين؛ الخلفاء السابقون قَلّ ذكرهم؛ والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم: هم يُدَرِّسون الناس وهم في قبورهم؛ وأولئك الخلفاء نُسوا؛ اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة، أو محمودة؛ فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال..
.12 ومن فوائد الآيتين: إثبات مشيئة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: { على من يشاء }؛ وهي عامة فيما يحبه الله، وما لا يحب؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ وكل شيء عُلِّق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة؛ لقوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً} [الإنسان: 30] ؛ فليست أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة؛ بل هي لحكمة بالغة اقتضت المشيئة..
.13 ومن فوائد الآيتين: أن هذا الفضل الذي نزله الله لا يجعل المفضَّل به رباً يُعْبد؛ بل هو من العباد . حتى ولو تميز بالفضل؛ لقوله تعالى: (على من يشاء من عباده ).
وهذه الفائدة لها فروع نوضحها، فنقول: إن من آتاه الله فضلاً من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبداً؛ إذاً لا يرتقي إلى منْزلة الربوبية؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله؛ فلا نقول لمن نزل عليه الوحي: إنه يرتفع حتى يكون رباً يملك النفع، والضرر، ويعلم الغيب..
ويتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله من العلم، وغيره ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره؛ لأن الله تعالى أعطاه من فضله؛ فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلما عظم الإحسان من الله عزّ وجلّ استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: “أفلا أكون عبداً شكوراً(3)” ..
ويتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اغتر بما آتاه الله من العلم، فيتعالى في نفسه، ويتعاظم حتى إنه ربما لا يقبل الحق؛ فحُرِم فضل العلم في الحقيقة..
.14من فوائد الآيتين: أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب جزاءً وفاقاً؛ لقوله تعالى: ( فباءوا بغضب على غضب).
15 . ومنها: أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: { عذاب مهين } بعد أن ترفعوا؛ فعوقبوا بما يليق بذنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه؛ قال الله تعالى: {فكلًّا أخذنا بذنبه} [العنكبوت: 40] ، وقال تعالى: {جزءًا وفاقاً} (النبأ: 26 ).
.16 ومنها: أن الإظهار في موضع الإضمار من أساليب البلاغة، وفيه من الفوائد ما سبق ذكره قريباً..
.17 ومنها: إثبات الغضب من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: { فباءوا بغضب على غضب }؛ والغضب من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ وهكذا كل صفة من صفات الله تكون على سبب..
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:91)
التفسير:
.{ 91 } قوله تعالى: { وإذا قيل لهم } أي لليهود؛ وأبهم القائل ليكون شاملاً لكل من قال لهم هذا القول: إما الرسول صلى الله عليه وسلم وإما غيره؛ { آمنوا بما أنزل الله } أي صدِّقوا به مع قبوله، والإذعان له؛ لأن الإيمان شرعاً: التصديق مع القبول، والإذعان؛ وليس كل من صدق يكون مؤمناً حتى يكون قابلاً مذعناً؛ والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمناً؛ لأنه لم يقبل، ولم يذعن؛ و “ما” اسم موصول؛ المراد به: القرآن العظيم؛ و{ أنزل الله } أي من عنده..
قوله تعالى: { قالوا }: هذا جواب: { إذا }؛ { نؤمن بما أنزل علينا } يعنون به التوراة؛ { ويكفرون بما وراءه} يعنون به القرآن؛ و “وراء” هنا بمعنى سوى؛ { وهو الحق }: هذه الجملة حال من “ما” في قوله تعالى: { بما وراءه } يعني أن هذا الذي كفروا به هو الحق؛ وضده الباطل . وهو الضائع سدىً الذي لا يستفاد منه؛ أما الحق فهو الثابت المفيد النافع؛ وهذا الوصف بلا شك ينطبق على القرآن؛ { مصدقاً }: حال أيضاً من { هو } أي الضمير؛ وسبق معنى كونه مصدقاً لما معهم؛ وقوله تعالى هنا: { لما معهم } يعني التوراة.
ثم قال تعالى مكذباً لقولهم: { نؤمن بما أنزل علينا }: { قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين }؛ الخطاب في { قل } إما للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وإما لكل من يتأتى خطابه؛ { فلم }: اللام حرف جر؛ و “ما” اسم استفهام دخل عليه حرف جر، فوجب حذف ألفها للتخفيف؛ والاستفهام للإنكار، والتوبيخ؛ يعني لو كنتم صادقين بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله؛ لأن قتلهم لأنبياء الله مستلزم لكفرهم بهم . أي بأنبياء الله؛ { من قبل } أي من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم
وقوله تعالى: { أنبياء } فيها قراءتان: { أنبئاء } بالهمزة؛ و{ أنبياء } بالياء، مثل: “النبي” ، و “النبيء” ؛ و”النبيء” جمعه أنبئاء؛ و”النبي” جمعه أنبياء.
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: { آمنوا بما أنزل الله }؛ لأن ما أنزل الله هو القرآن . وهو كلام؛ والكلام ليس عيناً قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في غيره، وهو نازل من عند الله لزم أن يكون كلام الله عزّ وجلّ..
.2 ومنها: علوّ الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كان القرآن كلامه، وهو نازل من عنده دلَّ على علوّ المتكلم به
.3 ومنها: كذب اليهود في قولهم: { نؤمن بما أنزل علينا }؛ لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر…} [الأعراف: 157] إلخ..
.4 ومنها: عتوّ اليهود، وعنادهم؛ لأنهم يقولون: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا..
.5 ومنها: أن من دُعي إلى الحق من هذه الأمة، وقال: “المذهب كذا، وكذا” . يعني ولا أرجع عنه ففيه شبه من اليهود . لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: “سمعنا وأطعنا”؛ ولا تعارضه بأي قول كان، أو مذهب..
.6 ومنها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به..
.7 ومنها: إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ ووجه ذلك أن الله أقام على اليهود الحجة على فعلهم؛ لأنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم؛ فإن قولهم: { نؤمن بما أنزل علينا } ليس بحق؛ لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا الأنبياء؛ ولهذا قال تعالى: ( قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ).
(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) (البقرة:92)
التفسير:
.{ 92 } قوله تعالى: { ولقد جاءكم موسى }: الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم . وهي للتوكيد؛ و “قد” وهي هنا للتحقيق؛ لأنها دخلت على الماضي؛ و{ جاءكم }: الخطاب لليهود؛ والدليل على أنه لليهود قوله تعالى: { موسى }؛ لأن موسى نبيهم؛ وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم يأت هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أتى بني إسرائيل الذين هؤلاء منهم..
قوله تعالى: { بالبينات }: الباء للمصاحبة، أو للتعدية؛ يعني: جاءكم مصحوباً بالبينات؛ أو أن البينات هي التي جيء بها، فتكون للتعدية؛ و “البينات” صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: بالآية البينات . أي بالعلامات الدالة على رسالته؛ ومنها: اليد، والعصا، والحجر، وفلق البحر، والجراد الذي أرسل على آل فرعون، والسنون، وأشياء كثيرة، مثل القمل، والضفادع، والدم..
قوله تعالى: { ثم }: تفيد الترتيب بمهلة . يعني ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآية، وأن تعرفوها: الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأساً: { اتخذتم العجل }: “اتخذ” من أفعال التصيير، كقوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلًا} [النساء: 125] يعني صيَّره؛ إذاً هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ، والخبر؛ المفعول الأول: { العجل }؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهاً؛ وحذف للعلم به، كما قال ابن مالك في الألفية:.
وحذف ما يعلم جائز و{ العجل } هو ولد البقرة، وليس عجلاً من حيوان؛ ولكنه عجل من حلي: صنعوا من الحلي مجسماً كالعجل، وجعلوا فيه ثقباً تدخله الريح، فيكون له صوت كخوار الثور، فأغواهم السامري، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي؛ لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه ثلاثون يوماً، فزاد الله تعالى عشراً، فصار أربعين يوماً؛ فقال لهم السامري: إن موسى ضلّ عن إلهه؛ ولهذا تخلف، فلم يرجع؛ فهو قد ضلّ، ولم يهتد إلى إلهه؛ فهذا إلهكم، وإله موسى، فاتَّخِذوه إلهاً..
قوله تعالى: { من بعده } أي من بعد ذهاب موسى لميقات ربه؛ لأن موسى رجع إليهم، وقال للسامري عن إلهه: {لنحرقنه ثم لننسفنَّه في اليم نسفاً} [طه: 97] ؛ وجرى هذا: فحرقه موسى صلى الله عليه وسلم، ونسفه في البحر..
قوله تعالى: { وأنتم ظالمون } أي معتدون؛ وأصل الظلم النقص، كما في قوله تعالى: {كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً} [الكهف: 33] ؛ وسمي العدوان ظلماً؛ لأنه نقص في حق المعتدى عليهم؛ وجملة: { وأنتم ظالمون } حال في موضع النصب من فاعل { اتخذتم } أي والحال أنكم ظالمون؛ وهذا أبلغ في القبح: أن يعمل الإنسان العمل القبيح وهو يعلم أنه ظالم..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: إقامة البرهان على عناد اليهود؛ ووجه ذلك أنه قد جاءهم موسى بالبينات، فاتخذوا العجل إلهاً..
2 . ومنها: سفاهة اليهود، وغباوتهم، لاتخاذهم العجل إلهاً مع أنهم هم الذين صنعوه..
.3 ومنها: أن اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى مما يدل على هيبتهم له؛ لقوله تعالى: { من بعده } يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه..
.4 ومنها: أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم، وليس عن جهل؛ لقوله تعالى: ( وأنتم ظالمون )
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:93)
التفسير:
.{ 93 } قوله تعالى: { وإذ أخذنا ميثاقكم }: { إذ } تأتي في القرآن كثيراً؛ والمعربون يعربونها بأنها مفعول لفعل محذوف؛ تقديره: اذكر؛ وإذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر: اذكروا، أي اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم؛ و “الميثاق” : العهد؛ وسمي العهد ميثاقاً؛ لأنه يتوثق به..
قوله تعالى: { ورفعنا فوقكم الطور } وهو الجبل المعروف؛ رفعه الله عزّ وجلّ على رؤوسهم تهديداً لهم؛ فجعلوا يشاهدونه فوقهم كأنه ظلة؛ فسجدوا خوفاً من الله عزّ وجلّ، وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بكشف كربتهم؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم عن اليهود أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون لله بها أن يسجدوا وقد أداروا وجوههم إلى السماء؛ يقولون: هذه السجدة أنجانا الله بها؛ فهي أشرف سجدة عندنا..
قوله تعالى: { خذوا } فعل أمر؛ وهو في محل نصب مقولاً لقول محذوف . أي: قلنا: خذوا . { ما أتيناكم } أي ما أعطيناكم؛ والمراد به التوراة { بقوة } أي بجدٍّ، ونشاط؛ فالجد: العزيمة الثابتة؛ والنشاط: القوة في التنفيذ؛ { واسمعوا } أي سماع قبول، واستجابة؛ فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة، وأن يسمعوا، ويستجيبوا، وينقادوا؛ وكان الجواب: { قالوا سمعنا } أي بآذاننا؛ { وعصينا } أي بأفعالنا؛ فما سمعوا السمع الذي طُلب منهم؛ ولكنهم استكبروا عنه؛ وظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظاً: { سمعنا وعصينا }؛ وقال بعضهم: قالوا: { سمعنا } بألسنتهم، وعصوا بأفعالهم؛ فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم، وأنهم لم يقولوا بألسنتهم: { وعصينا }؛ وهذا ضعيف؛ لأن الواجب حمل اللفظ على ظاهره حتى يقوم دليل صحيح على أنه غير مراد، ولأنه لا يمتنع أن يقولوا: “سمعنا وعصينا” بألسنتهم وهم الذين قالوا لموسى: {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} [البقرة: 55] ؛ فالذين تجرأوا أن يقولوا: {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} يتجرءون أن يقولوا: { سمعنا وعصينا } بألسنتهم؛ وكأن الذين قالوا: إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية؛ وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم: { وعصينا } كأنهم قالوا: إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم؛ ومن كان هذه حاله لا يمكن أن يقول: “سمعنا، وعصينا” والجبل فوقه؛ ويمكن الجواب عن هذا بأنهم قالوا ذلك بعد أن فُرِّج عنهم؛ و”العصيان”: هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور، أو فعل المحظور؛ فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاصٍ؛ ومن زنى، أو سرق، أو شرب الخمر فهو أيضاً عاصٍ لله. ورسوله..
قوله تعالى: { وأُشربوا في قلوبهم العجل }: قال بعضهم: إنه على تقدير مضاف؛ والتقدير: أشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب في القلب؛ ومعنى { أشربوا }: أنه جُعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب؛ إذاً امتزج بالقلب كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه؛ والمدر هو الطين اليابس؛ فهذا القلب أشرب فيه حب العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه؛ لأنه أبلغ؛ فكأن نفس العجل دخل في قلوبهم؛ والذي أشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى؛ ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالباً بالبناء لما لم يسم فاعله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “والشر ليس إليك”(1) ، وقال الله تعالى عن الجن: {وأنَّا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً} [الجن: 10] ؛ ففي الشر قالوا: {أريد} ، ولم ينسبوه إلى الله؛ أما الرشد فنسبوه إلى الله عزّ وجلّ..
قوله تعالى: { بكفرهم }: الباء هنا للسببية؛ أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل؛ لأنهم قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه؛ فصاروا كفاراً به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه: قال لهم هارون صلى الله عليه وسلم {يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري} [طه: 90] ؛ ولكن كان جوابهم لهارون: {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} [طه: 91] ؛ فأصروا؛ لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم..
قوله تعالى: { قل }: يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه . أي قل أيها النبي؛ أو قل أيها المخاطب؛ { بئسما يأمركم به إيمانكم }: “بئس” فعل ماض يراد به إنشاء الذم؛ و “ما” نكرة مبنية على السكون في محل نصب تمييز، يعني: بئس شيئاً يأمركم به إيمانكم عبادةُ العجل؛ يعني: إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم فإن إيمانكم قد أمركم بأمر قبيح؛ يعني: أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل؟! وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل، وعبدتموه..
قوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين } أي صادقين في دعوى الإيمان؛ و{ إن } شرطية، والمقصود بها التحدي؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح!!!.
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان؛ لقوله تعالى: { وإذ أخذنا ميثاقكم… } إلخ..
.2ومنها: أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور..
.3 ومنها: بيان قدرة الله عزّ وجلّ..
.4 ومنها: أن أمر الكون كله بيد الله عزّ وجلّ، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات؛ لقوله تعالى: { ورفعنا فوقكم الطور..
.5 ومنها: وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور، لقوله تعالى: { خذوا ما آتيناكم بقوة }..
.6 ومنها: بيان عتوّ بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: { قالوا سمعنا وعصينا }؛ وهذا أبلغ ما يكون في العتوّ؛ لأنه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: { سمعنا وعصينا }..
.7 ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابة، وسمع إدراك؛ مثال الأول: { خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا }؛ ومثال الثاني: ( سمعنا وعصينا )
.8 ومنها: أن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه بالمعاصي؛ لقوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين } يعني إن كنتم مؤمنين حقاً ما اتخذتم العجل إلهاً..
.9 ومنها: أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه؛ بل يذكره بصيغة المبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ لقوله تعالى: { وأشربوا في قلوبهم }؛ ولهذا نظير من القرآن، كقوله تعالى: {وأنَّا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً} [الجن: 10] ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “والشر ليس إليك”(1) ؛ فالشر في المفعول. لا في الفعل؛ الخير والشر كل من خلْق الله عزّ وجلّ؛ لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خير، وليس بشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة، وغاية محمودة . وإن كان شراً . لكن الشر في المفعولات. أي المخلوقات؛ وأما نفس الفعل فهو ليس بشر؛ أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار . والنار مؤلمة محرقة . لكنه يريد أن يُشفى . فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة . وهو شفاء الولد؛ فيكون خيراً باعتبار غايته..
.10 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد يبتلي العبد، فيملأ قلبه حباً لما يكرهه الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى:
( وأشربوا في قلوبهم العجل ).
.11 ومنها: أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله؛ لقوله تعالى: ( قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين).
(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (البقرة:95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (البقرة:96)
التفسير:
.{ 94 . 95 } قوله تعالى: { قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس }: { كانت } هنا ناقصة، وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى: { لكم }؛ وتكون { خالصة } حالاً من { الدار } . يعني: حال كونها خالصة من دون الناس؛ ويجوز أن يكون الخبر: { خالصة }؛ والمعنى واحد؛ والمراد بـ{ الدار الآخرة } الجنة؛ وإنما قال تعالى ذلك؛ لأنهم قالوا: “لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة، وبعدها تخلفوننا أنتم في النار؛ ونكون نحن في الجنة” . هذا كلام اليهود؛ والذي يقول هذا الكلام يدعي أن الدار الآخرة خالصة . أي خاصة . له من دون الناس، وأن المستحق للنار منهم يدخلها أياماً معدودة، ثم يخرج إلى الجنة..
قوله تعالى: { فتمنوا الموت } أي اطلبوا حصوله { إن كنتم صادقين } أي في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس؛ لأنها حينئذٍ تكون لكم خيراً من الدنيا؛ فتمنوا الموت لتصلوا إليها؛ وهذا تحدٍّ لهم؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: { ولن يتمنوه أبداً }؛ وفي سورة الجمعة قال تعالى: {ولا يتمنونه أبداً} [الجمعة: 7] وذلك؛ لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار الآخرة خالصة..
وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون فليتمنوا الموت لِيَصِلوا إليها؛ وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة؛ وهو الذي رجحه ابن جرير، وكثير من المفسرين؛ وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله تعالى: { فتمنوا الموت } أي فباهلونا، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا؛ فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: {فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} [آل عمران: 61] ؛ فيكون المعنى: تمنوا الموت عن طريق المباهلة؛ ورجح هذا ابن كثير؛ وضعف الأول بأنه لو كان المراد: تمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضاً علينا نحن، ويقولون: أنتم أيضاً إن كنتم تقولون: إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضاً تقولون: إن الدار الآخرة لكم، وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في النار؛ فتمنوا الموت أنتم أيضاً، والجواب عن ذلك أنا لم ندع أن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير . رحمه الله . مخالف لظاهر السياق؛ فلا يعوَّل عليه؛ وقد عرفت الانفكاك منه..
.{ 96 } قوله تعالى: { ولتجدنهم أحرص الناس على حياة }؛ اللام في { لتجدنهم } موطئة للقسم؛ والنون للتوكيد؛ وعليه تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، والنون؛ والضمير الهاء يعود على اليهود؛ و{ أحرص } اسم تفضيل؛ و “الحرص” هو أن يكون الإنسان طامعاً في الشيء مشفقاً من فواته؛ والحرص يستلزم بذل المجهود؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم “احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز”(1) ؛ ونكر { حياة } ليفيد أنهم حريصون على أيّ حياة كانت . وإن قلّت؛ حتى لو لم يأتهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليها..
قوله تعالى: { ومن الذين أشركوا } أي الشرك الأكبر؛ واختلف المفسرون فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف، والكلام منقطع عما قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر…؛ وهذا وإن كان محتملاً لفظاً، لكنه في المعنى بعيد جداً؛ ومنهم من قال: إنه معطوف على قوله تعالى: { الناس } يعني: ولتجدنهم أحرص الناس، وأحرص من الذين أشركوا؛ يعني: اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث، وبالجنة، وبالنار؛ والمشركون لا يؤمنون بذلك، والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياة؛ لأنه يرى أنه إذا مات انتهى أمره، ولا يعود؛ فتجده يحرص على هذه الحياة التي يرى أنها هي رأس ماله؛ وهذا القول هو الصواب..
قوله تعالى: { يود أحدهم لو يعمر ألف سنة }؛ “الود” خالص المحبة؛ والضمير في { أحدهم } يعود على المشركين لا غير . على القول الأول: أي أن قوله تعالى: { ومن الذين أشركوا } مستأنف؛ وعلى القول الثاني: يحتمل أن يكون الضمير عائداً على اليهود؛ ويصير انقطع الكلام عند قوله تعالى: { أشركوا }؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشركين؛ ويرجحه أمران:.
أحدهما: أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مذكور؛ والمشركون هنا أقرب..
والثاني: أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة، وكان اليهودي أحرص منه على الحياة، فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة..
وقوله تعالى: { لو يعمر } أي لو يزاد في عمره؛ و”العمر” هو الحياة؛ و{ لو } هنا مصدرية؛ وكلما جاءت بعد “ود” فهي مصدرية، كما في قوله تعالى: {ودوا لو تدهن فيدهنون} [الأحزاب: 20] ، وقوله تعالى:
{ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب } [يونس: 87] ؛ ومعنى “مصدرية” أنها بمعنى “أنْ” تؤول، وما بعدها بمصدر، فيقال في الآية . { يود أحدهم لو يعمَّر ألف سنة }: يود أحدهم تعميره ألف سنة؛ و “السنة” هي العام؛ والمراد بها هنا السنة الهلالية . لا الشمسية . لأن الكلمات إذا أطلقت تحمل على الاصطلاح الشرعي؛ وقد قال الله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم} [التوبة: 36] ؛ فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، كما قال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] ، وكما قال تعالى في القمر: {وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب} [يونس: 5] ..
قوله تعالى: { وما هو بمزحزحه من العذاب } أي بدافعه، ومانعه؛ { أن يعمر }: { أن }، والفعل بعدها فاعل “زحزح” ؛ والتقدير: وما هو بمزحزحه تعميره؛ لأن “مزحزح” اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ والمعنى أنه لو عُمِّر ألف سنة، أو أكثر وهو مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن يزحزحه من العذاب؛ بل إن الإنسان إذا ازداد عمره وهو في معصية الله ازداد عذابه؛ ولهذا جاء في الحديث: “شرُّكم من طال عمره، وساء عمله”(1).
قوله تعالى: { والله بصير بما يعملون }: { بصير } هنا بمعنى عليم؛ أي أنه جَلَّ وعلا عليم بكل ما يعملونه في السر، والعلانية من عمل صالح، وعمل سيء..
الفوائد:
.1 من فوائد الآيات: تكذيب اليهود الذين قالوا: “لنا الآخرة، ولكم الدنيا، لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة”؛ ووجهه: أن الله تعالى قال لهم: { فتمنوا الموت }، وقد قال تعالى: { ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم
2 . ومنها: أنَّ الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة؛ لقوله تعالى: ( بما قدمت أيديهم ).
.3 ومنها: إثبات السببية . تؤخذ من الباء في قوله تعالى: ( بما قدمت أيديهم ).
.4 منها: إثبات علم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى: { ولن يتمنوه أبداً }؛ فوقع الأمر كما أخبر به..
.5 ومنها: جواز تخصيص العموم لغرض؛ لقوله تعالى: { والله عليم بالظالمين } فخص علمه بالظالمين تهديداً لهم..
.6 ومنها: أن اليهود أحرص الناس على حياة..
.7 ومنها: إبطال قولهم: “لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة”، ثم يخرجون منها، ويكونون في الجنة؛ لأن من كان كذلك لا يكره الموت..
.8 ومنها: أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ لقوله تعالى: { أحرص }؛ و{ أحرص } اسم تفضيل
.9 ومنها: أن المشركين من أحرص الناس على الحياة، وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: { ومن الذين أشركوا } مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود..
10 . ومنها: أن طول العمر لا يفيد المرء شيئاً إذا كان في معصية الله؛ لقوله تعالى: ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ).
.11 ومنها: غَوْرُ فهم السلف حين كرهوا أن يُدْعَى للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان: “أطال الله بقاءك”؛ لأن طول البقاء قد ينفع، وقد يضر؛ إذاً الطريق السليم أن تقول: “أطال الله بقاءك على طاعة الله”، أو نحو ذلك..
.12 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء كغيرهم؛ لقوله تعالى: { والله بصير بما يعملون }؛ والبصر هنا بمعنى العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم “لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”(1) ؛ فأثبت لله بصراً؛ لكن تفسيره بالعلم أعم..
(1) أخرجه البخاري ص333، كتاب المغازي، باب 22: (ليس لك من الأمر شيء)، حديث رقم 4069.
(2) أخرجه البخاري ص109، كتاب الجنائز، باب 97: ما ينهى من سب الأموات، حديث رقم 1393.
(3) أخرجه البخاري ص88، كتاب التهجد، باب 6: قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، حديث رقم 1130؛ وأخرجه مسلم ص1169، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب 18: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، حديث رقم 7124 [79] 2819.
(1) أخرجه مسلم ص800، كتاب صلاة المسافرين، باب 26: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودائه بالليل، حديث رقم 1812 [201] 771.
(1) سبق تخريجه ص304.
(1) سبق تخريجه ص163.
(1) أخرجه أحمد 5/40، حديث رقم 20686؛ وأخرجه الترمذي ص1886، كتاب الزهد، باب 22: أي الناس خير وأيهم شر، حديث رقم 2330؛ مدار الحديث على عليّ بن زيد، قال الحافظ في التقريب: ضعيف، وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح بما قبله 2/271، حديث رقم 1899.
(1) أخرجه مسلم ص709، كتاب الإيمان، باب 79: في قوله عليه السلام: “إن الله لا ينام”…، حديث رقم 442 [293] 179.