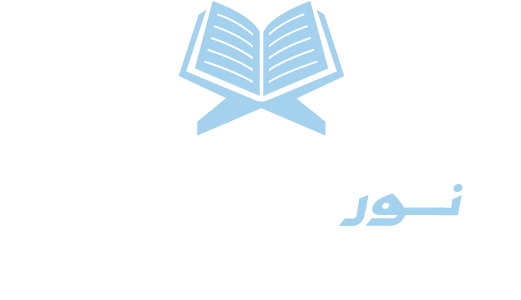ففي قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا}: إخلاص النية، وفي قوله: {وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}: تحقيق العمل، وقوله: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} أي: لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية.
* ثم قال في الأنصار: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩]؛ فوصفهم الله بأوصاف ثلاث: {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ}، {وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا} {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.
* ثم قال تعالى بعد ذلك: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الآية [الحشر: ١٠]:، وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة؛ فقد أثنوا عليهم بالأخوة، وبأنهم سبقوهم بالإيمان، وسألوا الله أن لا يجعل في قلوبهم غلًّا لهم؛ فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم؛ فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا}.
ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة؛ قالت: لا تعجبون! هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم، فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم (١)!!
وقوله: {وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا}، ولم يقل: للذين سبقونا بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة.
* {رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}: ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
* * *
* قوله: “وطاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله: “لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه” (رواه البخاري ومسلم) “.
* “طاعة”: معطوف على قوله: “سلامة”؛ أي: من أصول أهل السنة والجماعة: طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – … إلخ.
* السب: هو القدح والعيب؛ فإن كان في غيبة الإنسان؛ فهو غيبة.
* وقوله: “أصحابي”؛ أي: الذين صحبوه، وصحبة النبي – صلى الله عليه وسلم – لا شك أنها تختلف: صحبة قديمة قبل الفتح، وصحبة متأخرة بعد الفتح.
والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد
حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة في بني جذيمة، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لخالد: “لا تسبوا أصحابي”، والعبرة بعموم اللفظ.
ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام، لهذا قال: “لا تسبوا أصحابي”؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله.
وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك بالنسبة لمن بعدهم.
* وقوله: “فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا … “ إلخ.
* أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق البار بدون قسم: “لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”.
* “أحد”: جبل عظيم كبير معروف في المدينة.
* والمد: ربع الصاع.
* “ولا نصيفه”؛ أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن، وقال بعضهم: من الذهب؛ بقرينة السياق؛ لأنه قال: “لو أنفق مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”، يعني: من الذهب.
وعلى كل حال؛ فإن قلنا: من الطعام؛ فمن الطعام، وإن
قلنا: من الذهب، فليكن من الذهب، ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء.
* فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والإنفاق واحد، والمنفَق واحد، والمنفَق عليه واحد، وكلهم بشر، لكن لا يستوي البشر بعضهم مع بعض، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم؛ فلإخلاصهم العظيم، واتباعهم الشديد، كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون.
* وهذا النهي يقتضي التحريم؛ فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدًا منهم على الخصوص؛ فإن سبهم على العموم، كان كافرًا، بل لا شك في كفر من شك في كفره، أما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء خَلْقية أو خُلُقية أو دينية، ولكل واحد من ذلك حكمه.
* * *
* قوله: “ويقبلون”؛ أي: أهل السنة.
* قوله: “ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم”:
* الفضائل: جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد
منقبة له.
* والمراتب: الدرجات؛ لأن الصحابة درجات ومراتب؛ كما سيذكرهم المؤلف رحمه الله.
* فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم؛ فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك:
– فمثلًا يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير ذلك من الفضائل.
– ويقبلون مثلًا ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حث على الصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله (رواه أبو داود)، وهذه فضيلة.
– ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في هجرته في الغار.
– ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: “إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر” (رواه البخاري ومسلم).
– وكذلك ما جاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم، وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل؛ يقبلون هذا كله.
– وكذلك المراتب، فيقبلون ما جاء في مراتبهم؛ فالخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأعلاهم مرتبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي؛ كما سيذكره المؤلف.
* * *
* قوله: “ويفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل”:
* ودليل ذلك قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: ١٠].
فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.
* فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟
فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم؛ كأن نرجع إلى “الإصابة في تمييز الصّحابة” لابن حجر أو “الاستيعاب في معرفة الأصحاب” لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في الصّحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد.
وقول المؤلف: “وهو صلح الحديبية”:
– هذا أحد القولين في الآية، وهو الصَّحيح، ودليله قصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف، وقول البراء بن عازب: تعدون أنتم الفتح فتح مكّة، وقد كان فتح مكّة فتحًا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. رواه البُخاريّ .
– وقيل: المراد فتح مكّة، وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم (الدر المنثور 6/58).
* * *
* قوله: “ويقدمون المهاجرين على الأنصار”:
– المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – قبل فتح مكّة.
– والأنصار هم الذين هاجر إليهم النَّبيُّ – صَلَّى الله عليه وسلم – في المدينة.
* وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأنَّ المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار أتوا بالنصرة فقط.
– فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم، وتركوا أوطانهم، وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله
ورسوله، ونصرة لله ورسوله.
– والأنصار أتاهم النَّبيُّ – صَلَّى الله عليه وسلم – في بلادهم، ونصروا النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أنهم منعوه ممَّا يمنعون منه أبناءهم ونساءهم.
ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: ١٠٠]؛ فقدم المهاجرين على الأنصار، وقوله: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: ١١٧]؛ فقدم المهاجرين، وقوله في الفيء: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. . .} [الحشر: ٨]، ثم قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: ٩].
* * *
* قوله: “ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر-: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم”.
* أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصّحابة.
* وبدر مكان معروف، كانت فيه الغزوة المشهورة، وكانت في السنة الثَّانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان.
* وسببها أن النَّبيَّ – صَلَّى الله عليه وسلم – سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكّة، فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط، فانتدب منهم ثلاث مئة وبضعة عشر رجلًا، معهم سبعون بعيرًا وفرسان،
وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالًا، لكن الله عزَّ وجلَّ بحكمته جمع بينهم وبين عدوهم.
فلما سمع أبو سفيان بذلك، وأن الرسول عليه الصَّلاة والسلام خرج إليه لتلقي العير؛ أخذ بساحل البحر، وأرسل صارخًا إلى أهل مكّة يستنجدهم، فانتدب أهل مكّة لذلك، وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم، خرجوا على الوصف الذي ذكر الله عزَّ وجلَّ: {بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ} [الأنفال: ٤٧].
وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فتآمروا بينهم في الرجوع، لكن أبا جهل قال: والله؛ لا نرجع حتى نقدم بدرًا، فنقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبدًا!!
وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس، ولكن -ولله الحمد- كان الأمر على عكس ما يقول؛ سمعت العرب بهزيمتهم النكراء، فهانوا في نفوس العرب!!
قدموا بدرًا، والتقت الطائفتان، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة: {أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ} [الأنفال: ١٢ – ١٤].
حصل اللقاء بين الطائفتين، وكانت الهزيمة -ولله الحمد-
على المشركين، والنصر المبين للمؤمنين، انتصروا، وأسروا منهم سبعين رجلًا، وقتلوا سبعين رجلًا، منهم أربعة وعشرون رجلًا من كبرائهم وصناديدهم؛ سُحبوا، فأُلقوا في قليب من قُلب بدر خبيثة قبيحة.
* ثم إن النَّبيَّ – صَلَّى الله عليه وسلم – بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيَّام ركب ناقته، ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: “يا فلان ابن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًّا”. فقالوا: يا رسول الله! ما تُكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: “والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم” (١).
والنبي عليه الصَّلاة والسلام وقف عليهم توبيخًا وتقريعًا وتنديمًا، وهم قد وجدوا ما وعد الله حقًّا؛ قال الله تعالى: {ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ} [الأنفال: ١٤]؛ فوجدوا النَّار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق، ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد.
* فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله – صَلَّى الله عليه وسلم – وأصحابه، وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم، وقال: “اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم” (رواه مسلم)؛ فكل ما يقع منهم من ذنوب؛ فإنَّه مغفور؛ لهم؛ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديهم.
* وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم؛ فهو مغفور لهم.
* وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم، وهذا يقتضي أحد أمرين:
– إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك.
– وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام.
وأيًّا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم، ولم نعلم أن أحدًا منهم كفر بعد ذلك.
* * *
* قوله: “وبأنه لا يدخل النَّار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخبر به النَّبيُّ – صلى الله عليه وسلم -، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا
أكثر من ألف وأربع مئة” (رواه البخاري).
* أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان.
* وسبب هذه البيعة أن النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم – خرج من المدينة إلى مكّة يريد العمرة، ومعه أصحابه والهدي، وكانوا نحو ألف وأربع مئة رجل، لا يريدون إلَّا العمرة، فلما بلغوا الحديبية، وهي مكان قرب مكّة، في طريق جدة الآن، بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وعلم بذلك المشركون؛ منعوا رسول الله – صَلَّى الله عليه وسلم – وأصحابه؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت، {وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إلا الْمُتَّقُونَ} [الأنفال: ٣٤]، وجرت بينهم وبينهم مفاوضات.
وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصَّلاة والسلام بركت وأبت أن تسير، حتَّى قالوا: “خلأت القصواء“؛ يعني: حرنت وأبت المسير. فقال النَّبيُّ – صلى الله عليه وسلم – مدافعًا عنها: “والله؛ ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل“. ثم قال: “والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلَّا أعطيتهم إياها” (رواه البخاري).
جرى التفاوض، وأرسل النَّبيُّ – صَلَّى الله عليه وسلم – عثمان بن عفَّان، لأنَّ له رهطًا بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكّة، يدعوهم إلى الإسلام، ويخبرهم أن النَّبيَّ – صَلَّى الله عليه وسلم – إنما جاء معتمرًا معظمًا للبيت، فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل، وكبُر ذلك على المسلمين، فدعا النَّبيُّ – صَلَّى الله عليه وسلم – إلى البيعة، يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول رسول الله – صَلَّى الله عليه وسلم -، وكانت الرسل لا تقتل، فبايع الصّحابة رضي الله عنهم النَّبيَّ – صَلَّى الله عليه وسلم – على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت. 2/262