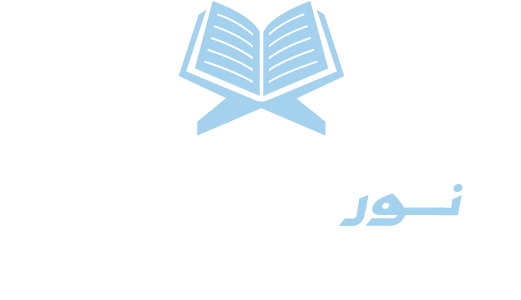فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية، أو إن شئت، فقل: مثبتة ومنفية، والمعنى واحد.
فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية، أو إن شئت، فقل: مثبتة ومنفية، والمعنى واحد.
فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسه، وكلها صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالاً على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص.
وإذا فهمنا هذه القاعدة، عرفنا ضلال أهل التحريف، الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فراراً من التمثيل.
ومثاله: قالوا: لو أثبتنا لله وجهاً، لزم أن يكون مماثلاً لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي.
فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات، فهو صفة كمال ولا يمكن أبداً أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص.
ولكن، إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء، أو هي اجتهادية، لمعنى أن يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه؟.
فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم، كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه.
وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمالمطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق.
أما صفة الكمال على الإطلاق، فهي ثابتة لله عز وجل، كالمتكلم، والفعال لما يريد، والقادر .. ونحو ذلك.
وأما صفة الكمال بقيد، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيداً، مثل: المكر، والخداع، والاستهزاء .. وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فلا تصح بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة.
وأما صفة النقص على الإطلاق، فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله بها وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء: 142]، فأثبت خداعه لمن خادعه لكن قال في الخيانة: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ} [الأنفال: 71] ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، وليس فيه مدح أبداً.
فإذاً، صفات النقص منفية عن الله مطلقاً.
والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال ويكونالله عز وجل قد أتصف بمدلولها، فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء، فهي صفة كمال مثبته لله على سبيل الإطلاق، وهذه تجعلها قسماً منفصلاً، لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرها، ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيراً، وقد يكون شراً، وقد لا يكون خيراً ولا شراً، فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله، لأنه سفه، والخير ينسب إليه، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180]، ليس فيها أي شيء من النقص ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق.
إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة مادمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟
فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة:
الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم، فهو متضمن لصفة ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها.
الطريق الثاني: أن ينص على الصفة، مثل الوجه، واليدين، والعينين … وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله عز وجل، ومثل الانتقام، فقال عنه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [إبراهيم: 47]، ليس من أسماء الله المنتقم، خلافاً لما يوجد في بعضالكتب التي فيها عد أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيداً، كقوله: {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: 22].
الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل، مثل: المتكلم، فأخذها من {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} [النساء: 164].
هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة, وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم.
وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل، فكثيرة ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت، ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيراً عامة، غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها.
فالقسم الأول العامة، كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته .. وغير ذلك من صفاته، فلم يفصل، بل قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} في كل كمال.أما إذا كان مفصلاً، فلا تجده إلا لسبب، كقوله {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: 91]، رداً لقول من قال: إن لله ولداً وقوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3] كذلك وقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38]، لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام، فسيلحقه التعب، فقال: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38]، أي: من تعب وإعياء.
فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات، ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، فقوله {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ}: متضمن كمال القوة والقدرة وقوله: {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} [الكهف: 49]: متضمن لكمال العدل وقوله: {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 85]: متضمن لكمال العلم والإحاطة .. وهلم جراً، فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي وإلا، لم تكن مدحاً.
لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد لأن النفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحاً ولا ثناء، ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذماً، وقد يكونلعدم القابلية، فلا يكون مدحاً ولا ذماً.
مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر :القائل هو النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو, ” الشعر والشعراء” (1/ 288)
قبيلة لا يغدرون بذمة … ولا يظلمون الناس حبة خردل
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدرانا لا يظلم أحداً.
والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا.
هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي، أما الأسماء فكلها مثبتة.
لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي، ومنها ما يدل على معني سلبي، وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله.
فمثال التي مدلولها إيجابي كثير.
ومثال التي مدلولها سلبي: السلام. ومعنى السلام، قال العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً، فمدلوله سلبي، بمعنى: ليس فيه نقص ولا عيب، وكذلك القدوس قريب من معنى السلام، لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب.
فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة وهو لا يريد بالنسبةللأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية.
* قوله: “فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون؛ فإنه الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”.
الشرح:
قوله: “فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون“: العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل.
وإنما جاء المؤلف بهذا النفي، ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماماً، وغير منحرفين إطلاقاً، عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار.
وقوله: “عما جاء به المرسلون”: ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والواضح أننا لا نعدل عنه، لأنه خاتم النبيين، وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره، هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف،لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ، لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به.
مثلاً: قال موسى لفرعون لما قال له: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى} [طه: 51 – 52]، فنفى عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك، لأنه جاء به رسول من الله {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 49 – 50]، فلو سألنا سائل: من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه؟ فنقول: من كلام موسى، فنؤمن بذلك، ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به، فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقرة على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه، فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه، فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، ولكن لا تدخر الحب كما هو، بل تقطم رؤوسه، لئلا ينبت، لأنه لو نبت، لفسد عليها، وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور، فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة، بل تنشره خارج جحرها حتى ييبس من الشمس والريح، ثم تدخله!
لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، لاحتمال أن يكون كذباً، كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى. وقوله رحمه الله: “عما جاء به المرسلون” هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات، فيختص بالأخبار؟إن نظرنا إلى عموم اللفظ، قلنا: يشمل الأخبار والأحكام.
وإن نظرنا إلى السياق، قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار.
ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصاً بالعقائد، فهو خاص، وليس لنا فيه كلام. وإن كان عاماً، فهو يشمل الأحكام.
والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها، أو ليست أحكاماً لنا؟
والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام، فهو لنا، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه، فهو على خلافه، فمثلاً: السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، لكن في شريعتنا محرم، كذلك الإبل حرام على اليهود: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: 146] ولكن هي في شريعتنا حلال.
فإذاً، يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام، فهو لنا، إلا بدليل.
ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياءالسابقين؟
نقول: لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب، والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين، فهو ثابت وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فهو أيضاً ثابت.
والباقي لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب، فإننا نصدقه، لا لنقلهم، ولكن لما جاء في شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب، فإننا نكذبه، لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله، فنقول: هذا كذب، واليهود يقولون: عزير ابن الله، فنقول: هذا كذب.
قوله رحمه الله: “فإنه الصراط المستقيم”: (فإنه): الضمير يعود على ما جاءت به الرسل ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه، فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه، فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: هو الصراط المستقيم.
(صراط): على وزن فعال، بمعنى: مصروط، مثل: فراش، بمعنى: مفروش، وغراس، بمعنى: مغروس، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطرق الواسع المستقيم مأخوذ من الزرط وهو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعاً، لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه، فالصراط يقولون في تعريفه: كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج.