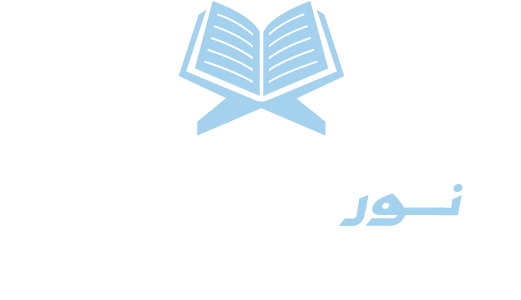لم يذكر الله مصرف الإنفاق أين يكون؛ لكنه تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير إسراف، ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً} [الفرقان: 67] ..
.7ومن فوائد الآية: أن من أوصاف المتقين الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله.
.8 ومنها: أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق بيانه في التفسير..
.9 ومنها: أهمية الإيمان بالآخرة؛ لأن الإيمان بها هو الذي يبعث على العمل؛ ولهذا يقرن الله تعالى دائماً الإيمان به عزّ وجلّ، وباليوم الآخر؛ أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على العمل؛ إنما يعمل لدنياه فقط: يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه: يسرق مثلاً؛ يتمتع بشهوته؛ يكذب؛ يغش…؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة؛ فالإيمان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل..
.10 ومنها: سلامة هؤلاء في منهجهم؛ لقوله تعالى: ( أولئك على هدًى من ربهم ).
.11ومنها: أن ربوبية الله عزّ وجلّ تكون خاصة، وعامة؛ وقد اجتمعا في قوله تعالى عن سحرة فرعون: {آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون} (الأعراف: 121، 122)
.12 ومنها: أن مآل هؤلاء هو الفلاح؛ لقوله تعالى: ( وأولئك هم المفلحون )
.13 ومنها: أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذُكر؛ فإن اختلَّت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات؛ لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة، والذي دلّ عليه العقل والنقل، أن الإيمان يزيد، وينقص، ويتجزأ؛ ولولا ذلك ما كان في الجنات درجات: هناك رتب كما جاء في الحديث: “إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق؛ قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا؛ والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين” ، أي ليست خاصة بالأنبياء..
القـرآن
)إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (البقرة:6) )خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة:7)
التفسير:
ثم ذكر الله قسماً آخر . وهم الكافرون الخلَّص .؛ ففي هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الخلَّص؛ ثم الكافرون الخلَّص؛ ثم المؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم؛ فبدأ بالطيب، ثم الخبيث، ثم الأخبث؛ إذاً الطيب: هم المتقون المتصفون بهذه الصفات؛ والخبيث: الكفار؛ والأخبث: المنافقون..
.{ 6 } قوله تعالى: { سواء } أي مستوٍ؛ وهي إما أن تكون خبر { إن } في قوله تعالى: { إن الذين كفروا }؛ ويكون قوله تعالى: { أأنذرتهم } فاعلاً بـ{ سواء } مسبوكاً بمصدر؛ والتقدير: سواء عليهم إنذارُك، وعدمُه؛ وإما أن تكون { سواء } خبراً مقدماً، و{ أأنذرتهم } مبتدأً مؤخراً؛ والجملة خبر { إن }؛ والأول أولى؛ لأنه يجعل الجملة جملة واحدة؛ وهنا انسبك قوله تعالى: { أأنذرتهم } بمصدر مع أنه ليس فيه حرف مصدري؛ لكنهم يقولون: إن همزة الاستفهام التي للتسوية يجوز أن تسبك، ومدخولها بمصدر..
قوله تعالى: { إن الذين كفروا } أي بما يجب الإيمان به..
قوله تعالى: { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون }: هذا تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا اعتذاراً للكفار .، ولا تيئيساً له صلى الله عليه وسلم و “الإنذار” هو الإعلام المقرون بالتخويف؛ والرسول صلى الله عليه وسلم بشير، ونذير؛ بشير معلم بما يسر بالنسبة للمؤمنين؛ نذير معلم بما يسوء بالنسبة للكافرين؛ فإنذار النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه بالنسبة لهؤلاء الكفار المعاندين، والمخاصمين . الذين تبين لهم الحق، ولكن جحدوه . مستوٍ عليهم..
وقوله تعالى: { لا يؤمنون }: هذا محط الفائدة في نفي التساوي . أي إنهم أنذرتهم أم لم تنذرهم . لا يؤمنون؛ وتعليل ذلك قوله تعالى: ( ختم الله على قلوبهم )
و “الختم” : الطبع؛ و”الطبع” هو أن الإنسان إذا أغلق شيئاً ختم عليه من أجل ألا يخرج منه شيء، ولا يدخل إليه شيء؛ وهكذا فهؤلاء . والعياذ بالله . قلوبهم مختوم عليها لا يصدر منها خير، ولا يصل إليها خير..
.{ 7 } قوله تعالى: { وعلى سمعهم } أي وختم على سمعهم، فهي معطوفة على قوله تعالى: { على قلوبهم }؛ والختم على الأذن: أن لا تسمع خيراً تنتفع به..
قوله تعالى: { وعلى أبصارهم غشاوة }: الواو للاستئناف؛ فالجملة مستقلة عما قبلها؛ فهي مبتدأ، وخبر مقدم؛ ويحتمل أن تكون الواو عاطفة، لكن عطف جملة على جملة؛ و{ غشاوة } أي غطاء يحول بينها وبين النظر إلى الحق؛ ولو نظرت لم تنتفع..
قوله تعالى: { ولهم } أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم { عذاب عظيم }: وهو عذاب النار؛ وعظمه الله تعالى؛ لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار..
انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخُلَّص الصرحاء..
الفوائد:
.1 من فوائد الآيتين: تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين يردُّه الكفار، ولا يَقبلون دعوته..
.2 ومنها: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذِر والداعي؛ لأنه لا يستفيد . قد ختم الله على قلبه .، كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 96، 97] ، وقال تعالى: {أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار} [الزمر: 19] يعني هؤلاء لهم النار؛ انتهى أمرهم، ولا يمكن أن تنقذهم..
.3 ومنها: أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة، ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه شبهاً من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ، ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله..
.4 ومنها: أن محل الوعي القلوب؛ لقوله تعالى: { ختم الله على قلوبهم } يعني لا يصل إليها الخير..
.5 ومنها: أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر: لأن الهدى قد يكون بالسمع، وقد يكون بالبصر؛ بالسمع فيما يقال؛ وبالبصر فيما يشاهد؛ وهكذا آيات الله عزّ وجلّ تكون مقروءة مسموعة؛ وتكون بيّنة مشهودة..
.6 ومنها: وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم..
مسألة:.
إذا قال قائل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم، أو مجرد ابتلاء وامتحان من الله عزّ وجلّ؟
فالجواب: أن له سبباً؛ كما قال تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} [الصف: 5] ، وقال تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية(المائدة: 13)
القـرآن
)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) (البقرة:8)
التفسير:
.{ 8 } قوله تعالى: { ومن الناس }: { من } للتبعيض؛ أي: وبعض الناس؛ ولم يصفهم الله تعالى بوصف . لا بإيمان، ولا بكفر .؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء: {مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء} [النساء: 143] ؛ و{ الناس } أصلها الأناس؛ لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفاً، كما قالوا في “خير”، و”شر”: إن أصلهما: “أخير”، و”أشر”؛ لكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ وسُموا أناساً: من الأُنس؛ لأن بعضهم يأنس بعضاً، ويركن إليه؛ ولهذا يقولون: “الإنسان مدني بالطبع”؛ بمعنى: أنه يحب المدنية . يعني الاجتماع، وعدم التفرق …
قوله تعالى: { من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر } أي يقول بلسانه . بدليل قوله تعالى: { وما هم بمؤمنين } أي بقلوبهم .؛ وسبق معنى الإيمان بالله، وباليوم الآخر..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بلاغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن في التقسيم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلَّص، ثم الكفار الخلَّص، ثم بالمنافقين؛ وذلك؛ لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة، وفهماً..
.2 . ومنها: أن القول باللسان لا ينفع الإنسان؛ لقوله تعالى: ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)
.3 ومنها: أن المنافقين ليسوا بمؤمنين . وإن قالوا: إنهم مؤمنون .؛ لقوله تعالى: { وما هم بمؤمنين }؛ ولكن هل هم مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون؛ وإن أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين..
.4 ومنها: أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب، واللسان..
ووجه الدلالة: أن هؤلاء قالوا: “آمنا” بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ فصح نفي الإيمان عنهم؛ لأن الإيمان باللسان ليس بشيء..
القـرآن
)يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (البقرة:9)
التفسير:
.{ 9 } قوله تعالى: { يخادعون الله } أي بإظهار إسلامهم الذي يعصمون به دماءهم، وأموالهم..
قوله تعالى: { والذين آمنوا } معطوف على لفظ الجلالة؛ والمعنى: ويخدعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام، وإبطان الكفر، فيظن المؤمنون أنهم صادقون..
قوله تعالى: { وما يخدعون إلا أنفسهم } أي ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم، حيث منَّوها الأماني الكاذبة..
قوله تعالى: { وما يشعرون } أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه؛ ولكن لا يُحِسُّون به، كما تقول: “مَرَّ بي فلان ولم أشعر به”..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: مكر المنافقين، وأنهم أهل مكر، وخديعة؛ لقوله تعالى: { يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم }؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: {هم العدو فاحذرهم} [المنافقون: 4] ؛ فحصر العداوة فيهم؛ لأنهم مخادعون..
.2 ومنها: التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: “فلان يخدع” فإنك تزداد تحفظاً منها؛ وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظاً حذراً، فلا ينخدع بمثل هؤلاء..
فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟
فالجواب: نعرفه بأن نتتبع أقواله، وأفعاله: هل هي متطابقة، أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لنا، ويظهر أنه يحب الإسلام، ويحب الدين، لكن إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه يحارب الدين عرفنا أنه منافق؛ فيجب علينا أن نحذر منه..
.3 ومن فوائد الآية: أن المكر السيئ لا يحيق إلّا بأهله؛ فهم يخادعون الله، ويظنون أنهم قد نجحوا، أو غلبوا؛ ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم؛ لقوله تعالى: { وما يخدعون إلا أنفسهم }: فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئاً، ولا رسوله، ولا المؤمنين..
.4 ومنها: أن العمل السيئ قد يُعمي البصيرة؛ فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة؛ لقوله تعالى: { وما يشعرون } أي ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و “الشعور” أخص من العلم؛ فهو العلم بأمور دقيقة خفية؛ ولهذا قيل: إنه مأخوذ من الشَّعر؛ والشعر دقيق؛ فهؤلاء الذين يخادعون الله، والرسول، والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم، لكن لا شعور عندهم في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم . والعياذ بالله .، فلا يشعرون بهذا الأمر..
القـرآن
)فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (البقرة:10)
التفسير:
.{ 10 } قوله تعالى: { في قلوبهم مرض }: هذه الجملة جملة اسمية تدل على مكث وتمكنُّ هذا المرض في قلوبهم؛ ولكنه مرض على وجه قليل أثّر بهم حتى بلغوا النفاق؛ ومن أجل هذا المرض قال سبحانه وتعالى: { فزادهم الله مرضاً }: الفاء هنا عاطفة؛ ولكنها تفيد معنى السببية: زادهم الله مرضاً على مرضهم؛ لأنهم . والعياذ بالله . يريدون الكفر؛ وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض؛ لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب، أو فسادها؛ فإذا كان القلب يريد خيراً فهو دليل على سلامته، وصحته؛ وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه، وعلته..
وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر؛ لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم: {إنا معكم إنما نحن مستهزئون} [البقرة: 14] ، أي بهؤلاء المؤمنين السذج . على زعمهم . ويرون أن المؤمنين ليسوا بشيء، وأن العِلْية من القوم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبير بـ {إنا معكم} [البقرة: 14] الذي يفيد المصاحبة، والملازمة..
فهذا مرض زادهم الله به مرضاً إلى مرضهم حتى بلغوا إلى موت القلوب، وعدم إحساسها، وشعورها..
قوله تعالى في مجازاتهم: { ولهم عذاب } أي عقوبة؛ { أليم } أي مؤلم؛ فهو شديد، وعظيم، وكثير؛ لأن الأليم قد يكون مؤلماً لقوته، وشدته: فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان؛ وقد يكون مؤلماً لكثرته: فقد يكون ضرباً خفيفاً؛ ولكن إذا كثر، وتوالى آلَم؛ وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار . وهذا ألم حسي .؛ وقال تعالى في أهل النار: {كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون} [السجدة: 20] ، وهذا ألم قلبي يحصل بتوبيخهم..
قوله تعالى: { بما كانوا يكذبون }: الباء للسببية . أي بسبب كذبهم .، أو تكذيبهم؛ و “ما” مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: بكونهم كاذبين؛ أو: بكونهم مكذبين؛ لأن في الآية قراءتين؛ الأولى: بفتح الياء، وسكون الكاف، وكسر الذال مخففة؛ ومعناها: يَكْذِبون بقولهم: آمنا بالله، وباليوم الآخر . وما هم بمؤمنين .؛ والقراءة الثانية: بضم الياء، وفتح الكاف، وكسر الذال مشددة؛ ومعناها: يُكَذِّبون الله، ورسوله؛ وقد اجتمع الوصفان في المنافقين؛ فهم كاذبون مكذِّبون..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق، وكان قلبه مريضاً فإنه يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً }؛ وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين: شبهات، وشهوات؛ فمنهم من علم الحق، لكن لم يُرِده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال الله تعالى في سورة النساء: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا} [النساء: 137] ، وقال تعالى في سورة المنافقين: {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون} [المنافقون: 3] ..
.2 ومن فوائد الآية: أن أسباب إضلال اللَّهِ العبدَ هو من العبد؛ لقوله تعالى: { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً }؛ ومثل ذلك قوله تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} [الصف: 5] ، وقوله تعالى: {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة} [الأنعام: 110] ، وقوله تعالى: {فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم} [المائدة: 49] ..
.3 ومنها: أن المعاصي والفسوق، تزيد وتنقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: { فزادهم الله مرضاً }؛ والزيادة لا تُعقل إلا في مقابلة النقص؛ فكما أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك الفسق يزيد، وينقص؛ والمرض يزيد، وينقص..
.4 ومنها: الوعيد الشديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: ( ولهم عذاب أليم )
.5 ومنها: أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب . أي أن الله لا يعذب أحداً إلا بذنب .؛ لقوله تعالى:
( بما كانوا يكذبون )
.6 ومنها: أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب، والتكذيب؛ وهذا شر الأحوال..
.7 ومنها: ذم الكذب، وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكذب من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم “آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب…”(1) الحديث؛ والكذب مذموم شرعاً، ومذموم عادة، ومذموم فطرة أيضاً..
مسألة :-
إن قيل: كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟
فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ لأنهم حينئذ تُجرى عليهم أحكام الإسلام، فيلوذون بحكم الله . تبارك وتعالى . حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك..
القـرآن
)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (البقرة:11)
)أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ) (البقرة:12)
التفسير:
.{ 11 } قوله تعالى: { وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض }: القائل هنا مبهم للعموم . أي ليعم أيَّ قائل كان؛ و “الإفساد في الأرض” هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي . كما فسره بذلك السلف؛ لقوله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} [الروم: 41]
وقوله تعالى: { في الأرض }: المراد الأرض نفسها؛ أو أهلها؛ أو كلاهما . وهو الأولى؛ أما إفساد الأرض نفسها: فإن المعاصي سبب للقحط، ونزع البركات، وحلول الآفات في الثمار، وغيرها، كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى عليه السلام: {ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون} [الأعراف: 130] ، فهذا فساد في الأرض..
وأما الفساد في أهلها: فإن هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود، ويقولون لهم: {لئن أخرجتم لنخرجنَّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم} [الحشر: 11] : فيزدادوا استعداءً للرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة له؛ كذلك أيضاً من فسادهم في أهل الأرض: أنهم يعيشون بين المسلمين، ويأخذون أسرارهم، ويفشونها إلى أعدائهم؛ ومن فسادهم في أهل الأرض: أنهم يفتحون للناس باب الخيانة والتَقِيَّة، بحيث لا يكون الإنسان صريحاً واضحاً، وهذا من أخطر ما يكون في المجتمع..
قوله تعالى: { قالوا إنما نحن مصلحون }؛ { إنما }: أداة حصر؛ و{ نحن }: مبتدأ؛ و{ مصلحون }: خبر؛ والجملة اسمية؛ والجملة الاسمية تفيد الثبوت، والاستمرار؛ فكأنهم يقولون: ما حالنا إلا الإصلاح؛ يعني: أنه ليس فيهم إفساد مطلقاً..
ومن توفيق الله أنه لم يلهمهم، فيقولوا: إنما نحن المصلحون؛ فلو أنهم قالوا: “نحن المصلحون” كان مقتضاه أن لا مصلح غيرهم؛ لكنهم قالوا: { إنما نحن مصلحون } أي ما حالنا إلا إصلاح؛ ولم يدَّعوا أنهم المصلحون وحدهم..
.{ 12 } قوله تعالى: { ألا إنهم هم المفسدون }؛ { ألا }: أداة تفيد التنبيه، والتأكيد؛ و{ إنهم }: توكيد أيضاً؛ و{ هم }: ضمير فصل يفيد التوكيد أيضاً؛ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: { ألا }، و “إن” ، و{ هم } وهذا من أبلغ صيغ التوكيد؛ وأتى بـ “أل” الدالة على حقيقة الإفساد، وأنهم هم المفسدون حقاً؛ ووجه حصر الإفساد فيهم أن { هم } ضمير فصل يفيد الحصر . أي هم لا غيرهم المفسدون؛ وهذا كقوله تعالى: {هم العدو فاحذرهم} [المنافقون: 4] أي هم لا غيرهم؛ فلا عداء أبلغ من عداء المنافقين للمؤمنين؛ ولا فساد أعظم من فساد المنافقين في الأرض..
قوله تعالى: { ولكن لا يشعرون } أي لا يشعرون أنهم مفسدون؛ لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس؛ فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمور، لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون غيرهم..
الفوائد:
.1 من فوائد الآيتين: أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام، وإبطان الكفر من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: { وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض }؛ والنفاق من أعظم الفساد في الأرض..
.2 ومنها: أن من أعظم البلوى أن يُزَيَّن للإنسان الفساد حتى يَرى أنه مصلح؛ لقولهم: ( إنما نحن مصلحون )
.3 ومنها: أن غير المؤمن نظره قاصر، حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي فقط؛ بل الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضحاً صريحاً..
.4 ومنها: أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق في دعواه؛ لأنهم قالوا: { إنما نحن مصلحون }؛ فقال الله تعالى: { ألا إنهم هم المفسدون }؛ وليس كل ما زينته النفس يكون حسناً، كما قال تعالى: {أفمن زُين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء} [فاطر: 8] ..
.5 ومنها: أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض، ويخفى عليه فساده؛ لقوله تعالى: { ولكن لا يشعرون
.6 ومنها: قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون، حيث قال الله عزّ وجلّ: { ألا إنهم هم المفسدون }؛ فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات؛ وهي { ألا } و “إن” ، و{ هم }؛ بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل..
القـرآن
)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) (البقرة:13)
التفسير:.
.{ 13 } قوله تعالى: { وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس }: القائل هنا مبهم للعموم . أي ليعم أيَّ قائل كان؛ والكاف للتشبيه، و “ما” مصدرية . أي كإيمان الناس؛ والمراد بـ{ الناس } هنا الصحابة الذين كانوا في المدينة، وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم
قوله تعالى: { قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء }؛ الاستفهام هنا للنفي، والتحقير؛ والمعنى: لا نؤمن كما آمن السفهاء؛ وربما يكون أيضاً مضمناً معنى الإنكار . أي أنهم ينكرون على من قال: { آمنوا كما آمن الناس }؛ وهذا أبلغ من النفي المحض؛ و{ السفهاء }: الذين ليس لهم رشد، وعقل؛ والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . على حدّ زعم هؤلاء المنافقين؛ فقال الله تعالى . وهو العليم بما في القلوب . رداً على هؤلاء: { ألا إنهم هم السفهاء }: وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: { ألا }، و “إن” ، وضمير الفصل: { هم }، وهو أيضاً مفيد للحصر؛ وهذه الجملة كالتي قبلها في قوله تعالى: { ألا إنهم هم المفسدون }..
قوله تعالى: { ولكن لا يعلمون } أي لا يعلمون سفههم؛ فإن قيل: ما الفرق بين قوله تعالى هنا: { ولكن لا يعلمون }، وقوله تعالى فيما سبق: { ولكن لا يشعرون }؟
فالجواب: أن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه، وشعوره؛ وأما السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره، ولا يُحَسُّ به نفسِه..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير؛ لقوله تعالى: { وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء }؛ فهم لا ينتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون: { أنؤمن كما آمن السفهاء)
.2 ومنها: إعجاب المنافقين بأنفسهم؛ لقولهم: ( أنؤمن كما آمن السفهاء )
.3 ومنها: شدة طغيان المنافقين؛ لأنهم أنكروا على الذين عرضوا عليهم الإيمان: { قالوا أنؤمن }؛ وهذا غاية ما يكون من الطغيان؛ ولهذا قال الله تعالى في آخر الآية: {في طغيانهم يعمهون} [البقرة: 15] ..
.4 ومنها: أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم: { أنؤمن كما آمن السفهاء }؛ فأعداء الله في كل زمان، وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ فالرسل وصفهم قومهم بالجنون، والسحر، والكهانة، والشعر تنفيراً عنهم، كما قال تعالى: {كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون} [الذاريات: 52] ، وقال تعالى: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين} [الفرقان: 31] وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من المجرمين، ولكن {وكفى بربك هادياً ونصيراً} [الفرقان: 31] ؛ فمهما بلغوا من الأساليب فإن الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال هؤلاء؛ لأن أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء مَسْلكين؛ مسلك الإضلال، والدعاية الباطلة في كل زمان، ومكان؛ ثم مسلك السلاح . أي المجابهة المسلحة؛ ولهذا قال تعالى: {هادياً} [الفرقان: 31] في مقابل المسلك الأول الذي هو الإضلال . وهو الذي نسميه الآن بالأفكار المنحرفة، وتضليل الأمة، والتلبيس على عقول أبنائها؛ وقال تعالى: {ونصيراً} [الفرقان: 31] في مقابل المسلك الثاني . وهو المجابهة المسلحة..
.5 ومن فوائد الآية: أن كل من لم يؤمن فهو سفيه، كما قال الله تعالى: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [البقرة: 130] ..
.6 ومنها: أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان بالله، واتباع شريعته؛ لأن الكافر المخالف للشريعة سفيه؛ فيقتضي أن ضده يكون حكيماً رشيداً..
.7ومنها: تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين، كما قال تعالى: {إن الله يدافع عن الذين آمنوا} [الحج: 38] ؛ فإذا ذموا بالقول دافع الله عنهم بالقول؛ فهؤلاء قالوا: { أنؤمن كما آمن السفهاء }، والله عزّ وجلّ هو الذي جادل عن المؤمنين، فقال: { ألا إنهم هم السفهاء } يعني هم السفهاء لا أنتم؛ فهذا من تحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ أما دفاعه عن المؤمنين إذا اعتُدي عليهم بالفعل فاستمع إلى قول الله تعالى: {إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان} [الأنفال: 12] : هذه مدافعة فعلية، حيث تنْزل جنود الله تعالى من السماء لتقتل أعداء المؤمنين؛ فهذا تحقيق لقول الله تعالى: {إن الله يدافع عن الذين آمنوا} [الحج: 38] ؛ ولكن الحقيقة أن هذا الوعد العظيم من القادر جل وعلا الصادق في وعده يحتاج إلى إيمان حتى نؤمن بالله عزّ وجلّ، ولا نخشى أحداً سواه، فإذا ضعف الإيمان أصبحنا نخشى الناس كخشية الله، أو أشد خشية؛ لأننا إذا كنا نراعيهم دون أوامر الله فسنخشاهم أشد من خشية الله عزّ وجلّ؛ وإلا لكنا ننفذ أمر الله عزّ وجلّ، ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى..
فنحن لو آمنا حقيقة الإيمان بهذا الوعد الصادق الذي لا يُخلَف لكنا منصورين في كل حال؛ لكن الإيمان ضعيف؛ ولهذا صرنا نخشى الناس أكثر مما نخشى الله عزّ وجلّ؛ وهذه هي المصيبة، والطامة العظيمة التي أصابت المسلمين اليوم؛ ولذلك تجد كثيراً من ولاة المسلمين . مع الأسف . لا يهتمون بأمر الله، ولا بشريعة الله؛ لكن يهتمون بمراعاة فلان، وفلان؛ أو الدولة الفلانية، والفلانية . ولو على حساب الشريعة الإسلامية التي من تمسك بها فهو المنصور، ومن خالفها فهو المخذول؛ وهم لا يعرفون أن هذا هو الذي يبعدهم من نصر الله؛ فبدلاً من أن يكونوا عبيداً لله أعزة صاروا عبيداً للمخلوقين أذلة؛ لأن الأمم الكافرة الكبرى لا ترحم أحداً في سبيل مصلحتها؛ لكن لو أننا ضربنا بذلك عُرض الحائط، وقلنا: لا نريد إلا رضى الله، ونريد أن نطبق شريعة الله سبحانه وتعالى على أنفسنا، وعلى أمتنا؛ لكانت تلك الأمم العظمى تهابنا؛ ولهذا يقال: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء..
.8 . ومن فوائد الآية: الدلالة على جهل المنافقين؛ لأن الله عزّ وجلّ نفى العلم عنهم؛ لقوله تعالى: { ولكن لا يعلمون }؛ فالحقيقة أنهم من أجهل الناس . إن لم يكونوا أجهل الناس؛ لأن طريقهم إنما هو خداع، وانخداع، وتضليل؛ وهؤلاء المنافقون من أجهل الناس؛ لأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم، وأنهم هم السفهاء..
القـرآن
)وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ) (البقرة:14) )اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (البقرة:15)
التفسير:
.{ 14 } قوله تعالى: { وإذا لقوا الذين آمنوا } أي قابلوهم، أو جلسوا إليهم؛ { قالوا } أي للمؤمنين الذين لقوهم؛ { آمنا } أي كإيمانكم..
قوله تعالى: { وإذا خلوا إلى شياطينهم }؛ ضُمِّن الفعل هنا معنى “رجعوا”؛ ولذلك عُدِّي بـ{ إلى }، لكن عُدِّي بالفعل { خلوا } ليكون المعنى: رجعوا خالِين بهم؛ والمراد بـ{ شياطينهم } كبراؤهم؛ وسمي كبراؤهم بـ “الشياطين” لظهور تمردهم؛ وقد قيل: إن “الشيطان” كل مارد؛ أي كل عاتٍ من الجن، أو الإنس، أو غيرهما: شيطان؛ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود بأنه شيطان؛ وليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه: الشيطان في جنسه: لأن أعتى الكلاب، وأشدها قبحاً هي الكلاب السود؛ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: “الكلب الأسود شيطان” ؛ ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان . أي مَريدهم، وعاتيهم..
وكلمة: “شيطان” : النون فيها أصلية من “شطن” بمعنى بعُد؛ ولكونها أصلية صُرف الاسم بتنوين، كما في قوله تعالى: { ويتبع كل شيطان مريد } [الحج: 3] ؛ ولو كانت النون والألف زائدتان منعت من الصرف؛ لأن الألف والنون إذا كانتا زائدتين في عَلَم؛ أو وصف فإنه يُمنع من الصرف؛ وأما إذا كانتا زائدتين في غير علم، ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف..
قوله تعالى: { إنا معكم } أي صحب مقارنون لكم تابعون لكم؛ { إنما نحن مستهزئون } أي ما نحن إلا ساخرون بالمؤمنين: نظهر لهم أنا مسلمون لنخادعهم..
.{ 15 } قوله تعالى: { الله يستهزئ بهم } أي يسخر تبارك وتعالى بهم بما أملى لهم، وكفّ أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه عن قتلهم . مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار..
قوله تعالى: { ويمدهم في طغيانهم يعمهون }؛ الطغيان مجاوزة الحد، كقوله تعالى: {إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية} [الحاقة: 11] ؛ و “العمه” الضلال؛ والمعنى أن الله يبقيهم ضالين في طغيانهم؛ واعلم أن بين “يَمد” الثلاثي، و”يُمد” الرباعي فرقاً؛ فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخير، والثلاثي في الشر؛ قال الله تعالى: {ونمد له من العذاب مداً} [مريم: 79] : وهذا في الشر؛ وقال تعالى: {وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون} [الطور: 22] : وهذا في الخير؛ وهنا قال تعالى: { ويَمدهم }: فهو في الشر..
الفوائد:
.1 من فوائد الآيتين: ذلّ المنافق؛ فالمنافق ذليل؛ لأنه خائن؛ فهم { إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا } خوفاً من المؤمنين؛ و{ إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم } خوفاً منهم؛ فهم أذلاء عند هؤلاء، وهؤلاء؛ لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تَقيَّة فهذا دليل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ لأنه تستر بما يُظَن أنه خير وهو شر..
.2 ومنها: أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به، أو برسله، أو بشرعه جزاءً وفاقاً؛ واعلم أن ها هنا أربعة أقسام:
قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص: هذا لا يسمى الله تعالى به؛ ولكن يوصف الله به، مثل “المتكلم”، و”المريد”؛ فـ”المتكلم”، و”المريد” ليسا من أسماء الله؛ لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم، ومريد على سبيل الإطلاق؛ ولم تكن من أسمائه؛ لأن الكلام قد يكون بخير، وقد يكون بشر؛ وقد يكون بصدق، وقد يكون بكذب؛ وقد يكون بعدل، وقد يكون بظلم؛ وكذلك الإرادة..
القسم الثاني: ما هو كمال على الإطلاق، ولا ينقسم: فهذا يسمى الله به، مثل: الرحمن، الرحيم، الغفور، السميع، البصير… وما أشبه ذلك؛ وهو متضمن للصفة؛ وليس معنى قولنا: “يسمى الله به” أن نُحْدِث له اسماً بذلك؛ لأن الأسماء توقيفية؛ لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى تَسَمَّى به..
القسم الثالث: ما لا يكون كمالاً عند الإطلاق؛ ولكن هو كمال عند التقييد ؛ فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيداً، مثل: الخداع، والمكر، والاستهزاء، والكيد. فلا يصح أن تقول: إن الله ماكر على سبيل الإطلاق، ولكن قل: إن الله ماكر بمن يمكر به، وبرسله، ونحو ذلك..
مسألة :-
هل “المنتقم” من جنس الماكر، والمستهزئ؟
الجواب: مسألة “المنتقم” اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا يوصف به على سبيل الإفراد، وإنما يوصف به إذا اقترن بـ”العفوّ”؛ فيقال: “العفوُّ المنتقم”؛ لأن “المنتقم” على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قُرِن بـ”العفوّ”؛ ومثله أيضاً المُذِل: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن بـ”المُعِز”؛ فيقال: “المعزُّ المُذل”؛ ومثله أيضاً “الضار”: قالوا: لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن “النافع”؛ فيقال: “النافع الضار”؛ ويسمون هذه: الأسماء المزدوجة..
ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق . ولو مقروناً بما يقابله . أي إنك لا تقول: العفوّ المنتقم؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى “المنتقم”؛ وليست صفة كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ ولهذا يقول عزّ وجلّ: {إنا من المجرمين منتقمون} [السجدة: 22] ، وقال عزّ وجلّ: {والله عزيز ذو انتقام} [آل عمران: 4] ؛ وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى، وذُكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها أشياء هي من أسماء الله . مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم..
القسم الرابع: ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق: فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبداً، ولا يسمى به، مثل: العاجز؛ الضعيف؛ الأعور…. وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة عيب مطلقاً..
والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين دال على كماله، وقوته، وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين مثل قوله تعالى: {إنهم يكيدون كيداً * وأكيد كيداً} [الطارق: 15، 16] أي أعظمَ منه كيداً؛ فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته، ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئاً من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله ما لم يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام، كما قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 33] ؛ فكل قول على الله بلا علم في شرعه، أو في فعله، أو في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءً حقيقياً؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكبر، وليس كمثله شيء..
وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وصف الله به نفسه؛ فكما أنك لا تتجاوز حكم الله فلا تقول لما حرم: “إنه حلال”، فكذلك لا تقول لما وصف به نفسه أن هذا ليس المراد؛ فكل ما وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهره، لكن تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك؛ فاستهزاء الله ليس كاستهزائنا؛ وقرب الله ليس كقربنا؛ واستواء الله على عرشه ليس كاستوائنا على السرير؛ وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرها، ولا نقول على الله ما لا نعلم؛ ولكن ننزه ربنا عما نزَّه نفسه عنه من مماثلة المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11] ..
أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقاً؛ لأن الخيانة صفة نقص مطلق؛ و”الخيانة” معناها: الخديعة في موضع الائتمان . وهذا نقص؛ ولهذا قال الله عزّ وجلّ: {وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم} [الأنفال: 71] ، ولم يقل: فخانهم؛ لكن لما قال تعالى: {يخادعون الله} [النساء: 142] قال: {وهو خادعهم} [النساء: 142] ؛ لأن الخديعة صفة مدح مقيدة؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “الحرب خدعة”(1) ، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تخن من خانك” ؛ لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان؛ أما الخداع فيكون في موضع ليس فيه ائتمان؛ والخيانة صفة نقص مطلق..
.3 ومن فوائد الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى قد يُملي للظالم حتى يستمر في طغيانه..
فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي تحذير الإنسان الطاغي أن يغتر بنعم الله عزّ وجلّ؛ فهذه النعم قد تكون استدراجاً من الله؛ فالله سبحانه وتعالى يملي، كما قال تعالى: { ويمدهم في طغيانهم يعمهون }؛ ولو شاء لأخذهم، ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . كما جاء في الحديث.
فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبد، والنعم التي يستدرج بها العبد؟
فالجواب: أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيماً على معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج..
.4 ومن فوائد الآيتين: أن صاحب الطغيان يعميه هواه، وطغيانه عن معرفة الحق، وقبوله؛ ولهذا قال تعالى: { ويمدهم في طغيانهم يعمهون }؛ ومن الطغيان أن يُقَدِّم المرء قوله على قول الله ورسوله؛ والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدِّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم(الحجرات: 1).
القـرآن
)أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (البقرة:16)
التفسير:
.{ 16 } قوله تعالى: { أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى }؛ “أولاء” اسم إشارة؛ والمشار إليهم المنافقون؛ وجاءت الإشارة بصيغة البُعد لبُعد منزلة المنافق سفولاً؛ و{ اشتروا } أي اختاروا؛ و{ الضلالة }: العماية؛ وهي ما ساروا عليه من النفاق؛ و{ بالهدى }: الباء هنا للعوض؛ أخذوا الضلالة، وأعطوا الهدى . مثلما تقول: اشتريت الثوب بدرهم؛ فالهدى المدفوع عوض عن الضلالة المأخوذة، كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب المأخوذ..
قوله تعالى: { فما ربحت تجارتهم } أي ما زادت تجارتهم . وهي اشتراؤهم الضلالة بالهدى..
قوله تعالى: { وما كانوا مهتدين } أي ما كانوا متصفين بالاهتداء حينما اشتروا الضلالة بالهدى؛ بل هم خاسرون في تجارتهم ضالون في منهجهم..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان سفه هؤلاء المنافقين، حيث اشتروا الضلالة بالهدى..
.2 ومنها: شغف المنافقين بالضلال؛ لأنه تبارك وتعالى عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه؛ والمشتري مشغوف بالسلعة محب لها..
.3 ومنها: أن الإنسان قد يظن أنه أحسنَ عملاً وهو قد أساء؛ لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظناً منهم أنهم على صواب، وأنهم رابحون، فقال الله تعالى: { فما ربحت تجارتهم }..
.4 ومنها: خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح؛ لقوله تعالى: ( فما ربحت تجارتهم )..
.5 ومنها: أن المدار في الربح، والخسران على اتباع الهدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه فهو الخاسر؛ ويدل لذلك قوله تعالى: {والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} [العصر: 1 . 3] ، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} [الصف: 10، 11] : تقف على {خير لكم} ؛ لأن {إن كنتم تعلمون} إذا وصلناها بما قبلها صار الخير معلقاً بكوننا نعلم . وهو خير علمنا أم لم نعلم..
.6 . ومن فوائد الآية: أن هؤلاء لن يهتدوا؛ لقوله تعالى: { وما كانوا مهتدين }؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ ولذلك لا يرجعون؛ وهكذا كل فاسق، أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع؛ فالجاهل البسيط خير من هذا؛ لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب . وليس على صواب..
القـرآن
)مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ) (البقرة:17) )صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (البقرة:18)
التفسير:
.{ 17 } قوله تعالى: { مثلهم } أي وصْفهم، وحالهم { كمثل الذي استوقد ناراً } أي طلب من غيره أن يوقد له ناراً، أو طلب من غيره ما يوقد به النار بنفسه؛ { فلما أضاءت ما حوله } أي أنارت ما حول المستوقد، ولم تذهب بعيداً لضعفها؛ { ذهب الله بنورهم } يعني: وأبقى حرارة النار؛ و “لما” حرف شرط، و{ أضاءت } فعل الشرط؛ و{ ذهب الله } جواب الشرط؛ والمعنى: أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور؛ لأن القاعدة أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة..
وفي هذه الآية نجد اختلافاً في الضمائر: { استوقد }: مفرد؛ { حوله }: مفرد؛ { بنورهم }: جمع؛ { تركهم }: جمع؛ { لا يبصرون }: جمع؛ قد يقول قائل: كيف يجوز في أفصح الكلام أن تكون الضمائر مختلفة والمرجع فيها واحد؟ الجواب من وجهين:.
الأول: أن اسم الموصول يفيد العموم؛ وإذا كان يفيد العموم فهو صالح للمفرد، والجمع؛ فتكون الضمائر في { استوقد }، و{ حوله } عادت إلى اسم الموصول باعتبار اللفظ؛ وأما { نورهم }، و{ تركهم }، و{ لا يبصرون } فعادت إلى الموصول باعتبار المعنى..
الوجه الثاني: أن الذي استوقد النار كان مع رفقة، فاستوقد النار له، ولرفقته؛ ولهذا قال تعالى: { أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم… } إلخ..
وعلى الوجه الثاني تكون الآية ممثلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم؛ لأن رأس المنافقين هو الذي استوقد النار، وأراد أن ينفع بها أقرانه، ثم ذهبت الإضاءة، وبقيت الحرارة، والظلمة، وتركهم جميعاً في ظلمات لا يبصرون..
قوله تعالى: { وتركهم في ظلمات }: جمعها لتضمنها ظلمات عديدة؛ أولها: ظلمة الليل؛ لأن استيقاد النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل؛ لأنك إذا استوقدت ناراً بالنهار فإنها لا تضيء؛ و الثانية: ظلمة الجو إذا كان غائماً؛ و الثالثة: الظلمة التي تحدث بعد فقد النور؛ فإنها تكون أشد من الظلمة الدائمة؛ و{ لا يبصرون } تأكيد من حيث المعنى لقوله تعالى: { في ظلمات } دال على شدة الظلمة..
.{ 18 } قوله تعالى في وصفهم: { صم } خبر لمبتدأ محذوف . أي هم صم؛ و{ صم } جمع أصم؛ و”الأصم” الذي لا يسمع، لكنه هنا ليس على سبيل الإطلاق؛ بل أريد به شيء معين: أي هم صم عن الحق، فلا يسمعون؛ والمراد نفي السمع المعنوي . وهو السمع النافع؛ لا الحسي . وهو الإدراك؛ لأن كلهم يسمعون القرآن، ويفهمون معناه، لكن لما كانوا لا ينتفعون به صاروا كالصم الذين لا يسمعون؛ وذلك مثل قول الله تعالى: {ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون}(الأنفال: 21).
قوله تعالى: { بُكْمٌ } جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ والمراد أنهم لا ينطقون بالحق؛ وإنما ينطقون بالباطل؛ و{ عُمْيٌ } جمع أعمى؛ والمراد أنهم لا ينتفعون بما يشاهدونه من الآية التي تظهر على أيدي الرسل . عليهم الصلاة والسلام..
فبهذا سُدت طرق الحق أمامهم؛ لأن الحق إما مسموع؛ وإما مشهود؛ وإما معقول؛ فهم لا يسمعون، ولا يشهدون؛ كذلك أيضاً لا يؤخذ منهم حق؛ لأنهم لا ينطقون بالحق؛ لأنهم بُكم؛ فهم لا ينتفعون بالحق من غيرهم، ولا ينفعون غيرهم بحق..
قوله تعالى: { فهم لا يرجعون }: الفاء هذه عاطفة، لكنها تفيد السببية . أي بسبب هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عن غيِّهم؛ فلا ينتفعون بسماع الحق، ولا بمشاهدته، ولا ينطقون به..
الفوائد:
.1 من فوائد الآيتين: بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالاً محسوسات؛ لأن الشيء المحسوس أقرب إلى الفهم من الشيء المعقول؛ لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيداً، كما قال تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت: 43] ..
.2 ومنها: ثبوت القياس، وأنه دليل يؤخذ به؛ لأن الله أراد منا أن نقيس حالهم على حال من يستوقد؛ وكل مثل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس..
.3 ومنها: أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله تعالى: { كمثل الذي استوقد ناراً }؛ فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى، والعلم، والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم . بمجرد ما يصل إليها . يتضاءل، ويزول؛ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب، وأعمام، وأخوال، وأقارب؛ فربما يجلس إلى المؤمن حقاً، فيتكلم له بإيمان حقيقي، ويدعوه، فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول..
.4 ومن فوائد الآيتين: أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: {فلما أضاءت ما حوله}: الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر؛ ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين . وهي أوسع ما تحدَّث الله به عن المنافقين: {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم} [المنافقون: 3] ..
.5 ومنها: أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت الظلمة الشديدة؛ بل الظلمات..
.6 ومنها: أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم: { ذهب الله بنورهم }، كأنه أخذه قهراً..
فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟
فالجواب: لا؛ لأن هذا الذي حصل من رب العباد عزّ وجلّ بسببهم؛ وتذكَّر دائماً قول الله تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} [الصف: 5] . حتى يتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فإنما ذلك بسبب منه
.7 ومن فوائد الآيتين: تخلي الله عن المنافقين؛ لقوله تعالى: [ وتركهم]
ويتفرع على ذلك: أن من تخلى الله عنه فهو هالك . ليس عنده نور، ولا هدًى، ولا صلاح؛ لقوله تعالى: (وتركهم في ظلمات لا يبصرون )
.8 ومن فوائد الآيتين: أن هؤلاء المنافقين أصم الله تعالى آذانهم، فلا يسمعون الحق؛ ولو سمعوا ما انتفعوا؛ ويجوز أن يُنفى الشيء لانتفاء الانتفاع به، كما في قوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون} (الأنفال: 21)
.9 ومنها: أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق . كالأبكم..
.10 ومنها: أنهم لا يبصرون الحق . كالأعمى..
.11 ومنها: أنهم لا يرجعون عن غيِّهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم محسنون، وأنهم صاروا أصحاباً للمؤمنين، وأصحاباً للكافرين: هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر، وأصحاب للكافرين في الباطن؛ ومن استحسن شيئاً فإنه لا يكاد أن يرجع عنه..