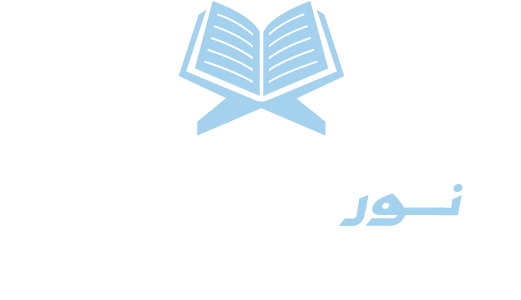منهج الأثر والتأثر في دراسات وكتابات المستشرقين عن قصص القرآن الكريم:
يعد هذا المنهج الاستشراقي ، منهجاً عدوانيا، تكتنفه العنصرية العرقية، والنزعة التأثيرية الدينية، ومضمونه يتمحور حول رد كل ما يتصل بدين الإسلام من قرآن وسنة وقصص وغيره بعد تفكيكها إلى ملة اليهودية والنصرانية المحرفة، و معظم المستشرقين إن لم يكونوا كلهم يمتهنون هذا المنهج فيربطون كل ما يتصل بالإسلام والمسلمين باليهودية والنصرانية، ولا شك أن هذه هي حالة عدائية محضة ، وحسد متوارث ومتأصل في نفوس القوم والله عز وجل قد بين لنا سوء الطوية التي تنطوي عليها قلوبهم ونفوسهم، فقال عز وجل (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) البقرة ١٠٩، يقول ابن كثير رحمه الله” يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم”[تفسير ابن كثير 1/133].
وهذا المنهج وهذه النزعة العدوانية التي يسلكها المستشرقون في الدراسات الإسلامية، ليست وليدة اليوم بل هي قديمة أزلية يتوارثها القوم كابرا عن كابر ، ففي عام 1833م ، أصدر اليهودي أبراهام غايغر A.Geiger كتابا يحمل عنوانا مثيرا هو (ماذا أخذ القرآن عن اليهودية؟)، وقد أصبح هذا الكتاب بمثابة الضوء الأخضر لمعاشر المستشرقين ، والذي فتح لهم بابا لتفكيك مضامين القرآن الكريم، واستنباط ما يُخَيل إليهم أنه منقولا من اليهودية فتكاثرت الأبحاث الاستشراقية التعسفية لترد قصص القرآن الكريم وغيره من التراث الإسلامي إلى العناصر التوراتية المزعومة يقول د. حسن عزوزي ” وقد أقبلت أبحاث هؤلاء تفكك مضامين القرآن الكريم، لتردها إلى عناصر توراتية _ يهودية مزعومة”[مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، ص 21]، وكلما وجد هؤلاء وجه شبه بين بعض مضامين القرآن والكريم وتلك الموضوعات التي تبث في التوراة والإنجيل، عزو الأمر مباشرة إلى أن القرآن استقى موارده القصصية وغيرها من التوراة والإنجيل، فهذا أحد مشاهيرهم ريجي بلاشير الذي قد يكون أحسنهم اعتدالا في إصدار الأحكام يقول في كتابه حياة محمد “إن التأثير النصراني كان واضحاً في السور المكية الأولى؛ إذ كثيرا ما تكشف مقارنة بالنصوص غير الرسمية كإنجيل الطفولة الذي كان سائداً في ذلك العهد عن شبه قوي” ويستمد التأييد لرأيه من آراء بعض الباحثين المستشرقين لإثبات ما استنتجه من أن هناك علاقة بين مؤسس الإسلام( يقصد النبيr ) والفقراء النصارى بمكة حسب زعمه.
ويرى الكثير من المستشرقين أن اللغة العبرية هي أصل لكثير من ألفاظ القرآن الكريم، ففي جانب الأعلام التي وردت في القرآن الكريم يرى المستشرق الفرنسي اليهودي أندريه شوراكي أن أصلها يعود للعبرية، وقد أصدر كتابا ترجم فيه معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية والتي أرجع الكثير منها وعزاها لأصول عبرية حسب زعمه، وقد وجد الكتاب انتقادا من بعض المستشرقين وذلك لعدم وجود مرجعية علمية صحيحة لديه ، ومن يرجع إلى تلك الترجمة سيجد فيها هشاشة وغرابة في الدلالات، استخدم فيها معان وألفظ شاذة لا تعطي القارئ نوع فهم أو وصول لحقيقة علمية واضحة.
إن هذا المستشرق اليهودي يذكي في الأذهان أن معظم ألفاظ القرآن الكريم ترجع في معانيها إلى ما يقابلها في لغته العبرية، وبالتالي يؤكد للناس فريته وكذبه بأن مصدر القرآن الحقيقي هو التوراة ، حيث استمد قصصه ومعانيه منها.
إن هذا المنهج الاستشراقي المخالف لكل قواعد البحث العلمي الصحيح، والذي ينسب مصدرية القرآن الكريم إلى التوراة والإنجيل، فإنه يتجاهل بل ويلغي قدسية القرآن الكريم وينفي أصل الدين ومنبعه ونسبته إلى الله عز وجل، والمستشرقون عندما يطبقون هذا المنهج على القرآن فإنهم يرجعون أسسه ومبادئه ومضامينه إلى أصول يهودية ونصرانية، يقول د. عمر لطفي العالم “إن ما صنعه القرآن هو الحق، وأن طريقته هي الطريقة المثلى في تقرير الحقائق بصورة كلية ليست مجالا للإختلاف، وأما ما عداه من الكتب السماوية الأخرى فقد تغيرت أسانيدها ودخلها التحريف والتغيير”[المستشرقون والقرآن دراسة نقدية لمناهج المستشرقين، مركز دراسات العالم الإسلامي] .
وفي الجانب الآخر نجد أن هذا المنهج الاستشراقي الظالم يشاطره التحايل والمراوغة والدهاء من بعض المستشرقين، فعلى سبيل المثال المستشرق المجري إجناس جولد زيهر I.Goldziher يحاول إقحام القرآن الكريم في أصل المدعاة وهي التشابه القائم بين ألفظ القرآن الكريم والعهد القديم على حد زعمه، حيث يقول ” القرآن مصدق لما سبق من الرسالات الدينية، وقد استصفى منها بعد فترة من الرسل ما هو من جوهر الدين”[العقيدة والشريعة في الإسلام، جولدزيهر، ص 17] ، هذه هي نظرة المستشرقين واعتقاداتهم في أن القرآن الكريم وقصصه مستمد من الأفكار اليهودية، إن مرادهم من وراء هذه التعسفات والأباطيل، واستخدام هذا المنهج الخطير جدا الذي يزعمون من وراءه أن كتاب الله عز وجل تأثر بالتوراة وغيرها من الكتب السماوية لينفوا عامدين مصدرية القرآن الكريم وربانيته.
إن منهج الأثر والتأثر الاستشراقي موجود إبان إفادة النهضة الأوروبية من الحضارة اليونانية، فقد طبقه الغرب بشكل صارم، ولذلك أصبح هذا المنهج أداة ووسيلة لمواجهة أي فكر أو مذهب جديد، وتطبيقه عليه للوصول إلى المأمول وخصوصا ما يتصل بالعالم الإسلامي ومعتقداته وتراثه المجيد، وبكلمة أدق فيما يتصل بالقرآن الكريم وعلومه، لأنه الوحي المنزل من عند الله على لسان رسولهr المحفوظ من كل عبث وتحريف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ومهما حاول أولئك العابثون فلن يصلوا إلى منشودهم من الإضرار به أو بمدخرات الأمة وتراثها الأصيل ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ يوسف ٢١ .
المنهج الافتراضي في دراسات وكتابات المستشرقين عن قصص القرآن الكريم:
يتسم المنهج الاستشراقي في مضمونه العام بالانحراف عن مسار المنهجية العلمية الصحيحة ، وخصوصا فيما إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام والمسلمين، والقرآن والشريعة ، ولقد كان المنهج الافتراضي أحد ضروب هذا المنهج ووسيلتهم إلى التصديق بما هو في الأصل كذبا، والمستشرقون يسعون إلى إيجاد فرضيات مسبقة ويحاولون إثباتها بأدلة وأراء واهية، ويخضعونها للبحث الذي يتناسب وما يصبون إليه من التكذيب والتشكيك وقلب الحقائق بما هو ثابت ومسلم به بأدلته الصحيحة من أمور الإسلام، ويحاولون نفي رسالة النبيr وما جاء به من الحق من ربه جل وعلا، يقول د. محمد فتح الله الزيادي” المستشرقون الدارسون للإسلام بحكم مخالفتهم العقدية له لا يستطيعون التخلص من مسلماتهم أن محمداr ليس نبيا مرسلا، وأن القرآن الكريم ليس كتابا منزلا، وأن العرب ليسوا جنسا حضاريا مؤهلا للقيام بدور حضاري إنساني، وقد أثرت هذه المسلمات في توجهاتهم البحثية فجعلتهم يحاولون الوصول إلى عدم جدة الرسالة الإسلامية، واعتمادها على مصادر قديمة، واتصال الرسولr بآخرين تعلم منهم ونقل ما نقل، ثم تراهم يتحدثون عن تأثر الرسولr بالبيئة تارة وبالصرع تارة أخرى، إلى غير ذلك من الآراء التي لسنا في مجال حصرها أو مناقشتها”[الاستشراق أهدافه ووسائله، ص116] .
إن القرآن الكريم وما يتضمنه من قصص وسور وآيات ، هو ميدان المستشرقين الأرحب لبث السموم والتشكيك في أصالة القرآن الكريم، ولقد كان ترتيب السور مرتعا خصبا لأولئك المستشرقون، لممارسة هذا المنهج الفرضي الذي لا يقوم على أسس علمية مقبولة، فقد خالفوا أهل الإسلام في قضية ترتيب السور الذي هو عند المسلمين مسألة توقيفية لا خلاف فيها، إذ أنهم يفترضون ترتيبا جديدا مبنيا على أسس من الهوى والزيغ، بعيدا عن المنهج العلمي الصحيح، وبناء على ما قرروه من هذا الترتيب المصطنع، فإنهم بنوا على ذلك نتائج تحمل منزلقا خطيرا في جانب القرآنيات، ومن خلال هذا الباب أظهروا طعونهم وتشكيكاتهم في القرآن، لا في الترتيب فحسب بل في كل ما يتضمنه من قصص وحوادث وآيات، وأخضعوه لظروف زمانية ومكانية، ومن هؤلاء المستشرق الانجليزي آرثر جفري الذي تكلم عن سورة الجن وأنشأ لها فرضية ليبني عليها أحكاما يوهم القارئ بأنها حقائق علمية لا تقبل النقاش والجدال، فيقول” إن الآيات الخاتمة للسورة تختلف كثيراً في الشكل والأسلوب، وتظهر وكأنها قطعة غريبة وضعها جامعو القرآن أو كتبته”[10]، فيؤكد هنا للقارئ جزافا أن هنا اختلافا وعدم تناسب وتناسق بين الآيات الخاتمة في السورة، ولو أن جفري أنصف ورجع إلى كتب التفسير الموثوقة لدى المسلمين، لوجد أن الحقيقة تخالف ما قاله وما توهمه، يقول الإمام برهان الدين البقاعي –رحمه الله- في آخر حديثه عن سورة الجن “لقد التقى أول السورة وآخرها، فدل آخرها على الأول المجمل وأولها على الآخر المفصل، وذلك أن أول السورة بين عظمة الوحي، بسبب الجن، ثم بين في أثنائها حفظه من مسترقي السمع، وختم بتأكيد حفظه وحفظ جميع كلماته” .
وذاك الإمام ابن الزبير الغرناطي[نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم برهان الدين البقاعي] عند حديثه عن سورة الجن ختم حديثه بقوله” ثم استمرت الآي ملتحمة المعاني معتضدة المباني إلى آخر السورة “، وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه جفري، وليس المقام هنا مقام الرد على مفتريات هؤلاء المستشرقين حول القرآن الكريم وعلومه، وإنما لبيان عوار هذا المنهج وفساده من الأصل، ولمزيد من البطلان والفساد لهذا المنهج، نورد مثالا يثير كثيرا من الغرابة في أفكار القوم، ففي قصة الاستئذان التي أمر الله بها في القرآن في سورة النور في قوله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النور ٢٧ ، يقول المستشرق الإنجليزي المعاصر منتغمري وات M.Watt في تأويل هذه الآية على حد زعمه “إن ذلك دليل على انحطاط في مستوى الأخلاق كان النبي r بحاجة إلى السمو به في نفوس أصحابه”[محمد rفي مكة، ويليام مونتجمري وات]، ومن يتأمل في كلامه يتبين له بروز المنهج الفرضي الذي نتج عنه استنتاج خاطئ، إذ أنه لو كانت الأخلاق غير منحطة لولج الناس بيوت الآخرين بلا أدب ولا استئذان، ولما صار للبيوت حرمة ولا هيبة، فقضية الاستئذان لا تختص بدين الإسلام فحسب ، بل هي فطرة جبلت عليها النفوس البشرية السوية، ودعت إليها الأديان، وتظافرت عليها الأعراف والتقاليد بين الشعوب الإنسانية، ولعل وات نسي أو تناسى أن الغرب يحتفظ بفضيلة الاستئذان قبل الولوج في بيوت الناس، فأنى لوات هذا الافتراض الذي لا يقوم على أساس علمي صحيح.
وخلاصة القول في هذا المنهج، هو أن معاشر المستشرقين يهدفون وبشكل مباشر من ورائه وغيره من المناهج الاستشراقية، إلى الوصول إلى غاية كبرى وهي إثبات أن القرآن الكريم بشري وليس وحياً منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه يحمل بين طياته التناقض إما إزاء موضوعاته أو أساليبه، وذلك من خلال الافتراضات المسبقة التي يسعى المستشرق جاهدا إلى إثباتها، وهذا المنج وهذه السمة غير العلمية ولا تستند على قواعد علمية صحيحة، يجب أن تواكبها من قبلنا منهجية إسلامية علمية ، تتسم بالموضوعية والعدل ، بعيدة عن الهوى والتعصب ، ننشد من ورائها الوصول إلى الحق، يقول الحسن بن الهيثم” ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرءه ونتصفحه استعمال العدل، لا اتباع الهوى، وفي سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق، لا الميل مع الآراء، فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر، ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وينحسر بها مواد الشبهات”.
المنهج الإسقاطي في دراسات وكتابات المستشرقين عن قصص القرآن الكريم:
يظهر في هذا المنهج شيء من الغرابة في ماهية اسمه وعلى ماذا ينطوي من المعاني والأهداف ، ولإزالة هذه الحيرة، لا بد لنا من التقديم والتعريف بهذا المنهج، ليتبين مضمونه وتتضح معالمه:
يعرف علماء النفس الإسقاط بأنه” تفسير الأوضاع والمواقف والأحداث بتسليط خبراتنا ومشاعرنا عليها، والنظر إليها من خلال عملية انعكاسٍ لما يدور في داخل نفوسنا”، ويعرفه علماء التحليل النفسي بأنه “حيلة نفسية، يلجأ إليها الشخص كوسيلة للدفاع عن نفسه ضدّ مشاعر غير سارّة في داخله، مثل الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص، فيعمد – على غير وعي منه – إلى أن ينسب للآخرين أفكارا ومشاعر وأفعالا حياله، ثمّ يقوم من خلالها بتبرير نفسه أمام ناظريه”[موسوعة علم النفس، أسعد رزق]. ويمكننا الوصول من خلال التعريفين السابقين إلى النتائج التالية:
1- أنّ الشعور بالنقص والدونية سبب للقيام بعملية الإسقاط .
2- الدفـاع عن عيـوبٍ أو نقـصٍ في القائم بهذه العملية.
3- فقدان الشعور أثناء القيام بهذه العملية.
4- نزاهة الغاية والهدف في الغالب مما يجه إليها أثناء عملية الإسقاط.[منهج الإسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين]
ولقد ورد منهج الاسقاط بصفة الاسقاط المتعمد في قوله عز وجل (وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)النساء ١١٢ ، قال ابن كثير رحمه الله” هي كقوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) فاطر ١٨، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها”[تفسير ابن كثير 1/492]، يقول د. حسن عزوزي” تفسير الوقائع والنصوص بالإسقاط أمر دأب المستشرقون على توظيفه في أبحاثهم القرآنية، ونعني بالمنهج الإسقاطي إسقاط الواقع المعيش على الحوادث والوقائع التاريخية، إنه تصور الذات في الحدث أو الواقعة التاريخية”[مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، ص33]، ويقول في موضع آخر” وهكذا يتم تفسير تلك الوقائع وفق المشاعر الإنسانية الخاصة والانطباعات التي تتركها بيئة ثقافية معينة، فالمستشرق الباحث عندما يضع في ذهنه صورة معينة يحاول إسقاطها على صور ووقائع معينة يخضعها إلى ما ارتضته مخيلته وانطباعاته”[مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، ص33].
والمستشرقون كعادتهم ودأبهم، يمارسون العملية الإسقاطية في الدراسات القرآنية بناء على تأثرهم القوي بخلفياتهم العقدية وموروثاتهم الفكرية، وبدافع نفسي خبيث يهدف إلى رمي القرآن الكريم بما ثبت في حق كتبهم المقدّسة ودياناتهم المحرّفة، منتقصين من قدر كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت ٤٢ .
ولتأكيد ما سبق نضرب مثالا يثبت رسوخ هذا المنهج عند المستشرقين، وهو ما أورده المستشرق بلاشير عندما قام بالبحث عن أسباب عدم جمع القرآن الكريم في مصحف مستقل زمن نبيناr إذ أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يميلون إلى ترك الأمور على ماهي عليه، وذلك لأن العرب في جملتهم لا يفكرون إلا في الحاضر ولا يهمهم المستقبل ، وهذا الميل يقف وراء عزوف المسلمين عن جمع القرآن في عهده .[مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، ص33] وهذا التفسير الإسقاطي فاسد بكل المقاييس العلمية، إذ أن بلاشير لا يستند فيه إلى أدنى دليل علمي صحيح، وحتى المنطق العقلي لا ينطبق عليه، لأنه مبني في الأساس على فرضيات مسبقة، وهوى متبع، مما نتج عن ذلك أحكاما جزافية متعسفة، لم تخضع أبدا لأدنى المعايير البحثية العلمية، ومن المعلوم ضرورة أن النبي r كان يحث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على حفظ القرآن وتدوينه خوفا عليه من الضياع، باستخدام كافة الطرق المتاحة أنذاك، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على عدم اختلاط القرآن بالحديث النبوي ، أمر بتدوين الحديث أولا ثم كتابة القرآن، يقول زيد بن ثابتt ” كنا عند رسول الله r نؤلف القرآن من الرقاع”[الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/164]، وفي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفكرون في حفظ القرآن وتدوينه ، ولكن لم يكن ممكنا جمعه في مصحف واحد أنذاك وذلك لأنه كان ينزل على رسول اللهr منجما حسب الوقائع والحوادث على مدى ثلاث وعشرين سنة، حيث كان يرقب في ذلك نزول زيادة أو نقصان أو نسخ لبعض الأحكام، وهذا أمر طبيعي استحالة جمعه في مصحف واحد أنذاك لهذه الأسباب، فمن أين لبلاشير هذا التخبط في التأويل واستخدام هذا المنهج غير الموافق للمعايير العلمية السليمة.
ومن الصور التي يطبق عليها المستشرقون هذا المنهج الإسقاطي قولهم بالتمايز في أسلوب القرآن الكريم المكي والمدني، وأرجعوا ذلك إلى البيئة المنحطة لأهل مكة، والبيئة المتقدمة والمتحضرة لأهل المدينة، إذ أن الآيات القصيرة تدل على أن أهل مكة أميون جاهلون، وإذا كانت طويلة فهذا يدل على أن أهل المدينة مثقفون واعون ومتعلمون، بل ومتأثرون بالنفوذ اليهودي فيها، بل من المستشرقين من بالغ في الأمر، وهو هنري لامنس حيث قال” إن اختلاف الأسلوب بين العهد المكي والعهد المدني يعد انعكاساً واضحاً للبيئة التي وجد فيها، فالنصوص القرآنية تعكس طبيعة وبيئة وظروف كل مكان وكل زمان، فالأسلوب القرآني يمتاز في مكة بالشدة والعنف، لأن أهلها أجلاف بينما يمتاز في المدينة باللين والوضوح والصفح، لأن أهلها مستنيرون”. ولا غرو في أن أهداف المستشرقين من وراء كل هذه الدعاوى ، هو التلبيس والتدليس على المسلمين دينهم، وصد الناس عنه، والتشكيك في معطيات القرآن الكريم وجعله وأسلوبه متأثرا بالبيئة المحيطة، وأنه كلام الرسولr وليس من كلام الله، وهذه كلها مغالطات وممارسات مجانبة للحق و للبحث العلمي الصحيح، ولم يفقه أولئك أن الدعوة الإسلامية قد أخذت تطورا كبيرا في جميع مراحلها، بداية من مكة ونهاية بالمدينة، وأنه وكما ورد في السيرة اختلاف واضح في خطاب القرآن الكريم لأهل المدينة، عن خطابه لأهل مكة، إذ أن الآيات التي نزلت في مكة كانت في تسفيه أحلام المشركين ومقارعتهم بالحجج وتحديهم، فالأمر كان يتعلق بتأسيس أسس العقيدة الصحيحة وتدمير معالم العقائد الوثنية السائدة، أما في المدينة فكان الأمر يستدعي تأسيس الدولة الإسلامية، ويتطلب التفصيل في التشريع وبناء المجتمـع الجديد، فلا غرو إذن أن يطنب القرآن بعدما كان يوجز، ويفصل بعدما كان يجمل، كما أن الدعوة الإسلامية أنذاك تحتاج إلى مراعاة ة وتدرج في أحول المدعوين وظروف الحال والمكان.
وخلاصة القول أن ما ادعاه أعداء الملة والدين من المستشرقين، من تناقض وتباين في سور القرآن الكريم وآياته وقصصه وأسلوبه، عار من الصحة، بل إنهم يفتقرون في دراساتهم هذه إلى أبسط معايير البحث العلمي الصحيحة، وأن الآيات والسور ليست خاضعة للظروف والمتغيرات في البيئة كما يدعي ويزعمه أولئك المغالطون، ولكنها حكمة إلهية ، ودعوة قرآنية تراعي أحوال المخاطبين، تشتد وتلين وترغب وترهب بما يستدعيه الحال والمقام.