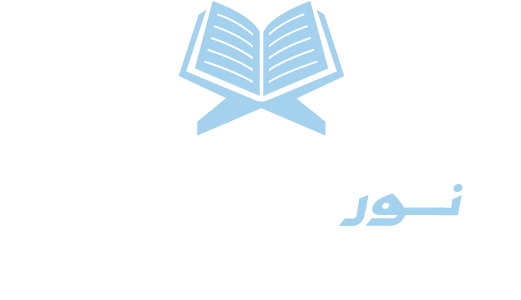ولهذا نظير في اللغة العربية، قال الله تعالى: ] عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً [ [الإنسان: 6]، والعين يشرب منها والذي يشرب به الإناء، فعلى رأي أهل الكوفة نقول: ] يَشْرَبُ بِهَا [ الباء بمعنى ( من )، أي: منها، وعى رأي أهل البصرة يضمن الفعل ] يَشْرَبُ [ معنى يتلاءم مع حرف الباء والذي يتلاءم معها يروى ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري.
ولهذا نظير في اللغة العربية، قال الله تعالى: ] عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً [ [الإنسان: 6]، والعين يشرب منها والذي يشرب به الإناء، فعلى رأي أهل الكوفة نقول: ] يَشْرَبُ بِهَا [ الباء بمعنى ( من )، أي: منها، وعى رأي أهل البصرة يضمن الفعل ] يَشْرَبُ [ معنى يتلاءم مع حرف الباء والذي يتلاءم معها يروى ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري.
وكذلك نقول في ]وما يعرج فيها[: لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية.
ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، ثم فصل في آية أخرى تفصيلاً آخر:
الآية الثانية: قوله: ] وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [ [الأنعام: 59].
]عنده[: أي: عند الله وهو خبر مقدم ]مفاتح[ مبتدأ مؤخر.
ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص، عنده لا عند غيره مفاتح الغيب وأكد هذا الحصر بقوله: ]لا يعلمها إلا هو[، ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين: إحداهما: بطريقة التقديم والتأخير والثانية: طريقة النفي والإثبات.
كلمة ]مفاتح[، قيل: أنه جمع مفتح، بكسر الميم وفتح التاء: المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء وهو قليل، ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب وقيل: جمع مفتح، بفتح الميم والكسر التاء وهي الخزائن، فـ ]مفاتح الغيب[ خزائنه ، وقيل: ]مفاتح الغيب[، أي: مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله، فيكون على هذا: ]مفاتح الغيب[، أي: مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها.
]الغيب[: مصدر غاب يغيب غيباً، والمراد بالغيب: ما كان غائباً والغيب أمر نسبي ، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله.
هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح: هي المبادئ، أو: هي الخزائن، أو: المفاتيح، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك، ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل ـ سأل أشرف الرسل البشري ـ وهو محمد عليه الصلاة والسلام ـ قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: “ما المسؤول عنها بأعلم من السائل”[رواه مسلم][68]والمعنى: كما أنه لا علم لك بها، فلا علم لي بها أيضاً. فمن ادعى علم الساعة، فهو كاذب كافر، ومن صدقه، فهو أيضاً كافر، لأنه مكذب للقرآن.
وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ: ] إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [ [لقمان: 34][69] ، فهي خمسة أمور:
الأول علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا، لأنها ساعة عظيمة، يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة، والساعة علمها عند الله لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل.
الثاني: تنزيل الغيث: لقوله: ]وينزل الغيث[: ]الغيث[: مصدر ومعناه: إزالة الشدة والمراد به المطر، لأنه بالمطر نزول شدة القحط والجدب وإذا كان هو الذي ينزل الغيث، كان هو الذي يعلم وقت نزوله.
والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد.
وهنا نقطة: قال: ]وينزل الغيث[، ولم يقل: وينزل المطر، لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات، فلا يكون غيثاً، ولا تحيا به الأرض، ولهذا ثبت في “صحيح مسلم”: “ليست السنة إلا تمطروا، إنما السنة أن ، تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً“70]، والسنة القحط.
الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: ]ويعلم ما في الأرحام[، أي: أرحام الإناث، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي: ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم، ومتعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل.
فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟
نقول: إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته، وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى ينزل، ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حياً ولا يعلمون هل يكون شقياً أو سعيداً، ولا يعلمون هل يكون غنياً أم فقيراً.. إلى غير ذلك من أحواله المجهولة.
إذاً أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق، فصدق العموم في قوله: ]ويعلم ما في الأرحام[.
الرابع: علم ما في الغد: وهو ما بعد يومك: لقوله: ] وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداًً[ وهذا مفتاح الكسب في المستقبل، وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه، فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى.
لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني، أو أقرأ، أو أزور أقاربي فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل ولكن يحول بينه وبين العمل مانع.
الخامس: علم مكان الموت: لقوله: ] وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [، ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى؟ في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها؟ ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو في الجو؟ وهذا شيء مشاهد.
ولا يدري بأي ساعة يموت، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان، فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت.
فهذه الخمسة هل مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وسميت مفاتح الغيب، لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا، ]مَاذَا تَكْسِبُ غَداًً[ مفتاح للعمل المستقبل ] وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [ مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات، دخل عالم الآخرة، وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث، فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادئ لكل ما وراءها، ] إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [.
ثم قال عز وجل: ] وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر [ [الأنعام: 59]: هذا إجمال، فمن يحصي أجناس ما في البر؟ كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل والبحر كذلك فيه من العوالم مالا يعلمه إلا خالقه عز وجل، يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليابس.
قال ]وما تسقط من ورقة إلى يعلمها[:
هذا تفصيل، فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط، فالله تعالى يعلمها، ولهذا جاءت ]ما تسقط[ النافية و]من[ الزائدة، ليكون ذلك نصاً في العموم، والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى، لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل.
انظر إلى سعة علم الله تعالى كل شيء يكون، فهو عالم به، حتى الذي لم يحصل وسيحصل، فهو تعالى عالم به.
قال: ]ولا حبة في ظلمات الأرض[: حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل.
]ظلمات[: جمع ظلمة ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر، في ليلة مظلمة مطيرة، فالظلمات: أولاً: طين البحر. ثانياً: ماء البحر. ثالثاً: المطر. رابعاً: السحاب. خامساً: الليل، فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل.
قال: ]ولا رطب ولا يابس[: هذا عام، فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس.
]إلا في كتاب مبين[: ]كتاب[، بمعنى مكتوب. ]مبين[ أي: مظهر وبين، لأن ( أبان ) تستعمل متعدياً ولازماً فيقال: أبان الفجر، بمعنى ظهر الفجر ويقال: أبان الحق بمعنى أظهره والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ.
كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى “لما خلق القلم، قال له: اكتب قال القلم: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة”[1][71]، فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتباً تكتب ما يعمله الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل، والكتاب التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: ] وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ [ [محمد: 31]، أما علمه بأن عبده فلاناً سيصبر أو لا يصبر، فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب.
الآية الثالثة: قوله: ] وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه [ [فاطر: 11].
]ما[: نافية.
]أنثى[ فاعل ]تحمل[ لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
وهنا إشكال: كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟
فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى، فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول: هو زائد، زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، زائد من حيث المعنى يزيد فيه.
وقوله: ]من أنثى[: يشمل أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية أخرى الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية، كبقرة، وبعير، وشاة.. وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض، كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل.
]ولا تضع إلا بعلمه[، فابتداء الحمل بعلم الله، وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل.
الآية الرابعة: قوله: ] لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً [ [الطلاق: 12].
] لِتَعْلَمُوا [: اللام للتعليل، لأن الله قال: ] )اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ [الطلاق: 12]، فقد خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع، وأعلمنا بذلك، لنعلم ] أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [.
القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، فالسماوات والأرض كانت معدومة، فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع.
] وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماًً[: كل شيء، الصغير والكبير، والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علماً.
وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع.
تنبيه: ذكر في “تفسير الجلالين” ـ عفا الله عنا وعنه ـ في آخر سورة المائدة ما نصه “وخص العقل ذاته، فليس عليها بقادر”!
ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ووظيفة العقل فيها التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالاً، ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال، وإنما تأتي بمحار، أي: بما يحير العقول، لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره.
والوجه الثاني: قوله: “فليس عليها بقادر”: هذا خطأ عظيم، كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره، فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوى ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئاً أبداً وهذا خطير جداً!!
لكن لو قال قائل: لعله يريد: “خص العقل ذاته، فليس عليها بقادر”، يعني: لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصاً قلنا: إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء، لا في الخارج ولا في الذهن” فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل، بخلاف العلم.
فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم.
إذاً، نحن نطلق ما أطلقه الله، ونقول إن الله على كل شيء قدير، بدون استثناء.
وفي هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل، وإثبات عموم قدرة الله تعالى.
والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله والخوف منه.
وقوله: ]إن الله هو الرزاق( 1 )………………………………………………
( 1 ) في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل.
جاءت هذه الآية بعد قوله: ] وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( 56 ) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ) [الذاريات: 56-57]، فالناس يحتاجون إلى رزق الله، أما الله تعالى، فإنه لا يريد منهم رزقاً ولا أن يطعموه.
* ]الرزاق[: صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء، قال تعالى ] إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ [ [النساء: 8]، أي: أعطوهم، والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته، ويقول: اللهم ارزقني.
وينقسم إلى قسمين: عام وخاص.
فالعالم: كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالاً أو حراماً، وسواء كان المرزوق مسلماً أو كافراً، ولهذا قال السفاريني:
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال
لأنه رازق كل الخلــق وليس مخلوق بغير رزق
لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين يأكلون الحرام، لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم، لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث، ولهذا قال الله تعالى: ]قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [ [الأعراف: 32]، ولم يقل: والرزق، أما الخبائث من الرزق، فهي حرام.
أما الرزق الخاص، فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله، ولهذا جاءت الآية الكريمة: ]الرزاق[ ولم يقل: الرازق، لكثره رزقه وكثرة من يرزقه، فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلاً عن أنواعه، فضلاً عن آحاده، لأن الله تعالى يقول: ] وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا [ [هود: 6]، ويعطي الله الرزق بحسب الحال.
ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق، فهل أسعى لطلب الرزق: أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟
فالجواب نقول: اسع لطلب الرزق، كما أن الله غفور، فليس معنى هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة.
أما قول الشاعر:
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين
فهذا القول باطل. وإما استشهاده بالجنين، فالجواب: أن يقال الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق، لأنه غير قادر، بخلاف القادر.
ولهذا قال الله تعالى: ]هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه [ [الملك: 15]، فلابد من سعي، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع.
ذو القوة( 1 ) المتين( 2 )……………………………………………………….
( 1 ) القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، والدليل على قوله تعالى: ]اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّة [ [الروم: 54]، وليست القوة هي القدرة، لقوله تعالى: ] وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراًً[ [فاطر: 44]، فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، ، والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانياً: أن القوة أخص فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا . مثال ذلك: تقول: الريح قوية ، ولا تقول قادرة ،و تقول: الحديد قوي، ولا تقول: قادر، لكن ذو الشعور تقول: إنه قوي، وإنه قادر.
ولما قالت عاد: ]من أشد منا قوة[ قال الله تعالى: )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّة [ [فصلت: 15].
( 2 ) المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشديد. أي الشديد في قوته، والشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي.
ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد، ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين، لأن الله سمى نفسه بذلك.
في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله، هما: الرزاق، والمتين، وإثبات ثلاث صفات، وهي الرزق، والقوة، وما تضمنه اسم المتين.
والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق، أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت، فلن تقابل قوة الله تعالى.
وقوله: ]ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[( 1 )…………………………….
( 1 ) هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة، وهما السميع والبصير، ففيها رد على المعطلة.
* قوله: ]ليس كمثله شيء[: هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته، وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل.
* قوله: ]وهو السميع البصير[: ]السميع[ له معنيان أحدهما: بمعنى المجيب. والثاني: بمعنى السامع للصوت.
أما السميع بمعنى المجيب، فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: ] إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ [ [إبراهيم: 39]، أي: لمجيب الدعاء.
وأما السميع بمعنى إدراك الصوت، فإنهم قسموه إلى عدة أقسام:
الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله.
الثاني: سمع يراد به النصر والتأييد.
الثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد.
مثال الأول: قوله تعالى: ]قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه [ [المجادلة: 1]، فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: “الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة، وإن حديثها ليخفى على بعضه”[72].
ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: ]إنني معكما أسمع وأرى[ [طه: 46].
ومثال الثالث: الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: ]أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ [ [الزخرف: 80]، فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول.
والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثاً.
والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب.
والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً.
* وقوله: ]البصير[، يعني: المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير، يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده، قال تعالى: ] وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [ [الحجرات: 18]، والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي، فبصر الله إذاً ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله: ]البصير[.
في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله، هما: السميع، والبصير. وثلاث صفات، هي: كمال صفاته من نفي المماثلة، والسمع، والبصر.
وفيها من الفوائد المسلكية: الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه، واستشعار عظمته وكماله، والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك مالا يرضاه.
واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قوله: ]كمثله[، حيث قالوا: الكاف داخلة على ( المثل )، وظاهره أن لله مثلاً ليس له مثل، لأنه لم يقل: ليس كهو، بل قال: ]ليس كمثله[، فهذا ظاهرها من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى، لكان ظاهر القرآن كفراً، وهذا مستحيل، ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال:
القول الأول: الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام: ليس مثله شيء، وهذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما في قوله: تعالى ]وما تحمل من أنثى[ [فاطر: 11]، فيقولون: إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد.
والقول الثاني: قالوا العكس، قالوا: إن الزائد ( مثل )، ويكون التقدير: ليس كهو شيء، لكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جداً أو نادرة، بخلاف الحروف، فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة، فليكن الزائد الحرف، وهي الكاف.
والقول الثالث: أن ( مثل ) بمعنى: صفة، والمعنى: “ليس كصفته شيء”، وقالوا: إن المثل والمثل والشِّبه والشَّبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى: ]مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ [ [محمد: 15]، أي: صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب.
القول الرابع: أنه ليس في الآية زيادة، لكن إذا قلت: ]ليس كمثله شيء[، لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل، صار الموجود واحداً، وعلى هذا، فلا حاجة إلى أن نقدر شيئاً. قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية، مثل قوله: ليس كمثل الفتى زهير.
والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم، لكان معنى الآية واضحاً، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب، والراجح: أن نقول، إن الكاف زائدة لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود.
وقوله: ]إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمعياً بصيراً[( 1 )……………………
( 1 ) هذه الآية تكملة لقوله تعالى: ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل [ [النساء: 58]، فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل، فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه، وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله: ] أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [، والحكم: ] وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل [، ثم قال سبحانه: ]إن الله نعما يعظكم به[، أصلها: نعم ما ولكن ادغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناً، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح.
* وقوله: ]نعما يعظكم به[: جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين ـ أداء الأمانة والحكم بالعدل ـ موعظة، لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب، فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أن يصلح القلب.
* ثم قال: ]إن الله كان سميعاً بصيراً[، وقوله: ]كان[: هذه فعل، لكنها مسلوبة الزمن، ، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي: أن الله متصف بالسمع والبصر، وإنما قلنا: إنها مسلوبة الزمن، لأننا لو أبقيناها على دلالاتها الزمانية، لكان هذا الوصف قد انتهى، كان في الأول سميعاً بصيراً، أما الآن فليس كذلك، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، و( كان ) في مثل هذا السياق يراد به التحقيق.
* قوله: ]سميعاً بصيراً[: نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه، وإثبات البصر بقسميه.
قرأ أبو هريرة هذه الآية، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه[1][73]. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك.
فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
فالجواب: من العلماء من قال: نعم، افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولست أشد تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق من الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسها، إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ، لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشي من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال.
وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله“، ويقبض أصابعه ويبسطها[1][74]. فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة.
والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر: أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا.
وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميع، والبصير. ومن الصفات: إثبات السمع، والبصر، والأمر، والموعظة.
وقوله: ]ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله[( 1 )……………….
( 1 ) هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة:
فالآية الأولى: قوله تعالى: ]ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله[ [الكهف: 39].
* ]ولولا[: بمعنى: هلا، فهي للتحضيض، والمراد بها هنا التوبيخ، بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول.
* ]إذ دخلت[: حين دخلت.
- · ]جنتك[: الجنة، بفتح الجيم هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها، فهو مستجن فيها، وهذه المادة ( الجيم والنون ) تدل على الاستتار، ومنه: الجُنة ـ بضم الجيم ـ التي يتترس بها الإنسان عند القتال، ومنها: الجِنة ـ بكسر الجيم ـ، يعني، الجن، لأنهم مستترون.
* وقوله: ]جنتك[: هذه مفرد، والمعلوم من الآيات أن له جنتين، فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟
الجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين. أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين، لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله، كأنه يقول: هاتان الجنتان جنة واحدة، تقليلاً لشأنهما، والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية ]قلت[: جواب ]لولا[.
* وقوله: ]ما شاء الله لا قوة إلى بالله[: ]ما[: يحتمل أن تكون موصولة، ويحتمل أن تكون شرطية: فإن جعلتها موصولة، فهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا ما شاء الله، أي: ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي، ولكنه بمشيئة الله، أي: هذا الذي شاءه الله. وإن جعلتها شرطية، ففعل الشرط ]شاء[، وجوابه محذوف، والتقدير: ما شاء الله كان، كما نقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والمراد: كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك: ]ما شاء الله[، لتتبرأ من حولك وقوتك لا تعجب بجنتك.
* وقوله: ]لا قوة إلا بالله[: ]لا[: نافية للجنس. و]قوة[: نكرة في سياق النفي، فتعم، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف.
فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله ، وبين قوله تعالى: ] اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّة [ [الروم: 54]، وقال عن عاد: ] وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّة [ [فصلت: 15]، ولم يقل: لا قوة فيهم، فأثبت للإنسان قوة.
فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين:
الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل، فلولا أن الله أعطاه القوة، لم يكون قوياً، فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله.
الثاني: أن المراد بقوله: ]لا قوة[، أي: لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل.
وعلى كل حال، فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته، ويقول: هذا بمشيئة الله وبقوة الله.
في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله، وهو: الله، وإثبات ثلاث صفات: الألوهية، والقوة، والمشيئة.
ومشيئة الله: هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولابد من وجود ما شاء بكل حال، فكل ما شاء الله وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه و يرضاه أم لا.
وقوله: ]ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد[( 1 )……………………..
( 1 ) الآية الثانية: قوله: ] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد [ [البقرة: 253]:
]لو[: حرف امتناع لامتناع، وإذا كان جوابه منفياً بـ( ما )، فإن الأفصح حذف اللام، وإذا كان مثبتاً، فالأكثر ثبوت اللام، كما قال تعالى: ]لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ [ [الواقعة: 65]. فنقول: الأكثر، ولا نقول: الأفصح، لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم: ]لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً [ [الواقعة: 70]. وقولنا: إن الأفصح حذف اللام في المنفي، لأن اللام تفيد التوكيد، والنفي ينافي التوكيد، ولهذا كان قول الشاعر:
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي
خلاف الأفصح، والأفصح: لو نعطى الخيار ما افترقنا
* قوله: ] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا [: الضمير يعود على المؤمنين والكافرين، لقوله تعالى: ] وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا [ [البقرة: 253].
وفي هذا رد واضح على القدرية الذي ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله قال: ] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا [، يعني: ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال: ]ولكن الله يفعل ما يريد[، أي: يفعل الذي يريده، والإرادة هنا إرادة كونية.
* وقوله: ]يفعل ما يريد[: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقدِّره على العباد فعل غير مباشر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد، فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله.
ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق.
أما ما يفعله الله بنفسه، كاستواءه على عرشه، وكلامه، ونزوله إلى السماء الدنيا، وضحكه… وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلاً مباشرة.
في هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: المشيئة، والفعل، والإرادة.
وقوله: ) أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) ( 1 )………………………..
( 1 )الآية الثالثة: قوله: ] أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [ [المائدة: 1].
* ]ُحِلَّتْ لَكُمْ[: المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم، لكن بإذن من الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أحلت لنا ميتتان ودمان“[1][75]، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: “إن الله يحرم عليكم“، كذا يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريماً يضيفه إلى نفسه، لكنه بإذن الله.
- ] بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ [: هي الإبل والبقر والغنم، والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب.
- وقوله [ بهيمة ] سميت بذلك لأنها لا تتكلم .
* ] إِلَّا مَا يُتْلَى [: إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة، وهي المذكورة في قوله تعالى: ] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه [ [المائدة، 3]، فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل، فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل، وبالنسبة للحم الخنزير منقطع، لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
* وقوله: ]غير محلي الصيد وأنت حرم[: ]غير[: حال من الكاف في ]لكم[، يعني: حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم، وهذا الاستثناء منقطع أيضاً، لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام.
وقوله: ]غير محلي الصيد[، يعني: قاتليه في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له، و]الصيد[: هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام.
* وقوله: ]إن الله يحكم ما يريد[: هذه الإرادة شرعية، لأن المقام مقام تشريع، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كوناً، حكم به وأوقعه، وما أراده شرعاً، حكم به وشرعه لعباده.
في هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: التحليل، والحكم، والإرادة.
وقوله: ] فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [( 1 )……………………………………….
( 1 ) الآية الرابعة: قوله ] فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [ [الأنعام: 125].
* قوله: ] فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ [: المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، والمراد بالهداية هداية التوفيق، فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق.
فإذا عرفت من نفسك هذا، فاعلم أن الله أراد بك خيراً وأراد لك هداية، أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية، وإلا لا نشرح صدره.